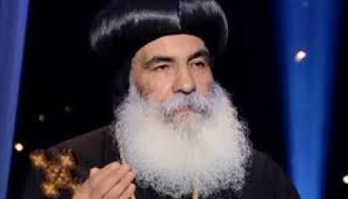المقالات
27 أبريل 2020
حقيقة القيامة
عيد القيامة هو عيد الأعياد، أو غاية وهدف كل المناسبات التي تسبقه. وكل المناسبات التي تلي عيد القيامة نتيجة له. ومع هذه الحقيقة نتكلم عن شواهد ذلك: ولعل الدليل الأول هو مزمور قداس عيد القيامة «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونبتهج فيه. آه يارب خلِّص، آه يارب أنقذ. مبارك الآتي باِسم الرب» (مز118: 24-26).
ولكن لماذا ذُكِر يوم القيامة على أنه اليوم الذي صنعه الرب؟! فالله هو صانع كل الأيام، بل كل شيء .. وللإجابة نوضّح الأمور التالية:
1- الله هو مصدر الحياة: لأنه هو مالك الحياة وواهب الحياة، لذلك هو الخالق لكل الكائنات إذ وهب الحياة للجميع، ولكن حين دخل الموت إلى العالم بحسد إبليس نتيجة دخول الخطية إلى العالم بغواية الشيطان لحواء التي أكلت وأعطت رجلها فأكل، ومن خلال هذه المعصية فقد الإنسان الحياة الأبدية والحياة الروحية والعلاقة مع الله، لذلك طُرد من الفردوس وحضرة الله، وقيل في (تك6: 3) «لا يدين روحي في الإنسان لزيغانه هو بشر».. لذلك بعد إتمام الفداء على الصليب وموت الفادي وقيامته في اليوم الثالث، أعلن الحياة الأبدية الغالبة للموت، ولم يَعُدْ للموت سلطان على الإنسان وحياته، لذلك صارت الصيحة «أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتكِ يا هاوية؟».. لم يعد للموت سلطان، لذلك نسمّي الموت الآن "انتقال"، وليس نهاية حياة بل استمرار للحياة بصورة مختلفة حتى يوم القيامة حيث تتحد الأرواح بالأجساد، ويقوم الجميع كما ورد في (يو5: 29) «تأتي ساعة يسمع فيها كل مَنْ في القبور صوت ابن الله، والذين يسمعون يُحْيَوْن، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة».
2- مفهوم الحياة: الحياة المقصود بها الوجود الباعث للحياة، فكل المخلوقات تساهم في الحياة الإنسانية واستمرارها على الأرض، بمعنى أن بعض المخلوقات يستخدمها الإنسان كغذاء كالخضروات والفواكه والخبز والمنتجات البروتينية سواء حيوانية أو نباتية يتغذّى عليها الإنسان لاستمرار الحياة، فوجود هذه المخلوقات يفيد في استمرار حياة الإنسان.. وأيضًا الشمس كطاقة ضوئية وحرارية تفيد في إعطاء حياة للمخلوقات، ويدخل كذلك المعادن بتفاوت أنواعها وقيمتها في اقتصاديات الحياة، إذ تساعد الإنسان كتجارة وصناعة في أن تستمر الحياة بالجسد والروح معًا، مما ينتج عن هذا الاتحاد النفس أي العقل البشري الخلّاق والعاطفة الحاضنة للصغار والضعفاء والحواس التي تتصل بالحياة.. حقًا إنها الحياة عطية الله..
3- قيامة الجسد: وهذا ما نحتفل به من خلال عيد القيامة المجيد الذي أعطانا القيامة أيضًا، وصار الموت فترة مؤقته لراحة الروح في الفردوس وراحة الجسد في القبر «"طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن". "نعم" يقول الروح: "لكي يستريحوا من إتعابهم، وأعمالهم تتبعهم"» (رؤ14: 13). هذا هو الموقف الآن، لذلك طيلة فترة الخماسين المقدسة تكون التحية "خريستوس آنستي... آليثوس آنستي"، أي "المسيح قام... بالحقيقة قام"، وصارت القيامة في التوبة لأن أجرة الخطية موت ولكن التوبة حياة من موت فتكون قيامة.. هذا نعيشه ليترسّخ في الأذهان لنعرف أن القيامة حقيقة معاشة فلا نخاف الموت...
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد
30 مارس 2020
المحبة الغافرة
المغفرة التي نطلبها من الله مشروطة بغفراننا لمن يسيء إلينا «واغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين إلينا» (مت6: 12)، وهذا ما قاله السيد المسيح: «إن لم تغفروا للناس زلاتهم، لا يغفر لكم أبوكم أيضًا زلاتكم» (مت6: 15)، وكذلك «اغفروا يُغفَر لكم» (لو6: 37).. ولكن لابد من المحبة حتى يمكن المغفرة، لأن المحبة هي دليل الكمال المسيحي الذي يقول عنه القديس مار إسحق "حينما تمتلئ النفس من ثمار الروح تتقوى، فلا تُهزَم أمام حرب العدو، بل ينفتح القلب بالحب لسائر البشر". والسيد المسيح أعطى مثلًا أن عبدًا طلب مسامحة سيده لِما عليه من دين مالي، ولكن سمع هذا السيد أن هذا العبد رفض مسامحة عبدًا آخر مديونًا له بدين مالي أقل كثيرًا فرفض مسامحته.. فطلب السيد أن يوضع ذلك العبد في السجن إلى أن يوفي الفلس الأخير (مت5: 26). ومن هذا المثل يتضح أن المغفرة هي لمن يغفر لغيره، وإلا لن ينال غفرانًا..
لذلك لابد أن نقتنع بضرورة:
1- أن نتنازل عن كرامتنا الشخصية وحقوقنا مهما كانت الإساءة، فنغفر أولًا حتى ننال الغفران من الله.
2- شرط أن يكون الغفران من القلب وليس بطريقة شكلية مظهرية.
3- نلتمس عذرًا لمن أخطأ في حقنا مثل السيد المسيح الذي التمس عذرًا لصالبيه وقال: «اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (لو23: 34).
4- احرص أن تقف أمام الله بريئًا من الحقد، حتى لا تُحزن الروح القدس.
5- واشعر أنك مديون أكثر من غيرك، مثلما قال الرب يسوع لسمعان الفريسي عن الدائن الذي كان له مديونان، الأول 500 دينار والآخر 50 دينارًا وسامحهما كليهما، ثم تساءل الرب: «تُرى مَنْ أحبه أكثر؟»، وكان يقصد أن يكشف لسمعان الفريسي أنه مديون بخطايا مثل المرأة الخاطئة ولو بقدر أقل، والسيد المسيح سامحهما كليهما، فأحبته المرأة الخاطئة أكثر من سمعان الفريسي لأنه سامحها بالأكثر.
لذلك يقول البابا شنوده: "سلف المغفرة لكي تجدها في اليوم الأخير، ولا تكن بارًا في عيني نفسك لئلا تقسو على أخيك ولا تغفر له، لأنك لست محتاجًا للمغفرة لأنك بار".
6- اغفر لأخيك المخطئ إليك لأنه ضحية الشيطان الذي ملأ قلبه بمشاعر سلبية تجاهك. وحين تغفر له تملأ قلبه بالمحبة الغافرة فيتعلم أن يغفر.
7- كما أن غفرانك علامة تواضعك ومحبتك للقريب كنفسك التي تغفر لها كثيرًا.
ولكن ما بالك إن كنت أنت المسيء ؟! هنا يطلب الوحي الإلهي أن تذهب وتصطلح مع أخيك وتعتذر له وتُصحّح أخطاءك.. ويُحكى عن القديس موسى الأسود أنه حين سمع أمر مسئول الدير بطرد راهب أخطأ، فقام بحمل قفة مملوءة رملًا ومثقوبة وحملها على كتفه، وذهب للآباء الذين جلسوا يحكمون على المخطئ وقال لهم: "هذه خطاياي تجري وراء ظهري ولا أراها، وجئت لكي أحكم على مخطئ غيري"، وكانت النتيجة أن قام الآباء بنصح المخطئ وأعطوا له فرصة أخرى. والتدريب الرائع الذي يعلمنا أن نغفر بنكران الذات ليظهر مسيحنا القدوس فينا كغافر للجميع ونردد «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل2: 20).
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد
23 مارس 2020
القداسة ولباس العُرس
لعل هذا هو جوهر خبرة الحياة الروحية، أن نتقدّس ونقتني لباس العُرس الذي هو شرط دخول الملكوت الأبدي. ومفهوم القداسة هو الالتصاق بالله القدوس لأن القداسة هي صفه في الله، ففي (خر15: 11) «مَنْ مثلك في الآلهة يارب.. مَنْ مثلك معتزًا في القداسة مخوفًا بالتسابيح صانعًا عجائب»، فالله قدوس يكره الشر والمعصية، وخلق الإنسان على صورته ومثاله «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» (تك1: 26). ويقول القديس يعقوب السروجي: "خلق الله الإنسان أعظم من كل الخليقة، وأعطاه إمكانية التقديس، لذلك أوصى الإنسان أن يتقدس «إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس، ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب الأرض» (لا11: 44)"، فالقداسة هي طبيعة الحياة مع الله «نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضًا قديسين» (1بط1: 15),
والقداسة عطية من الله باختيار الإنسان الذي خُلِق على مثال الله في كل سيره في حياته، وفي حالة حرص الإنسان على القداسة في كل سيرة يقتني ثوب العرس الذي هو شرط الدخول الى الملكوت الأبدي، الذي وُصِف بأنه "عرس ابن الملك" (مت22: 1-3) «يشبه ملكوت السموات إنسانًا ملكًا صنع عرسًا لابنه، وأرسل ليدعو عبيده المدعوين إلى العرس". وفي قول الأب غريغوريوس الكبير: "يمكننا القول أن الآب صنع لابنه الملك العرس خلال سر التجسد حيث التصقت به الكنيسة المقدسة مزيّنة بلباس العرس، بدءًا من العذراء القديسة مريم، ليتحد بعروسه المقدسة كنيسته المتزينة بلباس العرس في كل الأزمنة بقديسيه". وهنا نتساءل: ما هو ثوب العرس؟ إنه الحياة الداخلية المقدسة، والمُعلَنة من خلال السيرة العطرة بالتصرفات العملية والسلوك المسيحي، وأساسه ما نلناه في المعمودية بإيماننا المسيحي من إمكانية السلوك بوصايا الله، بقيادة الروح القدس العامل فينا دائمًا كنتيجة للتقديس بالميرون المقدس بعد المعمودية. ويؤكد القديس جيروم ذلك بقوله: "ثوب العرس نناله بتنفيذ وصايا الرب وتتميم ناموسه المقدس بعمل روح الله الذي يقودنا «فالذين ينقادون بروح الله فهم أبناء الله» (رو8: 14). والقديس أغسطينوس يوصي قائلًا: "ليكن لكم الإيمان العامل بالحب الإلهي فإن هذا هو ثوب العرس.. يا مَنْ تحبون المسيح، وتحبون بعضكم بعضًا، وكذلك الأصدقاء، بل حتى الأعداء. ولا يكون هذا ثقلًا عليكم". بل يرى الأب غريغوريوس الكبير أن ثوب العرس يُنسَج بين عارضتين هما: محبة الله ومحبة القريب، لأن الحب المقدس هو طبيعة النفس التي لا تقدر أن تفصل محبة الله عن محبة القريب. ولخطورة هذا الأمر نقتني المحبة المتكاملة لله وللناس، ونسهر عليه بالصلوات كما في نصف الليل: "ها هوذا الختن يأتي في نصف الليل، فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظًا، أمّا الذي يجده متغافلًا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تُثقلي نومًا فتُلقي خارج الملكوت، بل إسهري..."
إننا جميعًا نشتاق إلى دخول العرس السماوي في الملكوت الأبدي، وشرط الدخول هو اقتناء ثوب العرس، لئلّا يأتي مَنْ يقول: «يا صاحب كيف دخلتَ إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟.. فسكت» (مت22: 12).
لذلك نحذر من أن تكون لنا صورة التقوى لكن ننكر قوتها، ولا أن نكون كالجاهلات نحمل مصابيح ليس لها رصيد في زيت الآنية، لأن زيت المصباح ينفذ لكن خزين زيت الآنية لا ينفذ مطلقًا.
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد
16 مارس 2020
حياة النمـو
+ النمو سمة الحياة: كل الكائنات الحية تختبر خاصية النمو في حياتها، فالطفل يولد ثم ينمو ليصل إلى المراحل المتعددة: الصبا والشباب والنضوج والرجولة والحكمة.. الخ. وكذلك النبات يُزرع بذرة صغيرة تنمو فتكبر وتصير نباتًا ثم شجرة صغيرة ثم شجرة كبيرة مثمرة.. فحبة الخردل وهي أصغر جميع البذور تصير شجرة كبيرة تتآوى فيها جميع طيور السماء.. وهكذا بقية الكائنات الحية كلها تبدأ صغيرة وتكبر في مراحل العمر المتعددة.
+النمو تحدي لكل المعوقات: لا شك أن كل مَنْ ينمو في هذه الحياة يواجه تحديات في كل مراحل حياته، سواء في الصغر أو في الكبر، من أمراض أو عوامل الفناء الكثيرة التي تعمل في هذا الكون.. فالبقاء يمثل قوة تقاوم عوامل الفناء هذه، والنتيجة هي النمو واكتساب حصانة قوية ضد كل ما يُعطل النمو هكذا قال القديس بولس: «ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام» (في13:3).
يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "إذ يستحيل على الذين يصعدون ويبلغون القمة أن يتحاشوا الشعور بالدوار، لهذا يحتاجون ليس فقط أن يتسلقوا صاعدين، بل وأن يكونوا حذرين عند بلوغهم الذروة، فالحذر شيء وفقدان توازن رؤوسنا عندما نرى المسافة التي تسلقناها شيء آخر، فلنلاحظ ماذا تبقى لنا أن نصعد ونهتم بهذا".
+النمو الروحي هو سعي نحو الهدف: فهدف مَنْ يحيا مع الله هو الإعداد للوصول للحياة الأبدية كهدف رئيسي تُمهّد له كل الأهداف القريبة الأخرى كالصلاة والنقاوة والتوبة والجهاد ووسائط النعمة الكثيرة..الخ. ولقد حَذَّرَ القديس بولس من الانشغال بأي هدف آخر كبديل للحياة الأبدية فقال: «فليفتكر هذا جميع الكاملين منَّا، وإن افتكرتم شيئًا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضًا» (في3: 15)، بمعنى أن مَنْ ينشغل عن هذا الهدف الأساسي وهو الحياة الأبدية، بأي هدف آخر كالمواهب أو العطايا اللازمة للخدمة، وهي مجرد وسائل ولا ترقى لمستوى الهدف الأساسي وهو الملكوت الأبدي..
+النمو هو الوسيلة المثلى للترقّي الروحي المنشود: فأي بداية لابد أن تكمل حتى تصل إلى المستوى المطلوب الذي ينشده الرب لنا، وهذا ما نوّه عنه القديس بولس حين قال: «ليس أني قد نلت أو صرت كاملًا، لكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضًا المسيح يسوع، أيها الأخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئًا أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع» (في3: 12، 14).
يقول القديس أمبروسيوس: "يوجد شكلان للكمال شكل عادي وآخر علوي، واحد يُقتنى هنا والآخر فيما بعد، واحد حسب القدرات البشرية والآخر خاص بكمال العالم العتيد، أما الله فعادل خلال الكل، حكيم فوق الكل، كامل في الكل".
فمن يبدأ ولا ينمو لا يستطيع أن يدرك ما يود أن يدركه ولا يسعى نحو الغرض.. لذلك فكل عمل روحي له بداية وله تكمله أيضًا، فالصلاة تبدأ بالجسد ثم بالفكر ثم بالروح ثم بالروح والذهن ثم بالاستعلانات الإلهية..الخ. وكذلك في الصوم: صوم الجسد ثم صوم اللسان ثم صوم الفكر ثم صوم الحواس جميعًا..الخ.. وهكذا بقية الوسائط الروحية... لابد أن يتحقق فيها النمو ويتحول هذا الجهاد إلى مكآفأة كرامة بهية أبدية.
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وتوابعها
المزيد
09 مارس 2020
الصوم وحياة السهر
في مَثَل الحنطة والزوان، يعلن عن وجود عدو مُقاوم أي إبليس رئيس مملكة الظلمة الذي لا يطيق مملكة النور.. «يشبه ملكوت السموات إنسانًا زرع زرعًا جيدًا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانًا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرًا، حينئذ ظهر الزوان أيضًا» (مت13: 24-26).
أولًا: لماذا لم يقل السيد "وفيما الزارع نائم جاء عدوه وزرع زوانًا" إنما قال "فيما الناس نيام"؟.. ذلك لأن: الله يسهر على كرمه ويهتم به، لكن الكرامين إذ ينامون يتسلل العدو إلى الكرم.. إن الله يحترم الإرادة الإنسانية ويأتمنها، لكن الله يطلب السهر حتى لا يتسلل العدو ليلًا..
ثانيًا: لم يقل السيد المسيح "جاء عدوهم" إنما قال:"جاء عدوه"؟.. لأن: العدو لا يقصد الكرامين بل صاحب الكرم، فالعامل الحقيقي ضد الكرم هو إبليس عدو الله نفسه.. حقًا إنها حرب بين الله وإبليس، بين النور والظلمة..
ما المقصود بالنوم هنا؟ يُقصد به التراخي والإهمال أو نسيان الله نفسه. يقول ق. جيروم "لا تسمح للعدو أن يلقي زوانًا وسط الحنطة بينما الزارع نائم عندما يكون الذهن الملتصق بالله في غير حراسة، وإنما قُل مع عروس النشيد: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. إخبرني أين ترعى أين تربض عند الظهيرة (نش3: 1 و1: 7)".
ثالثًا: ماهو الزوان؟ إلى أي شيء يشير؟
(1) يشير إلى الهرطقات: التي تنتشر في غفلة روحية من الرعاة، لذلك يقول ق. جيروم: "ليت أسقف الكنيسة لا ينام لئلا بإهماله يأتي إنسان عدو ويلقي بالزوان، أي تعليم الهراطقة".
(2) يشير إلى الخطية: الخطية التي تتسلّل إلى الفكر والقلب في غفلة روحية من الإنسان الروحي، لذلك يتحدث الأب إيسيذورس عن الأفكار الشريرة بقوله: "لماذا تنبع الأفكار الشريرة من القلب وتنجس الإنسان (مت 15: 19-20)؟! بلا شك لأن العاملين ينامون مع أنه كان يلزم أن يكونوا ساهرين حتى يحفظوا ثمار البذار الصالحة لكي تنمو. فلو لم نضعف أثناء سهرنا بسبب النهم والتراخي وتدنيس الصورة الإلهية، أي فساد البذرة الصالحة، ما كان لباذر الزوان أن يجد وسيلة للزحف وإلقاء الزوان المستحق للنار".
(3) يشير إلى الأشرار: الذين يحملون شكلية العضوية الكنسية دون روحها وحياتها العميقة.
رابعًا: ظهور الزوان وانتظار وقت الحصاد، لماذا؟
«فلما طلع النبات وصنع ثمرًا.. حينئذ ظهر الزوان أيضًا.. إنسان عدو فعل هذا.. دعوهما ينميان كلاهما معًا إلى الحصاد.. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولًا الزوان واحزموه ليُحرق.. وأمّا الحنطة فاجمعوها إلى مخزني" (13: 26-30).. وهنا يطلب السيد الرب يسوع:
(أ) تأكيد الاهتمام الإيجابي والعمل لحساب ملكوت الله عوض إدانة الأشرار.
(ب) عدم اليأس والجهاد، لا في إقتلاع الزوان بل في العمل وتحويل الزوان إلى حنطة، فالله لم يقطع عيسو الشرير حتى لا يهلك معه أيوب البار الذي جاء من نسله، ولم يقتل لاوي العشار حتى لا يفقده ككارز بالإنجيل، ولا انتقم لإنكار سمعان بطرس الذي قدم دموع التوبة بحرقة، ولا ضرب شاول الطرسوسي بالموت حتى لا نفقد بولس الرسول الذي كرز بالخلاص في أقاصي الأرض.
ينصح ق. أغسطينوس بقوله: "كثيرون يكونون في البداية زوانًا لكنهم يصيرون بعد ذلك حنطة، فلنحتملهم بالصبر. وإنك لتجد القمح والزوان بين الكراسي العظيمة كما بين العلمانيين أيضًا، فليحتمل الصالحون الأشرار، وليصلح الأشرار من أمرهم مقتدين بالصالحين".
لنحذر: في ملء اليقظة من عدو الخير الذي يلقي الزوان سرًا ليملك على القلب الذي أُعِد لسُكنى المسيا المخلص، ولا يكون هناك مكان لإبليس المفسد بالصوم وحياة السهر.
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد
02 مارس 2020
الصوم والشفاء
الصوم وصية إلهية وُجِّهت للإنسان لتأكيد حبه لله، وذلك حين طلب الله من الإنسان أن يأكل من كل الشجر في الجنة ماعدا شجرة معرفة الخير والشر. وهكذا وُجِد الصوم في عبادة الإنسان لله، وكان أمام الإنسان فرصة الطاعة لتأكيد محبته لله، أو المعصية والأكل والسقوط ودخول الموت إلى الإنسان، وهذا ما حدث فعلًا... لذلك حين تجسد الابن الكلمة اُقتيد بالروح للبرية صائمًا حتى يُصحّح خطأ آدم الأول، ويصير آدم الثاني رأس البشرية الجديدة. ومن هنا اكتسب الإنسان أهمية الصوم، لأنه يرفض الموت ويحب الحياة، لذلك ركزت الكنيسة في قراءات الآحاد علي الأمور التالية:
(1) علاقة الصوم بالعبادة: وهذا إنجيل أحد الرفاع قبل بداية الصوم، ويضع صورة العبادة المقبولة: في صلاة في المخدع، وصوم داخلي بقناعة وتُعفّف النفس، وصدقة مُخفاة عن أعين الجميع وعطاء المديون وليس المتباهي بمنطق «من يدك وأعطيناك... والمعطي المسرور يحبه الرب»، كمن هو فرح بسداد ديونه للرب المسئول عن الفقير والمحتاج. وهنا دعوة للاستشفاء من التباهي والمتعة بالتفضُّل علي الآخر.
(2) علاقة الصوم بالنصرة: كما انتصر السيد المسيح على الشيطان الذي لم يستطع أن يُسقطه كما حدث مع آدم الأول، وذلك أعطى للإنسان الجديد كرامة أقوي وأعلىن حتى مع إمكانيات العهد الجديد ينتصر على عدو الخير بصورة تجعله يحيا بالفضيلة والقداسة الداخلية بعيدًا عن موت الخطية. وهذا نوع من الشفاء من مرض الخطية، فالذي يبدأ بالعبادة ومنها الصوم، يصل إلى النصرة على موت الخطية.
(3) علاقة الصوم بالعودة لبيت الآب: حيث السيادة ورفض عبودية الكورة البعيدة مع الخنازير المتسخة، والتمسك ببيت الآب وبالأمان وبالغذاء والحياة الكريمة، والاستشفاء النفسي والجسدي. والصوم من العوامل الأساسية لحفظ إرادة الإنسان صالحة نقية، وتظل اختيارات الإنسان تُفرح قلب الله دائمًا بنعمة الله.
(4) علاقة الصوم بالمصالحة: حين التقي الرب بالسامرية لكي يُنهي العداوة بين اليهود والسامريين، إذ هو المخلص والمصالح الإنسان مع الله والإنسان مع أخيه والإنسان مع الخليقة. وهنا نجد المصالحة تبدأ مع الله ثم مع الإنسان ثم مع الخليقة، وبذلك تمنح الحياة، لأن الخصومة موت لأنها عداوة، أمّا المصالحة فحياة.
(5) علاقة الصوم بالشفاء: وهذه نتيجة لكل ما سبق بالصوم. والشفاء هو المحصِّلة لبركات الصوم في كل ما سبق الحديث عنه. وشفاء الإرادة التي بدأت بالعبادة، فاختزنت للنصرة على الشر، بفضل العودة لبيت الآب، والمصالحة التي تقدِّس الإرادة، وتُنير العينين لرؤية الحياة الأبدية، بالقيامة التي تهزم الموت إلى الأبد، من خلال الخلاص والفداء الذي نحتفل به في أسبوع الآلام، وصولًا إلى القيامة التي تعلن جسد الحياة الأبدية. وواضح جدًا أن الصوم كعبادة، مع الصلاة والصدقة، يُحرّر النفس من سلطان الشيطان، ويعيدنا لبيت الآب، ويُنهي العداوة بالمصالحة الشافية للروح بالتوبة، وللنفس بالتوبة، وللنفس بالقداسة، وللجسد بالحفظ من إغراءات أو شهوات تضر بالكيان الإنساني. ونخلص من كل هذا أن مراحل الشفاء الإرادي من أي ضرر شرير تتوقف على الصوم بطريقة روحية تقدّس الإرادة، لذلك قيل «وتنبت صحتك سريعًا» (إش58: 8).
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد
24 فبراير 2020
فكر الصوم
الصوم ليس هو الجوع، ولكنه التوبة والرجوع بمعنى تغيير الفكر، الذي يُمثّل الاتجاه الذي يحدّد علاقة الإنسان بالله... ومن هنا كان للصوم فكر هدفه ضبط فكر الصائم حتى يتجه نحو الله ويحبه، ومن هنا كان للصوم فكر روحي قوي تقدمه الكنيسة لنا في قراءات آحاد وأيام الصوم المقدس.أحد الرفاع: العبادة في الخفاء «أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية»، بمعنى «أدخل مخدعك وأغلق بابك» أي الاتجاه الخفي العميق في القلب الذي يحب الله ويريده. فالصوم فرصة للعلاقة الفردوسية مع الله، حيث بدأ آدم وحواء حياتهما مع الله صائميْن، أي لا يأكلان من الثمرة الممنوعة، فكانت العشرة المقدسة مع الله والحديث المتبادل معه.أحد الكنوز: أي كيف تكتنز كنزًا سمائيًا في الصوم لأنه «حيث يكون كنزك، هناك يكون قلبك»... والاكتناز المادي يضيع، لكن الكنوز الروحية لا تفنى ولا تتبدّد، فليست المشكلة في الاحتياج المادي، ولكن العلاج في الشبع الروحي الذي يرفعنا فوق كل الكائنات الأرضية، فلا يقدر أحد أن يخدم سيدين، بل اطلبوا أولًا ملكوت الله وبرّه وهذه كلها تُزاد لكم... فالكنز الحقيقي هو أن يملك الله على الإنسان، لكي يملك الإنسان مع الله في الأبدية السعيدة.أحد التجربة: نتيجة حسد الشيطان للصائم يحاربه بالأكل، وإذا رفضها يحاربه بالقنية «أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي». وإذا انتصر عليها يحاربه بالمعجزة «أوقفه على جناح الهيكل» ويطالبه بأن يلقي بنفسه حتى يتأكد أن الملائكة معه وستحمله بلا أذى (مت4: 1-11). وهذا هو أسلوب الشيطان: أن يحارب بالمنطق الشرير للتشكيك والتشويش ونزع السلام.أحد الابن الضال: والتركيز على ترك بيت الآب (الكنيسة)، حيث البحث عن نصيب الذات والمتعة الزائفة مع أصدقاء السوء حيث الكورة البعيدة. ولكن المال ينتهي ولا يبقى سوى خرنوب الخنازير الذي لا يجده مَنْ يريده، لأن الشيطان ليس ملجأً، بل يبغي ضلال الإنسان. والصوم يعيد الابن إلى حضن أبيه بالتوبة ورفض الكورة البعيدة، فينال الحُلة الأولى والعجل المُسمن فرحًا وابتهاجًا بالعودة المرتقبة، إذ عينا الآب لا تكفّان عن البحث عن الضال.أحد السامرية: كمثال للضلال والبحث عن الماء والارتواء بعيدًا عن الله مع ستة أزواج، فتجد عند البئر مخلص العالم والعريس الحقيقي للنفس البشرية، فيدعوها إلى الماء الحي لترتوي بعد ظمأ سنين كثيرة، لأنها تشرب من الماء الذي يعطش مَنْ يشرب منه باستمرار، فلأنها التقت بالمسيا نالت ما جعلها تُقِرّ وتعترف بأخطائها وترغب في السجود بالروح والحق.أحد المخلّع: وهو مثال للشلل الإرادي الذي يقترب من الماء دون شفاء إذ ليس له مَنْ يلقيه أولًا في الماء بعد أن يحرِّك الملاك الماء، فيأتي الإنسان الذي يبحث عنه ليشفيه ويأمره أن يحمل سريره ويمشي، لأنه المخلص الشافي للإرادة الشريرة المشلولة الضائعة.أحد المولود أعمى: حيث الشفاء الشامل بخلقة عين جديدة من التراب بيد المخلص وبالماء، حيث الاستنارة الداخلية والحكمة الحقيقية لاقتناء الإنسان الروحي المولود من فوق. وهكذا يجدِّد الصوم وفكره الروحي حياة الصائم من خلال العبادة ليكنز وينتصر ويتوب ويتجدد.
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد
17 فبراير 2020
بين القوة والعنف
كثرت أحداث العنف في هذه الأيام في مجتمعنا المصري الهادئ بطبعه، والمُعبَّق بالمحبة كطبيعته. ويظن البعض أو القِلّة التي تستخدم العنف والقتل، أنه لون من القوة. بينما العنف ضعف، فالقوة تساعد لكن العنف يُسيء للآخرين، ويدل على تعصب ديني أو أفكار خاطئة أو خضوع لأعصاب ملتهبة تُترجَم إلى شتائم أو سباب بعبارات لا تليق، وكلها خطايا لا تليق تَنُمّ عن رغبة في الانتقام أو التسيُّد على المجتمع، ورغبة في التخلُّص من الآخر بدلًا من الوحدة معه كنسيج قوي يحمل فضائل المحبة والاحتمال والاتضاع والوداعة ونبذ العنف، كمجتمع قوي يؤمن بالله القوي، وليس مجتمعًا يتخذ أسلوب العنف الذي هو الضعف، بل والشر في صور عديدة بغيضة يُقَسَّم المجتمع، وينتج عن هذا عواقب وخيمة وشريرة.. لذلك ينصح معلمنا بولس الرسول في مواجهة الصعوبات: «بل في كُلِّ شَيءٍ نُظهِرُ أنفُسَنا كخُدّامِ اللهِ، في صَبرٍ كثيرٍ: في شَدائدَ، في ضَروراتٍ، في ضيقاتٍ، في ضَرَباتٍ، في سُجونٍ، في اضطِراباتٍ، في أتعابٍ، في أسهارٍ، في أصوامٍ، في طَهارَةٍ، في عِلمٍ، في أناةٍ، في لُطفٍ، في الرّوحِ القُدُسِ، في مَحَبَّةٍ بلا رياءٍ» (2كو6: 4-6).+ مصادر العنف: الرغبة في التسلّط، والتباهي بالجريمة، وإرهاب الناس الآمنين وترويعهم كمظهر من مظاهر الرفض، وصنع القلاقل والتوتر المؤذي للأمن وللحياة وللسلام، والذي يُصًدّر الموت ويهدّد الحياة الآمنة المستقرة. ونحن كمصريين نرفض هذا بشدة، والتاريخ يُظهر حقيقة هامة وهي أن مَنْ يستخدم العنف ينتهي مثل الوثنيين وغيرهم، بينما مَنْ يتحمل الإساءة وينشر السلام والوئام في المجتمع يقوى وينتشر ويجذب الجميع ويغفر للآخرين زلّاتهم ويقدم القدوة للفضيلة التي تفوق القانون الوضعي وتسمو عنه.فالقوة تتفوق على العنف وتغلبه، وتحول الموت المدمّر إلى سلام بإبادة صانعي العنف ومُصَدّري الموت للأبرياء. فقوة التعاليم الدينية السمحة، وقوة القانون، وقوة الوحدة المجتمعية، تتحد ضد العنف، وتخلص المجتمع من هؤلاء العنفاء الأشرار. لذلك فإن الشهيد أسطفانوس وهو يُحاكَم أمام المجمع كان حكيمًا قويًا، ولم يستطيعوا أن يقاوموا قوته، فيقول سفر الأعمال: «ولَمْ يَقدِروا أنْ يُقاوِموا الحِكمَةَ والرّوحَ الّذي كانَ يتَكلَّمُ بهِ» (أع6: 10).وفي هذا نستنجد بقوة الله وعمله المعجزي، وقوة الدولة بجيشها وشرطتها ورجال القانون فيها، وقوة القانون نفسه الذي يحكم على مَنْ يؤذي غيره ويخلص المجتمع منه ومن أمثاله. وسبيلنا في هذا بنشر روح الحب والوحدة، ونبذ الكراهية، وتقديم الأمثولة الصالحة في الحوار المجتمعي الهادئ، والتأثير الروحي القوي بالصبر وطول الأناة، والقناعة الداخلية بأن الحياة أقوى من الموت، والبعد عن الرغبة في الانتقام الشخصي الذي يحول المجتمع إلى غابة يأكل فيها القوى الضعيف، والبعد أيضًا عن التكتلات الشريرة التي تؤدّي إلى إشعال الغضب بين الأطراف فتشتعل البلاد بطريقة تهدم السلام والهدوء والتنمية والبناء.+ الفكر المستنير: يؤمن بأن نعمة الله تكفي لتحوِّل الضعف إلى قوة أكثر من أي سلاح حاد، فالله يكره إزهاق الروح، ويرفض القتل والعنف، ونعمته تقوّي الضعيف لينتصر على العنيف، وأقصد أن نعمة الله عملت في النبي موسى فانتصر على فرعون صاحب القوة الغاشمة، وفتح الله للشعب بقيادة النبي موسى البحر ليعبروا في سلامٍ وأمان بينما غرق فرعون وكل قوته في البحر الأحمر، وهذا هو مصير العنفاء القتلة، مثلما حدث مع جليات الذي أراد قتل الناس فأعطى الله داود النبي قوة ليقتله بوسائل بسيطة من يد الله وفوق قدرة داود. وببركة الشهداء ضحايا العنف ينتصر المجتمع على العنف ومَنْ يتبعه، بوحدة الجميع ضده، ندعو الله مخلصين أن يحرّر مجتمعنا من العنف لتبقى القوة من الله أقوى بكثير جدًا من العنف.
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد
03 فبراير 2020
المذبح العائلي
مع اقتراب فترة مقدسة هي الصوم الأربعيني المقدس الذي صامه رب المجد بنفسه في الجبل، وهي فترة من أقدس أيام السنة كلها، تتسم بأنها فترة عبادة على مستوى الكنيسة في القداسات اليومية، وعلى مستوى الأسرة أيضًا فيما يُسمّى بالمذبح العائلي أي خدمة الصلاة اليومية بالمزامير، وهذا له تأثير قوي في اجتماع الصلاة مع الصوم في حياتنا مما يجعل العلاقة بالله متكاملة ويُضاف إليهما الصدقة، وهم أركان العبادة المسيحية، إذ بالصوم ينضبط المصلي في صلاته ويأخذ من محبة الله للخليقة فيعطي على قدر ما يستطيع.وهنا نذكر أن الصوم يجعل الجسد ذبيحة حب لله، وبالصلاة يقدم ذبائح شكر لله وتسبيحًا، وبالصدقة يعطي للمحتاجين على مثال الله العاطي فيتشبه بالله في صنع الخير لمن يحتاج. لذلك نجد في كنائسنا في فترة الصوم قداسات يومية في الكنيسة، وحرصًا على إشباع الجائع والمحتاج، ونردد في ألحان الصوم اللحن الشهير: "طوبى للرحماء على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين (يوم الدينونة في القيامة العامة).."الصوم دعوة لإقامة المذبح العائلي: فنجد في (يشوع24: 15) «أما أنا وبيتي فنعبد الرب».. وهذا مبدأ روحي مهم جدًا يجب أن نأخذه في الاعتبار في الصوم خاصة، وطول أيام حياتنا عمومًا، لأن وجود الله في البيت مهم لكي يقود روح الله الأسرة، وهي أفضل عبادة وقيادة «إن لم يبنِ الرب البيت، فباطلًا تعب البنائون» (مز127: 1)، وهكذا يضع الله أساسًا قويًا للأسرة، ويبني كل أفرادها على الوصية الإلهية وتنفيذها بحرص شديد، لأن خلال الصلاة والصدقة في الصوم تُبني حياة كل أفراد الأسرة وأحد الآباء يقول: "الكنيسة المقدسة ليست مجرد حوائط مبنية، ولكنها تُعَبَّر عن قلوب المؤمنين التي تحب الله، ومسكن لله بداخلها". لذلك ينبغي أن نبني مذبحًا للرب داخل بيوتنا ليسكن الله فيها، وهذه هي الوصية «قُم اصعد إلى بيت إيل وأَقم هناك مذبحًا لله» (تك35: 1) وهنا نؤكد أن قداسة الجماعة من خلال الصوم والصلاة حول المذبح، لتصير الأسرة أيقونة حَيَّة سمائية تخلو من العيوب التي تهدمها لكن عمليًا ماهو المذبح العائلي؟: جزء من البيت مُخصَّص للعبادة والصلوات والجلسات الروحية الفردية أو للأسرة كلها للصلوات ويقول القديس كبريانوس: "إن كان اثنان بفكر واحد يستطيعان أن يفعلا هكذا متى وُجِد اتفاق في الفكر، فكم بالأكثر بين الجميع".. وهكذا تكون الصلاة مؤثرة إذا وُجِدت وحدانية القلب بين الجميع. ويقول الأب يوحنا من كرونستادت: "الصلاة الجماعية تُستجاب سريعًا وتأتي بثمار كثيرة عندما تكون بوحدانية الرأي واتفاق الأهداف، ويُضاف إلى ذلك التمتع بكلمة الله التي هي غذاء روحي قوي «فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله»."والسيد المسيح يوصي بحفظ كلمته كدليل لحبه الذي يملأ القلب في الصوم : «إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلًا»، فإن كان الصوم دليل حبنا لله فهكذا حفظ وصاياه..( يو14: 23)..
نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها
المزيد