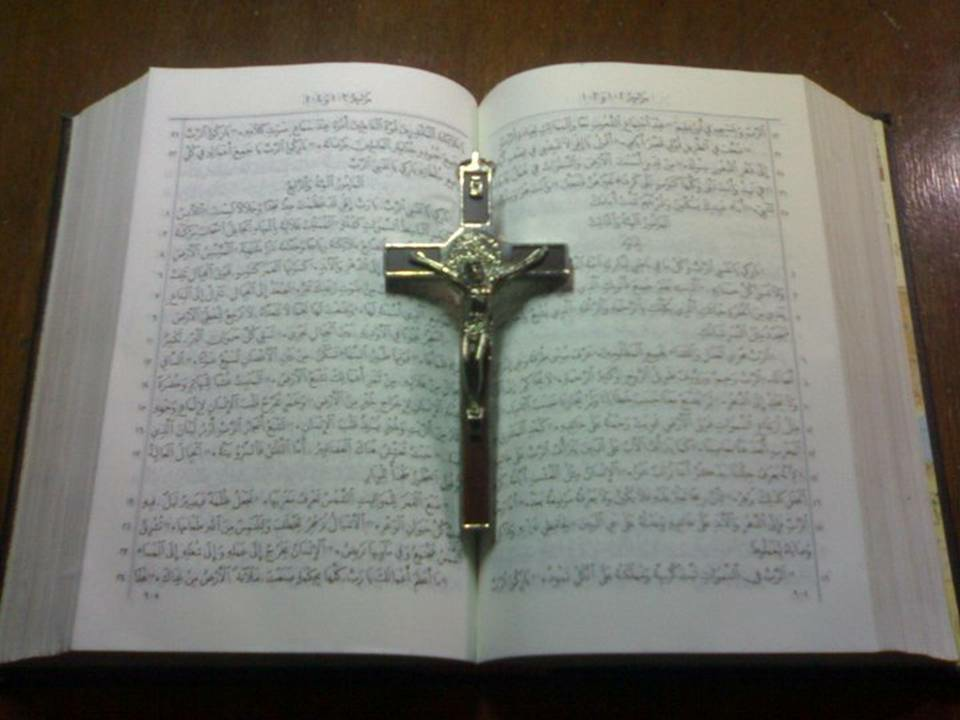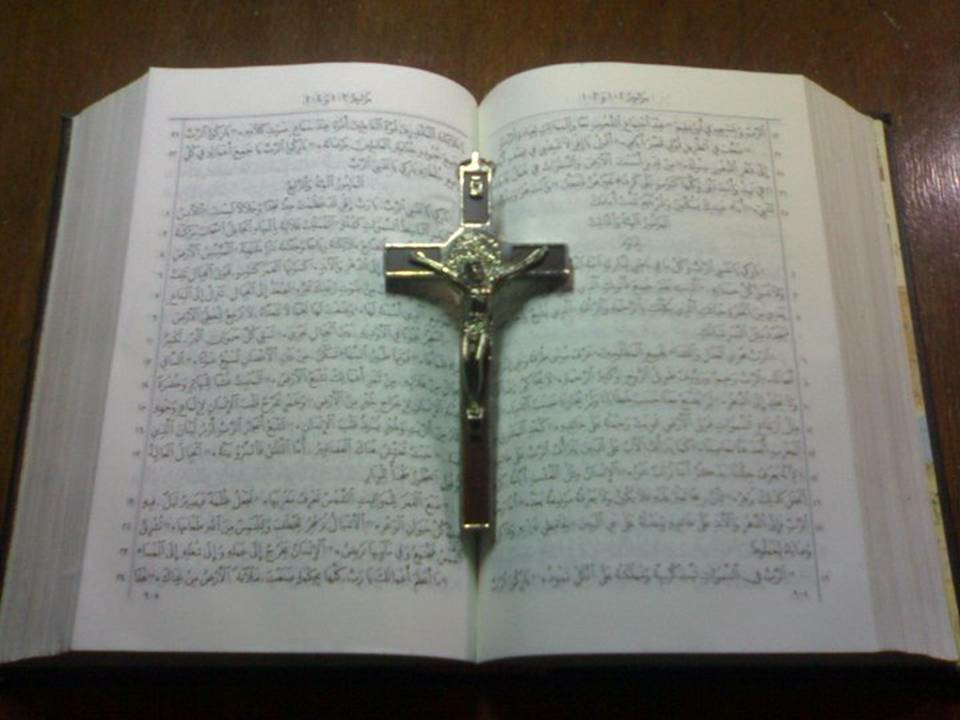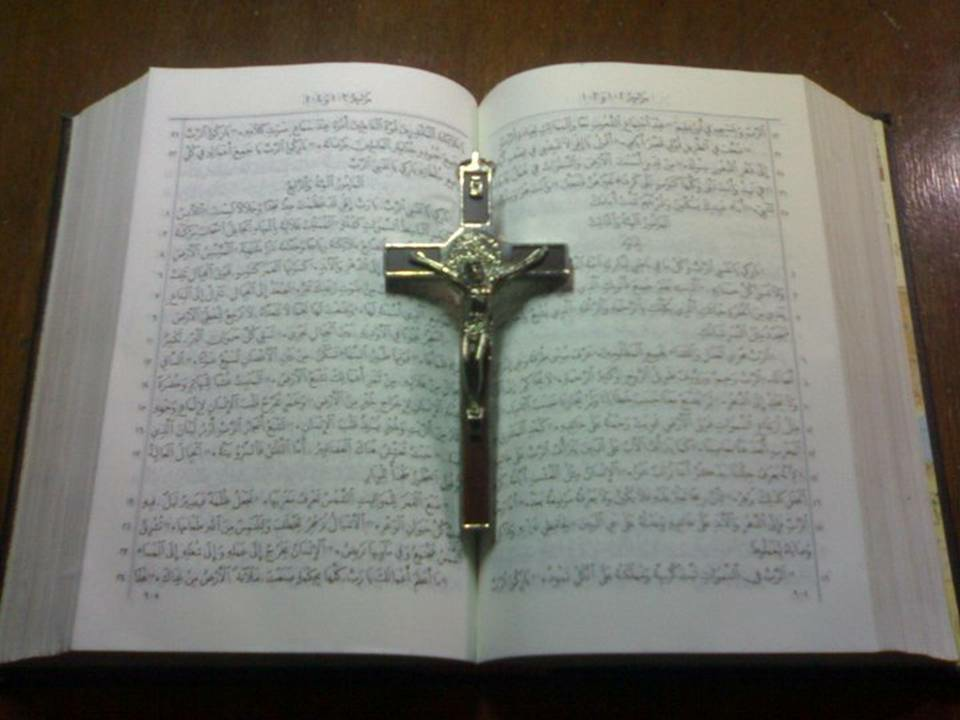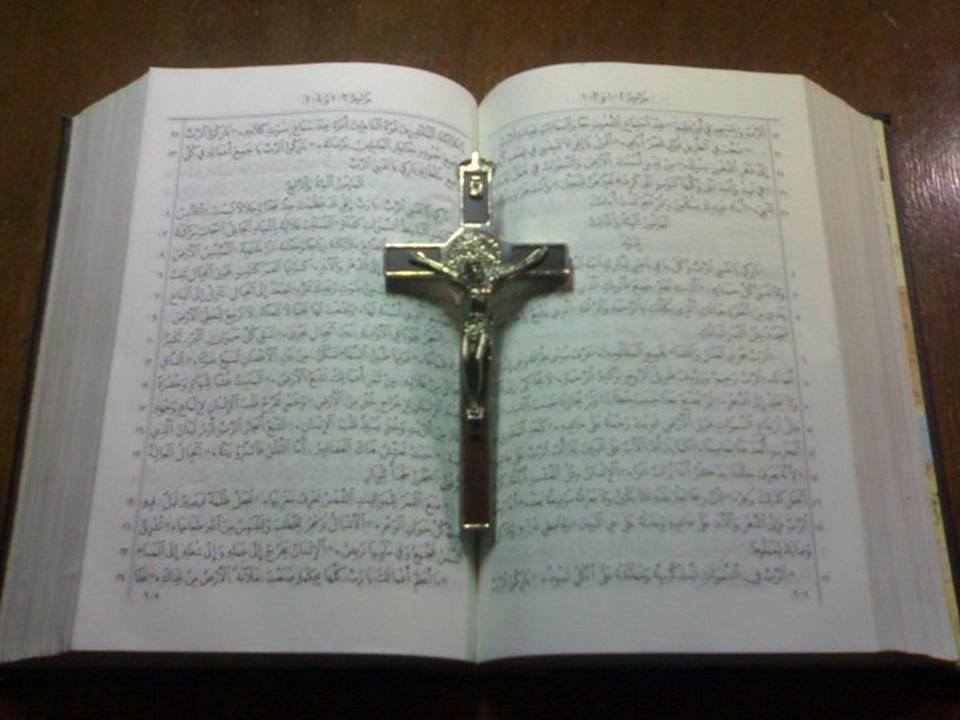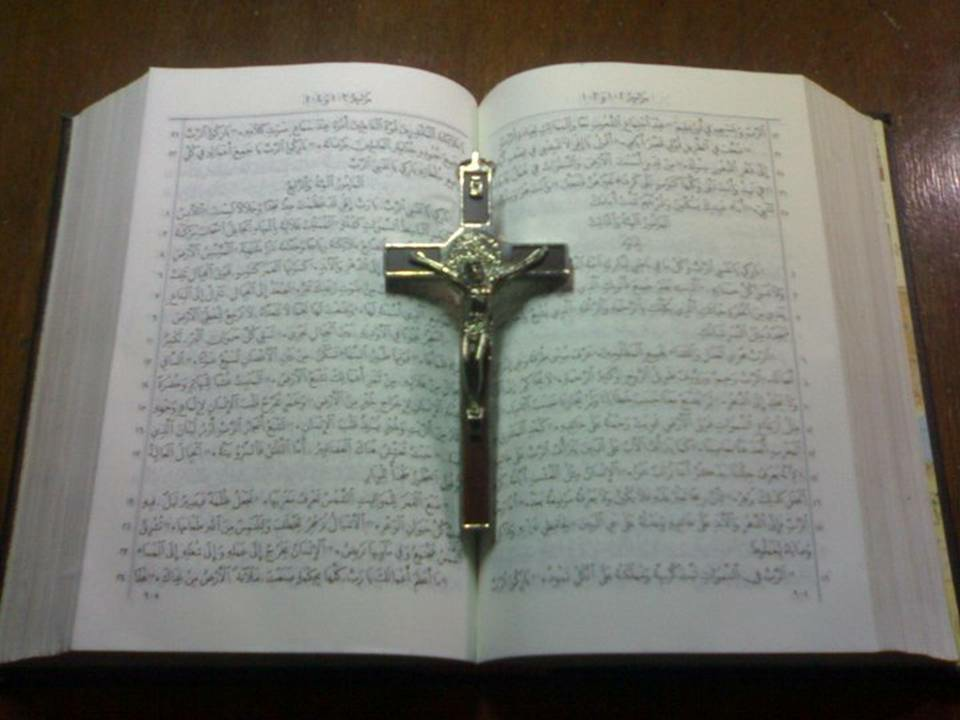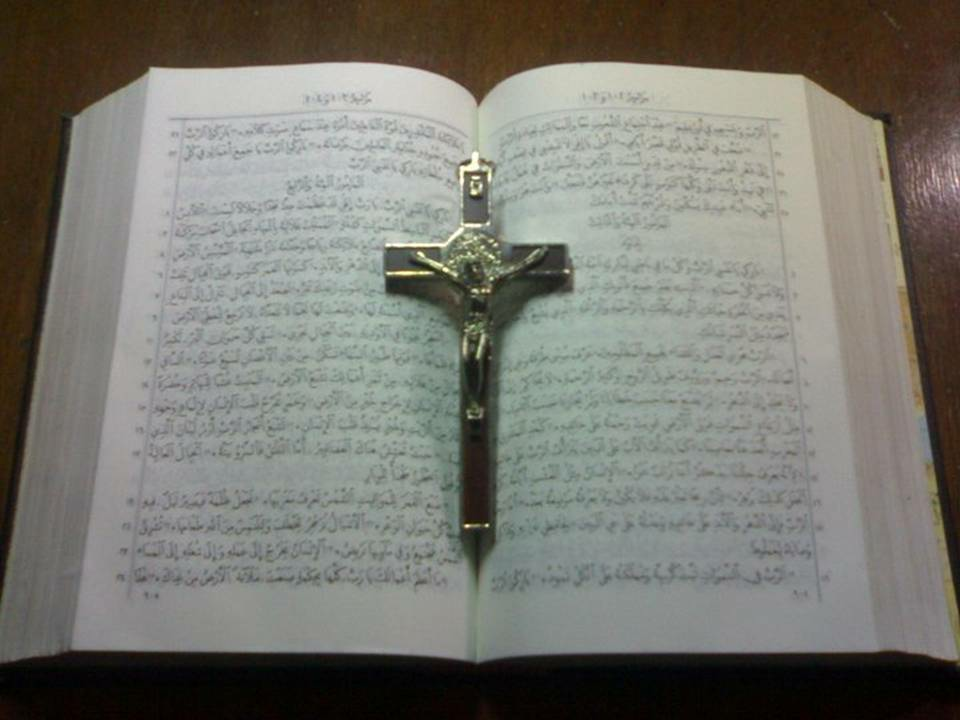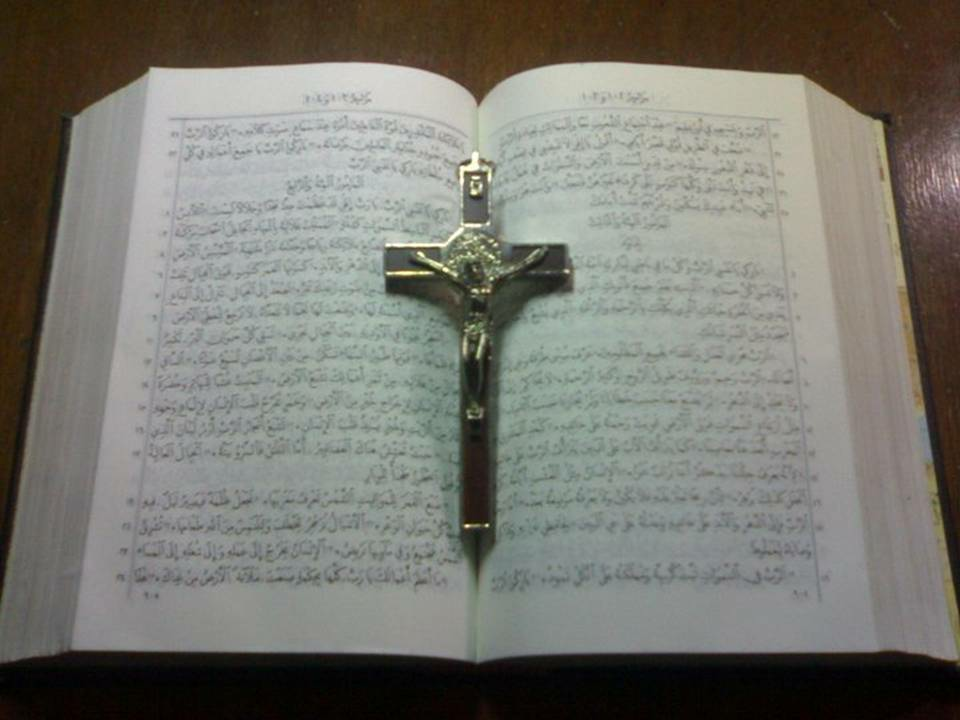المقالات
29 يناير 2025
الرهبنة القبطية
جاءت الرهبنة القبطية كنتيجة طبيعية لتعاليم المسيحية السامية من جهة، ومن جهة أخرى كرغبة في الحياة حسب النموذج الذي أعطاه السيد المسيح من خلال حياته على الأرض، وكذلك نموذج القديس يوحنا الحبيب، قال الرب يسوع: «لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ ، ويوجد خصيان خصاهُمُ الناس، ويوجد خصيانٌ خَصَوْا أَنفُسَهُمْ لأَجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل (متى ۱۲:۱۹)، ثم جاء القديس بولس والذي عاش في البتولية أيضًا ليقول: "وَلَكِنْ أَقُولُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجِينَ وَلِلأَرَامِلِ، إِنَّهُ حَسَنٌ لَهُمْ إِذَا لَبِثُوا كَمَا أَنَا فَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا بِلَا هُمْ غَيْرُ الْمُتَزَوْجِ يَهْتُمُ فِي مَا لِلرَّبِّ كَيْفَ يُرْضِي الرَّب إِذَا مَنْ زَوْجَ فَحَسَنًا يَفْعَلُ، وَمَنْ لَا يُزَوِّجُ يَفْعَلُ أَحْسَنَ" (كورنثوس الأولى٧ : ۸،۳۲،۳۸). والراهب هو الشخص الذي لم يستطع أن يحيا وصية المسيح بكمالها وهو في العالم، فانطلق إلى البرية ليتسنى له ذلك، ويكتب ابن العسال أن: "الرهبنة هي فلسفة المسيحية" وكانت للرهبنة القبطية مقدمات، أي أنه وجدت صور باهتة لها في العهد القديم من جهة، وفي بعض ديانات أخرى من جهة ثانية، فقد عاشت جماعة الأسينيين حياة شبه رهبانية في مغارات حول قمران، كما عاشت جماعة "الثيرابيوتا" اليهودية في منطقة مريوط بغرب الإسكندرية،وجدت كذلك جماعات رهبانية بين البوذيين والبراهمة وهم تابعون لكونفوشيوس وبوذا، وفي مصر وجد عباد سيرابيس في منف بمصر، كما أن هناك نماذج لرجال في الكتاب المقدس عاشوا هذه الحياة، مثل القديسة مريم وايليا النبي ويوحنا المعمدان، وحنّة النبية وغيرهم ظهرت الرهبنة المسيحية من مصر، ومؤسسها هو القديس أنطونيوس، وإن كنا نقرأ أنه في عهد الإمبراطور أنطونيوس بيوس (۱۳۸-١٦١م) انطلق الأب فرونتونيوس إلى جبل نتريا مع خمسين شابا ليحيوا هناك ولكنهم لم يستمروا، ويقول العلامة "والس" إن تلك الحملة لم تكن إلا واحدة من حملات عديدة لم تسجلها الكتب المعاصرة لها، لأنها كانت تميل إلى الهدوء دون دعاية أول نماذج للرهبنة القبطية كانت فردية مثل القديس بولا السائح، والذي عاش وحيدًا مدة تسعين سنة، ولولا لقائه بالقديس أنطونيوس لما عرفنا عنه شيئًا، الأنبا أنطونيوس ذاته ترهب أولاً بمفرده، وتتلمذ على شيخ قديس يحيا منفردًا مثل كثيرين، قال عنهم لاحقاً عندما سُئل عن مرجعيته الرهبانية: "إن كتبي هي شكل (طقس) الذين سبقوني"، وكان كثيرون قد خرجوا من قراهم ليحيوا على أطرافها. كذلك نقرأ عن بيوت للعذارى وجدت قبل تجمعات الرجال الرهبانية. وهكذا تكونت الرهبنة على مرحلتين، الأولى المتوحدين والنساك الفرادى، والثانية: الشركة والتجمعات الرهبانية.
آباء الرهبنة الأوائل: يُعتبر القديس أنطونيوس هو أب الرهبنة في العالم، حيث أسس أول جماعة رهبانية لها قانون ومرجعية، تلمذ كثيرين ومنهم آباء عظام، مثل القديسين مكاريوس الكبير وباخوميوس وآمون وإيلاريون وسيرابيون وغيرهم، كما يُعتبر القديس باخوميوس مؤسس نظام الشركة، حيث رأى أن يحيا الرهبان في مجموعات، يعملون ويصلون ويقيمون معا للتشجع، بينما انتهج القديس مكاريوس الكبير النظام الذي يجمع بين الوحدة والشركة، ثم ظهر القديس الأنبا شنوده كأب رهبنة وزعيم وطني وواعظ بليغ ورئيس للمتوحدين. شهد القرنان الرابع والخامس أزهى عصور الرهبنة، كثرت الأديرة وازداد عدد الرهبان بشكل مذهل، حتى شهد
بلاديوس بأن أصوات تسبيح الرهبان كانت تسمع متصلة من أسوان إلى الاسكندرية على طول الصحراء الغربية، كما انتشرت مغارات المتوحدين لدرجة أن بعض عدد مغارات المتوحدين كانت تقارب - وتفوق أحيانًا - عدد القلالي داخل الأديرة، مثل الفيوم والتي فاق عدد قلالي الرهبان فيها عدد مساكن الناس. ومن أشهر التجمعات الرهبانية: بسبير (في الصعيد الأوسط)، ونتريا منطقة البحيرة (حاليا)، ومنطقة القلالي (النوبارية)، والأسقيط (وادي النطرون) ومنطقة البهنسا (في الصعيد الأوسط)، ومنطقة ليكوس (بالقرب من أسيوط)، ومنطقة أنتينوس (ملوي) وغيرها كثير هذا وقد اعتبرت الصحراء الأرض المقدسة بعد أورشليم ووفد لزيارتها الكثيرون من مشاهير الكنيسة الشرقية والغربية، مثل باسيليوس هيلاريون، أيرونيموس، وبلاديوس وكاسيان.. وكتبوا الكتب عنها كثيرا.
وكانت الرهبنة أقوى ما كانت عندما كانت قائمة على التفرد، حيث كان للراهب البعد الاختباري مع الله حيث يؤمن له كافة احتياجاته وتعزياته، ذلك قبل أن يصبح للرهبان حصون في القرن السادس، وأسوار منذ القرنين التاسع والعاشر، وأصبحت هناك مخازن للطعام وأبواب ومزاليج وبوابون، وفي وقت لاحق زراعات ومشروعات. وقد حذر الآباء مبكرًا من مثل هذا: أن تقترب المساكن أو الزراعات من الأديرة، وقالوا: إن كل نياح جسداني ممقوت عند الله. والآن يتوق الآباء والأمهات رؤساء الأديرة ومعهم الآباء الرهبان والأمهات الراهبات - بكل قلوبهم - للعودة إلى الطقس الأول للرهبنة، وأن تعود الأديرة إلى الهدوء. ولما كان الرهبان والأديرة من أولى اهتمامات قداسة البابا تواضروس الثاني، كما رأى قداسته بنظرة ثاقبة أن النهوض بالكنيسة يبدأ بالاهتمام بالرهبنة، ومن هنا جاء مؤتمر الرهبنة الذي عُقد بدير القديس الأنبا بيشوي في الفترة من ١٤-١٦ يناير ۲۰۱۳م.
المزيد
23 يناير 2025
بدعة بولس السميساطي أسقف أنطاكية
مؤسس البدعة السيموساطية هو بولس السميساطى وأدخلها فى أنطاكية
من هو بولس السيموساطي؟
ولد بولس فى بلدة تدعى سيمساط (وهى مدينة صغيرة ما بين النهرين)عن والدين فقيرين،وقد أصبح واسع الغنى بوسائل محرمة،ولا يعلم بأى طريقة أستطاع بها أن يصبح بطريركاً على الكرسى الأنطاكى إلا أنه يمكن القول أنه بجانب غناة وسلطته فقد كان بولس السيموساطي خطيباً مفوّهاً وسياسياً ماهراً ماكراً فإستطاع أن يحتل مركزاً مرموقاً في مملكة الملكة زينوبيا التي كانت تعرف بميلها لليهود فقد وكلت إليه جباية الخراج (الضرائب) فتقلد منصب دوسناريوس (أى والى مدنى من الدرجة الولى ذو مرتب سنوى 280 سترشيا عملة ذلك الوقت)، ورغبة منها في الانفصال عن روما فقد ساعدت بنفوذها بولس السيموساطي حتى يجلس على كرسى أسقفية إنطاكية عام 260م الذى كان يشاركها فى الميل لمناصبة روما العداء، وكان يحرص على وظيفته المدنية حرصاً شديداً لأنها كانت فرصة لأذلال شعبه كما كانت سلاحاً يستخدمه ضد الإكليروس عند مقاومتهم له نتيجة لهرطقته وسلوكه الشائن.
أخلاق بولس السيماساطى
ولما أثرى بعد فقر مدقع وشديد، وأنبسطت طالت يدة بعد أن كانت مغلولة فإنهمك فى الملذات والشهوات، فكان يصحب معه فى أى مكان يذهب إليه إمرأتين جميلتين يقضى معهما أكثر أوقاته، وكان مغرماً بالرفاهية والعظمة فلم يكن يسير فى الطرقات إلا ومائة من الخدم يتقدمونه ومائة أخرى يتبعونة يلبسون أفخر الثياب - وأبدل التراتيل التى تقال فى الكنيسة لتمجيد الرب الإله بنشائد تمجده وكلف بإنشادها فى الكنيسة بعض النسوة - وكان إذا خطب أو وعظ يجعل الناس تصفق له فى آخر كل عظة.
محتوى بدعة بولس السيموساطي:
كان بولس السيموساطي يعلم بأن الله واحد، أي أقنوم واحد، وفي هذا الأقنوم يمكننا أن نميز بين اللوجوس والحكمة، وهما عبارة عن صفتين وليسا أقنومين. خرج اللوجوس من الله أو انبثق منه منذ الأزل، وهو الذي كان يعمل في الأنبياء، وأيضاً في يسوع الذي وُلد من العذراء، أي أن يسوع إنسان مثلنا تماماً، مع أنه أعظم من موسى والأنبياء، ولكنه إنسان كامل، وقد حلّ اللوجوس في هذا الإنسان يسوع لذا لابد من التمييز بينه وبين يسوع. فاللوجوس أعظم من يسوع لأن يسوع بشري مثلنا، ويقول أن كلمة الإله حل فيه بعد ولدته من العذراء ونشط بعد حلول اللوجوس على يسوع وقت عماده وارتبط به برباط المحبة القوية. وبفضل رباط المحبة هذه استطاع يسوع أن ينتصر ليس فقط على الخطيئة بل أيضاً على خطيئة أجداده، لذا أصبح فادياً ومخلصاً لأنه تمّم مشيئة الله بطريقة كاملة، وبسبب أتحاد الكلمة الإلهية بهذا النسان يمكن القول أن المسيح هو الإله وليس بمعناها الحقيقى، ونشأ عن هذه البدعة والهرطقة فكر آخر وهو أنه كان فى المسيح أقنومان وأبنان للأله أحدهما بالطبيعة والآخر بالتبنى، وبذلك أنضم غلى سابيليوس فى انكار الثالوث الأقدس بقوله يوجد إله واحد تحسبه الكتب المقدسة بالآب وأن حكمته زكلمته ليست اقنوماً بل أنها فى العقل الإلهى بمقام الفهم فى العقل الإنسانى.
الكنيسة تحرم بولس السيموساطي:
وظهر فى ذلك الوقت كاهناً يُدعى ملخيون لإظهار أضاليل بولس ودحض بدعته وانضم إليه عدد من الكهنة والأساقفة منهم لينوس أسقف طرسوس، فدعا لعقد مجمع محلي في إنطاكية عام 264،ولكن هذا المجمع لم يصل لأية نتيجة لتدخل الملكة زينوبيا، وقد أعقبه مجمع آخر في إنطاكية ولم يصل أيضاً لنتيجة أيضاً،ولكن لم يمل أصحاب الإيمان القويم واستمروا في نضالهم ضد بولس السيموساطي،وبلغ البابا ديونيسيوس أخبار هذا الهرطوقى المخالف للعقيدة والأخلاق أرسل إليه العديد من الرسائل ووضح فيها مخالفة أفكاره لنصوص الكتاب المقدس وشهادات الآباء وقد أجاب بولس على رسائله موارباً وموارياً على ضلالته، ولأجل بدعته عقد فى أنطاكية مجمعاً وتكرر أنعقادة ويقول الأنبا ساويرس فى تاريخ البطاركة: " ولما طعن البابا ديونيسيوس فى ايامه ضعف جسده من كثرة ما لحقة من أضطهاد ولم يفتر مع هذا ليلة واحدة من قراءة الكتب المقدسة فلما علم الرب محبته للكتب أنعم عليه بقوة بصره حتى أنه صار يبصر كما كان فى ايام شبابه، ولما لم يقدر أن يذهب إلى مجمع أنطاكية الذى أجتمع فيه لمناقشة ما يقوله بولس السيماساطى أرسل برسالة مملوئة حكمة وتعاليم إلى ألساقفة المجتمعين به، لأن بوله كان كالقشب الذى يهر على الخراف، فمضى أساقفة المجمع مسرعين إلى أنطاكية بمجد السيد المسيح ومن جملة من حضر المجمع برمليانوي أسقف قيسارية قبادوقية، وغريغوريوس أسقف قيصرية الجديدة وأخوه أيثنوذوروس، وايلينوس أسقف طربيوس، ونيقيدوموس أسقف أبقونيا، وأيماناوس أسقف أورشليم، ومكسيموس أسق وسطراً وجماعة معهم أساقفة وقسوس وشمامسة "وكان بولس السيماساطى حينما يحضر المجمع يراوغ كثيراً فى أقواله، فكان تارة يستغيث من قساوة الأساقفة عليه، فمن جهة لا يبوح بحقيقة هرطقته وأفكاره،وتارة ينكر ما عزى إليه من ضلال، ثم يظهر موافقته للمجمع بما يطلب التصريح به، ولكن يرجع مرة ثانية لبدعته لهذا ينطبق عليه المثل " الكلب يرجع لقيئة " ولما أتنفذ فرص توبته ولم يرتدع كتب اعضاء المجلس كتب أعضاء المجمع إلى البابا مكسيموس البطريرك الأسكندرى وديونيسيوس أسقف روما يسردون فيها نقائص وعيوب بولس السيماساطى وإصرارة على بدعته وضلاله، ثم عقدوا بشأن ضلالته مجمعاً آخر أكبر حضره أساقفة أكثر وعُقد هذا المجمع في انطاكية عام 268م وقد قام ملخيون باستجواب بولس في هذا المجمع حتى استطاع إظهار ضلالته أمام الجميع ، وقام آباء المجمع بالكتابة إلى أسقفي روما والإسكندرية وأساقفة الكنائس الأخرى شارحين ضلالة بولس السيموساطي. فخلعوا بولس السيماساطى من بطريركية أنطاكية قلم يرضخ بالحكم وأعتصم بالدار البطريركية رافضاً الخروج منها وأستعان بقوة تدمر الحربية وواصل بولس البقاء في منصبه كأسقف رافضاً قرار المجمع وذلك بسبب مساندة الملكة زينبيا له، واستمر الحال هكذا لمدة أربع سنوات حتى سقطت الملكة وسقط معها بولس وكل تعاليمه.وبعد خلع بولس السيماساطى من من بطريركية الكرسى الأنطاكى وأقاموا بدلاً منه دمنوس، فعرض الأساقفة أمره إلى القيصر الرومانى أورليان فحكم بأن تعطى الأسقفية لمن أنتخبه المجمع ونفى بولس السيماساطى ذكر المؤرخ يوسابيوس القيصرى فى كتابه تاريخ الكنيسة بدعة بولس السميساطى تحت عنوان " بولس السميساطى والبدعة التى أدخلها إلى أنطاكية" فقال:
1 - بعد أن رأس زيستزس كنيسة روما أحدى عشرة سنة خلفه ديونيسيوس سمى ديونيسيوس الأسكندرى، وحوالى نفس الوقت مات ديمتريانوس فى أنطاكية ونال تلك السقفية بولس السميساطى .
2 - ولأنه كان يعتقد أعتقادات وضيعة عن المسيح - مخالفة لتعاليم الكنيسة - أى أنه كان فى طبيعته إنساناً عادياً، فقد توسلوا إلى ديونيسيوس الأسكندرى ليحضر المجمع، ولما لم يتمكن من الحضور بسبب تقدمه فى السن وضعف جسمه أعطى رأيه فى الموضوع الذى تحت البحث برسالة أرسلها إليهم، ولكن جميع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا فى انطاكية كأنهم قد أجتمعوا ضد مبدد قطيع المسيح ذكر المؤرخ يوسابيوس القيصرى فى كتابه تاريخ الكنيسة (ك7 ف 28) (عن الأساقفة الذين ذهبوا لدحض بدعة بولس السميساطى تحت عنوان " أساقفة ذلك العصر البارزون " فقال:
1 - من بين هؤلاء كان فرمليانوس (ك6 ف 26) العظيم أسقف قيصرية كبادوكية، وألخوان غريغوريوس (غريغوريوس صانع العجائب ك6 ف 30) وأثينودورس، وبعض الرعاة من كنائس بنطس وهيلينوس (ك6 ف 46: 3) أسقف أيبروشية طرسوس ونيكوماس أسقف أيقونية، وعلاوة على هؤلاء هيميناس (ك7 ف 14) أسقف كنيسة أورشليم وثيوتكنس أسقف كنيسة قيصرية المجاورة، يضاف إلى هؤلاء مكسيموس الذى رأس ألخوة فى بوسترا (ك6 ف 33) بكيفية ممتازة وإن أراد أحد إحصائهم لوجد آخرين كثيرين علاوة على القسوس والشمامسة الذين أجتمعوا وقتئذ لنفس الغرض فى المدينة السابق ذكرها (أنطاكية) ولكن هؤلاء كانوا أبرزهم.
2 - وحينما أجتمع كل هؤلاء فى أوقات مختلفة لبحث هذه المواضيع كانت الحجج والأسئلة تناقش فى كل إجتماع، وكان أنصار السميساطى يحاولون أن يداروا ويخفوا هرطقته، وحاول الآخرون بكل غيرة أن يفضحوا ويعلنوا هرطقته وتجديفه على المسيح.
3 - وفى نفس الوقت مات ديونيسيوس فى السنة الثانية عشرة من حكم جالينوس بعد أن لبث أسقفاً 17 سنة وخلفه مكسيموس.
4 - وبعد أن لبث جالينوس فى الحكم 15 سنة خلفه كلوديوس الذى سلم الحكم إلى أوريليان بعد سنتين.
ذكر المؤرخ يوسابيوس القيصرى فى كتابه تاريخ الكنيسة (ك7 ف 29) عن حرم بولس السميساطى تحت عنوان " وبعد أن دحض ملخيون (أحد القسوس الفلاسفة) آراء بولس صدر الحكم بحرمة " فقال:
1 - وفى أثناء حكمة عقد مجمعاً آخر مؤلف من أساقفة كثيرين، وكشف عن منشئ الهرطقة فى أنطاكية، وفضحت تعاليمه الكاذبة أمام الجميع، فحرم من الكنيسة الجامعة تحت السماء.
2 - وقد أخرجه ملخيون من مخبه ودحض آراءه، وهذا كان رجلاً متعلماً فى نواح أخرى، وكان رئيساً لمدرسة الفلسفة اليونانية فى أنطاكية، ونظراً لسمو إيمانه بالمسيح، رسم قساً لتلك الأيبروشية، وإذ ناقشة هذا الرجل مناقشة خطيرة دونها الكتاب الحاضرون، ولا زالت باقية إلى ألان، أستطاع وحده أن يكشف حقيقة الرجل الذى ضلل وخدع ألاخرين ذكر المؤرخ يوسابيوس القيصرى فى كتابه تاريخ الكنيسة (ك7 ف 30) عن رسالة الأساقفة ضد بولس السميساطى فقال:
1 - أما الرعاة الذين اجتمعوا من أجل هذا الأمر فقد أعدوا بإجماع الآراء رسالة موجهة إلى ديونيسيوس أسقف روما ومكسيموس أسقف الأسكندرية وأرسلوها إلى جميع الأقطار، وفى هذه بينوا للجميع غيرتهم وهرطقة بولس، والحجج والمناقشات التى دارت معه، كما بينوا حياة الرجل وتصرفاته، وخليق بنا أن ندون فى الوقت الحاضر الأقتباسات التالية من كتاباتهم:
2 - " إلى ديونيسيوس ومكسيموس، وإلى زملائنا الخدام فى كل العالم، ألساقفة والقسوس والشمامسة، وإلى كل الكنيسة الجامعة تحت السماء، هيلينوس وهيميناس وثيوفيلس وثيوتكنس ومكسيموس وبروكلوس ونيكوماس وأليانوس وبولس وبولانس وبروتوجينيس وهيرالكس وأوطاخى وثيودوروس وملخيون ولوسيوس وجميع الباقيين المقيمين معنا فى المدن والأمم المجاورة، أساقفة وقسوس وشمامسة، وكنائس الرب الأله سلام للأخوة المحبوبين فى الرب "
3 - وبعد ذلك بقليل بدأوا قائلين: " لقد ارسلنا ودعونا أساقفة كثيرين من أماكن بعيده ليخلصونا من هذه التعاليم المميتة كديونسيوس السكندرى وفرمليانوس الكبادوكى، هذين المباركين، أما ألول فإذ أعتبر منشئ هذه البدعة غير جدير بأن يوجه إليه أى خطاب أرسل رسالة إلى أنطاكية موجهة لا إليه بل إلى كل الإيبروشية، وقد أثبتنا صورتها فيما بعد.
4 - وأما فرمليانوس فقد اتى مرتين، وشجب بدعته، كما تعرف، ونشهد نحن الذين كنا موجودين، وكما يعرف آخرون كثيرون، ولكنه إذ وعد بتغيير آرائه صدقه، ورجا أن تتخذ الأجراءات اللازمة دون أن تلحق أيه إهانة للكلمة، ولذلك أرجأ الأمر إذ خدعه ذاك الذى أنكر حتى إلهه وربه، ولم يحفظ الإيمان الذى كان يعتقده سابقاً.
5 - ولقد كان فرمليانوس ألان فى طريقة ثانية إلى أنطاكية، ووصل حتى طرسوس، لأنه علم بالأختبار شرة وأنكاره للرب، ولكنه مات بينما كنا مجتمعين ومنتظرين وصوله.
6 - وبعد التحدث عن امور اخرى وصفوا فيما يلى نوع الحياة التى عاشها: " ولأنه قد انحرف عن جادة الإيمان، وأرتد بعد المناداة بتعاليم وضيعة زائفة، فليس من الضرورى - طالما كان قد أخرج خارجاً _ إصدار لأى حكم على تصرفاته.
7 - فمثلاً مع انه كان سابقاً فقيراً معدماً، لم يرث أيه ثروة من آبائه، ولم يجن أى ثروة من تجارة أو أى عمل آخر، إلا أنه الآن أصبح يمتلك ثروة طائلة بسبب شروره وأنتهاكه حرمة المعابد وسلبه للأخوة، وحرمان المظلومين من حقوقهم، ووعده لهم بمساعدتهم نظير أجر معين مع أنه يضللهم، وينهب أولئك الذين فى ضيقهم يكونون مستعدين أن يعطوا ليصطلحوا مع ظالميهم، ظانين أن التقوى تجارة (1 تى 6: 5)
8 - أو كغطرسته وكبريائه وإنتفاخه وإدعائه الكرامة العالمية، مفضلاً أن يدعى نائب الملكة عن أن يدعى أسقفاً، وزهوه وهو يسير فى السواق قارئاً بعض الرسائل بصوت مسموع وهو يمشى علناً يحف به حرس وتتقدمه وتتبعه الجماهير، حتى أصبح الإيمان مكروهاً بسبب كبريائه وغطرسة قلبه.
9 - أو كممارسة الألاعيب الخداعة فى الإجتماعات الكنسية، محاولاً تمجيد نفسه وتضليل الآخرين وإذهال عقول البسطاء، معداً نفسه محكمة وعرشاً مرتفعاً، الأمر الذى لا يليق به كتلميذ للمسيح، ومكاناً سرياً كحكام العالم، ضارباً بيده على فخذه وبقدميه عند دخول المحكمة أو كتوبيخه وأهانته لمن لا يصفقون له، ويلوحون بمناديلهم، كما يحدث فى المسارح، ولا يصيحون ويقفزون كالرجال والنساء المحيطين به، الذين يصغون إليه بهذه الطريقة الشائنة، بل يصغون بوقار كأنهم فى بيت الرب، أو كمهاجمته العنيفه العلانية لمفسرى الكلمة ممن غادروا هذه الحياة وتعظيمه لنفسه لا كأسقف بل كفيلسوف ومشعوذ.
10 - وإبطاله الترانيم الموجهة إلى ربنا يسوع المسيح كأنها إختراعات عصرية للرجال العصريين، وتدريبه النسوة لأنشاد الترانيم لشخصه وسط الكنيسة يوم عيد الفصح العظيم، مما تقشعر الأبدان عند سماعها، ومحاولته أقناع الساقفة والقسوس فى ألقاليم والمدن المجاورة الذين يتملقونه لعلهم يتبعون نفس الخطة فى أختلاطهم بالشعب.
11 - وقد رفض الأعتراف بأن ابن الله نزل من السماء، وهذا ما سنبينه فيما بعد، وليس هذا مجرد كلام، بل قد قامت عليه ألدلة الكثيرة من الكتابات التى أرسلناها إليكم، وألأدهى من هذا قوله أن يسوع المسيح من أسفل (قارن مع يو 3: 31 لبذى يأتى من فوق هو فوق الجميع)، أما من يرنمون له ويمدحونه بين الشعب فيقولون أن معلمهم الفاجر نزل ملاكاً من السماء، وذلك المتغطرس لم يأمر بمنع هذه، بل لا يستنكف حينما تقال بحضوره.
12 - وهنالك النساء اللاتى يسميهن أهل أنطاكية " أمينات الدار " المنتميات له وللقسوس والشمامسة الذين معه، وبالرغمن من أنه يعرف هؤلاء الأشخاص وأثبت عليهم جريمتهم، إلا أنه تستر على هذه هذه الخطية وخطاياهم الأخرى الشنيعة، ولكى يكونوا مدينين له، ولكى ى يجرأوا على أتهامه بسبب أقواله وأفعاله الخبيثة خوفاً على أنفسهم، على أنه قد جعلهم أيضاً أثرياء، لهذا أحبه الطامعون فى هذا الثراء وأعجبوا به.
13 - نحن نعلم أيها الأحباء أن ألسقف وكل الأكليروس يجب ان يكونوا أمثلة للشعب فى كل العمال الصالحة، ونحن لا نجهل كم من أشخاص قد سقطوا، أو تشككوا، بسبب النسوة اللاتى أتوا بهن، لذلك فحتى لو أفترضنا أنه لم يرتكب أى عمل خاطئ إلا أنه كان يجب أن يتجنب التشكك الناشئ من أمر كهذا لئلا يعثر أحد، أو يدفع الآخرين للأقتداء به.
14 - وكيف يستطيع توبيخ أو تحذير أى شخص آخر من الأختلاط الكثير بالنساء لئلا يسقط كما هو مكتوب (حكمة يشوع بن سيراخ ص 25), إن كان هو نفسه قد طرد واحده، ومعه ألآن أثنتان جميلتان متوردتان الوجه، يأخذهما معه أينما ذهب، وفى نفس الوقت يعيش فى البذخ والتنعم!!
15 - وبسبب هذه ألمور يكتئب الجميع وينوحون، ولكنهم إذ يخشون ظلمه وبطشه، ولا يجرؤون على أتهامه.
16 - لكن كما قلنا إذ كان يجوز للمرء أستدعاء الرجل لمحاسبته عن هذه التصرفات لو كانت عقيدته سليمة، ولو كان معدوداً معنا، فإننا لا نراه من الضرورى أن نطلب منه تفسيراً لهذه الأمور طالما كان قد أهان السر، وطالما كان يتمشدق مفاخراً بهرطقة أرتيماس (راجع تاريخ الكنيسة - يوسابيوس القيصرى ك5 ق 28) (لأنه لماذا لا نذكر أباه؟)
17 - وبعد ذلك اضافوا هذه الكلمات فى ختام الرسالة: " لذلك أضطررنا لحرمه طالما كان مقاوماً للرب الإله، ورافضاً الطاعة، وأضطررنا لأقامة أسقف آخر للكنيسة الجامعة بدلاً منه، ونعتقد أننا بإرشاد إلهى قد اقمنا دومنوس المتزين بكل الصفات اللائقة بأسقف، وهو أبن لديمتريانوس المبارك، الذى سبق أن رأس نفس الأيبروشية بكيفية ممتازة، وقد أعلمناكم بهذا لكى تكتبوا إليه وتتقبلوا الرسائل منه، ولكن ليكتب ذلك الرجل إلى أرتيماس، وليكتب إليه المشايعون لأرتيماس.
18 - وحالما سقط بولس من ألسقفية، ومن أفيمان المستقيم، أقيم دومنوس _ كما قيل - أسقفاً لأنطاكية.
19 - ولكن رفض بولس تسليم بناء الكنيسة إلتجئ إلى المبراطور أوريليان، فحسم المر بالعدل، وامر بتسليم البناء لمن يراه أساقفة إيطاليا ومدينة روما، وهكذا طرد هذا الشخص من الكنيسة، بفضيحة شنيعة بأمر السلطات العالمية.
20 - هكذا كانت معاملة أوريليان لنا وقتئذ، ولكنه فى أثناء حكمه غير تفكيره من جهتنا، واوحى أليه بعض المستشارين ليثير علينا أضطهاداً وصارت مباحثة كبيرة عن هذا من كل جانب.
21 - وإذ كان على وشك تنفيذ هذا، وكان على أهبه التوقيع على ألوامر ضدنا، حلت به الدينونة الإلهية، ومنعته من اتمام غرضه وهو على حافة تنفيذه، وبذلك بين الرب بكيفية ظاهرة يراها الجميع بوضوح أن حكام هذا العالم لم يستطيعوا مقاومة كنائس المسيح، إلا أن سمحت بذلك اليد التى تحميها، بتدبير سماوى، من أجل التأديب والتقويم، وفى الأوقات التى تراها مناسبة.
22 - وبعد أن حكم أوريليان ست سنوات (4) خلفه بروبس، وهذا حكم عددا من السنين وخلفه كاروس وأبناه كارينوس ونيوميريانوس، وبعد أن حكموا أقل من 3 سنوات آل الحكم إلى دقليديانوس وشركائه (5)، وفى عصرهم حدث الأضطهاد الذى نعانى مرارته، مع ما تبعه من هدم الكنائس.
23 - وقبل ذلك بوقت قصير مات ديونيسيوس أسقف روما بعد أن ظل فى مركزه 9 سنوات وخلفه فيلكس.
المجمعين الأنطاكييّن الثاني والثالث
تدخل الأساقفة: وهكذا انقسمت أنطاكية واتسع الشق فتدخل أساقفة الكنائس المجاورة، إذ اشتدت المشادة في أنطاكية دعا الينوس أسقف طرسوس أخوته الأساقفة في كنيسة أنطاكية إلى اجتماع في أنطاكية للنظر في قضية أسقفها. فلبى الدعوة كثيرون ومن أشهرهم كما يقول أفسابيوس، فرميليانوس أسقف قيصرية قبدوقية وغريغوريوس العجائبي أسقف قيصرية الجديدة في بلاد البونط -إذ كانت بلاد البونط حتى مجمع نيقية تتبع لأنطاكية- وأخوه اثينودوروس ونيقوماوس اسقف ايقونية وهيميناوس أسقف أورشليم وثيوتيقنوس أسقف قيصرية فلسطين ومكسيموس أسقف بصرى حوران. وأرسلوا دعوة إلى ديونيسيوس أسقف الاسكندرية لما عُرِف عنه من حكمة ودراية ودفاعه. وأراد أن يحضر الاجتماع إلا أنه اعتذر لتقدمه في السن. فأرسل لهم أفسابيوس الشماس الاسكندري لينقل لهم رسالته في مسألة بولس. وهذا الشماس كان معروفاً بتمسكه بالإيمان القويم وتضحيته في سبيل المحافظة على نقاوة الإيمان.
هرطقة بولس: يذكر علماء الكنيسة اهتمام الآباء -خصوصاً- في القرن الثالث بالثالوث الأقدس-له المجد- وسعيهم للتوفيق بين وحدانية الله في التوراة وألوهية المسيح في الإنجيل. واختلافهم في هذا التوفيق. ثم يذكرون فكرة التبني Adoptianism التي قال بها ثيودوتوس وأرطمون وفكرة المونارخية التي نادى بها براكسياس في القرن الثاني ثم سبيليوس في القرن الثالث، ويقرأ -العلماء- في تاريخ افسابيوس أن الأساقفة المجتمعين اتهموا بولس بالأرطمة. وفي أقوال القديسين هيلاريوس وباسيليوس يجدون في موضوع بولس اعتراضاً على لجوئه إلى اللفظ اليوناني Homoousios للتعبير عن علاقة المسيح بالآب. فيقول الدارسين أن بولس زعم أن الله اقنوم واحد وأن الله تبنى المسيح تبني.
المجمع الأنطاكي الثاني: (264)عقد المجمع جلساته كما أسلفنا في أنطاكية. وكثر الجدل فيه. وأخفى البولسيون هرطقتهم. وحاول الأحبار أن يظهروها إلا أنهم لم يفلحو، ورقد بالرب ديونيسيوس الاسكندري، فخسروا الأحبار سنداً لا يوجد فيما بينهم من هو بحزمه وعزمه. وكانت زينب لا تزال في مركزها وفي أوج عزها ومجدها. وأيّد بولس جميع أعداء رومة. واعترف بولس بأنه قال قولاً جديداً وقطع العهود على نفسه بالعودة إلى الإيمان القويم.
المجمع الأنطاكي الثالث: (268) عاد بولس إلى سيرته الأولى، ضارباً عرض الحائط الوعود التي قطعها على نفسه. فكتب إليه الأساقفة رادعين واعظين، لكن دون جدوى. ففكروا بالعودة إلى أنطاكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فدعى الينوس مرة ثالثة إلى اجتماع في أنطاكية في سنة 268 فأمَّ عاصمة الشرق عدد كبير من الأساقفة. لعل عددهم وصل إلى السبع وثمانين وخلا مكان غريغوريوس العجائبي. وتوفيَ فرميليانوس بعده وهو في طريقه إلى أنطاكية. فتبوأ إلينوس المكان الأول بين المجتمعين، وجاء بعده هيمنايوس ومن ثم ثيوتيقنوس وكسيموس ونيقوماس أسقف أيقونية وثيوفيلوس أسقف صور وبروكلوس ونيقوماس واليانوس وبولس وبولاتوس وبروتوجينس وهيراكس وافتيخيوس وثيودوروس وملكيون ولوقيوس. أما أسامي الأساقفة الباقين فهم غير مذكورين في المراجع وخشي الأساقفة ألا يقارعوا بولس في فصاحته ودهاءه. فوكلوا أمر المقارعة إلى ملكيون -كما فعل غيرهم في ظروف مماثلة-. واستقدموا عدداً من الكتّاب لتدوين المناقشة. وناقش ملكيون بولس في العقيدة وأثبت -ملكيون- رأيه فثبت وقوع بولس في الهرطقة أدان المجمع بولس ووصمه بالهرطقة لأنه "امتنع عن القول بأن ابن الله نزل من السماء وتجسد، ولأنه قال بأن يسوع المسيح بشر وإنسان". وأكد المجمع شذوذ بولس في حب المال والجاه والفخفخة. وشجب المجمع أيضاً اقدامه على مساكنة النساء والسماح لبعضعن أن يرتلن في الكنيسة -تقاريظه ومديحه-. وصرَّح المجمع أيضاً أن إصلاح من يشعر بوحدة الكنيسة ويعد نفسه منها ممكن. ولكن ذلك الذي يستهزئ بسر التقوى -1Ti 3: 16 وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ،- ويفخر بهرطقة أرطمون المنتنة لا فائدة من محاسبته وخلع المجمع الأنطاكي الثالث بولس وانتخب دومنوس ابن ديمتريانوس سلف بولس اسقفاً على أنطاكية. وكتب بذلك رسالة إلى أسقف رومة ديونيسيوس ومكسيموس أسقف الاسكندرية وجميع الأخوة الأساقفة والكهنة والشمامسة وإلى كل الكنيسة الجامعة. ليكتب هؤلاء بدورهم إلى دومنوس معترفين برئاسته على كرسي أنطاكية جاء في المراجع المتأخرة أن مكسيموس الاسكندري وخليفة ديونيسيوس الروماني الاسقف فيليكس اتصلا بدومنوس واعترفا برئاسته في سنة 269. التي لم تدم أكثر من ثلاث سنوات وخلفه تيمايوس في السنة الأولى من حكم اوريليانوس 270-271.
امتناع بولس عن الطاعة: ومع ذلك -اعتراف الكنيسة الجامعة برئاسة دومنوس- امتنع بولس عن طاعة المجمع المقدس، وظلَّ يعتبر نفسه رئيساً على كنيسة أنطاكية. وطاوعه في ذلك أتباعه، وأيدته زينب صاحبة السلطة، فظلت أوامره نافذة. وجلَّ ماربحه المؤمنون أنه أصبح لهم أسقفاً سليم العقيدة تقياً يلتفون حوله بإيمان وخشوع، ويمارسون الطقوس كسائر أبناء الكنيسة الجامعة. ولكن السلطات التدمرية لم تعترف بهم. وراحوا يعقدون معظم اجتماعاتهم في السرّ، وفي بعض الكنائس الصغيرة المنسية.
زوال بولس: في سنة 268 سقط غاليانوس ضد أوريولوس، ولكن كان ولاء الجنود ل بكلوديوس الثاني. فقتل غاليانوس وما لبث أن مات بالطاعون فخلفه أوريليانوس في أواخر سنة 270 وأوائل 271 أنفذت زينب زبدة قائد قواتها إلى مصر ليستولي عليه، وكان حاكم مصر الروماني بروبوس قد خرج ليؤدب بعض العصاة في ليبية وقرطاجة وتطهير بحر الأرخبيل من القوط، ففعل زبدة واستولى على مصر وترك فيها حامية وعاد إلى سورية. ولما عاد بروبوس إلى مصر بعد خروج زبدة منه، حارب الحامية التدمرية ومن ناصرها من المصريين، فمات محارباً. وهنا أضحت زينب في حرب ضد رومة وكانت زينب قد أرسلت جيشها عبر طوروس إلى آسية الصغرى واحتلت أنقرة ثم بيثينية. ووصلت طلائع الجيش إلى خلقيدونية. وكان وقتها قد وصل إلى خلقيدونية اعتلاء اوريليانوس العرش الروماني، فصمد الخلقيدونيين في وجه التدمريين وقام اوريليانوس في صيف 271 من إيطاليا إلى البلقان، ثم إلى آسية الصغرى. فتراجع جيش زينب إلى سورية الشمالية، وصمد في أنطاكية. ولما وصل اوريليانوس إلى أنطاكية لجأ إلى حيلة انتصر على اثرها على التدمريين مما جعل زبدة أن يهرب من أنطاكية إلى حمص، حيث كانت زينب، ومعه بعض الأنطاكيين الموالين لزينب بالهروب معه. فلحق به اوريليانوس إلى حمص واصطدم هناك معه وانتصر عليه. فتراجعت زينب إلى تدمر. ولحق بها اوريليانوس وقتل البدو حتى وصل إلى تدمر بعد أسبوع واحد. وشدد الحصار على تدمر. فطلبت زينب من بشابور الساساني معونته، فأنجده، إلا أن اوريليانوس تمكن القضاء على هذه النجدة قبل وصولها إلى تدمر. فتخفت زينب وذهب لتطلب النجدة من الفرات. إلا أن الرومان أدركوها عند نهر الفرات وعادوا بها إلى معسكر اوريليانوس. فدخل تدمر ظافراً. وجر وراءه زينب وابنها ومستشارها لونجينوس. وقد حاكم هذا الأخير في حمص وأمر بقتله وبزوال الحكم التدمري زال نفوذ بولس السميساطي وقويت شوكة تيمايوس وجمهور المؤمنين. فتقدم الاسقف تيمايوس بطلب للأمبراطور أن يخرج بولس من قلاية الأسقفية ويكف يده عنها. فأمر بأن تعطى القلاية إلى أولئك الذين على صلة بالمكاتبة بأساقفة العقيدة المسيحية في ايطاليا ومدينة روما وأما مصير بولس بعد الخلع لا نعلم عنه شيئاً.
زينب التدمرية: بعد أن غلب الأمبراطور فاليريانوس على يد الفرس في سنة 260 وأُسر،وجلس على العرش ابنه غاليانوس. استطاع لاذينة صاحب تدمر أن يثبت مقدرته في الحرب والسياسة، فجعله غاليانوس امبراطوراً على الولايات الشرقية. إلى أن اغتاله أحد أقربائه. فحلَّ محله ابنه وهبة اللات من زوجته زينب. إلا أنه كان صغيراً وقاصر، تولّت الحكم عنه والدته. واتسعت رقعة سلطته، فشملت كل سورية ولبنان ومصر وقسماً من آسية الصغرى. وفي منتصف سنة 271 أعلنت زينب استقلالها عن الإمبراطورية الرومانية. وكان وقتها الامبراطور اوريليانوس، فهب إلى قتالها واسترجاع تدمر تحت العرش الروماني. فدخل تدمر وأسر زينب واقتادها إلى رومة من السنة نفسها. وفي هذا الوقت كان بولس السميساطي أسقفاً على أنطاكية.
بولس السميساطي أسقفاً على أنطاكية: (260-268). أصله من مدينة سميساط. ويفترض به أنه كان يعرف عن اليهود ودينهم والتوراة قبل وصوله إلى الكرسي. وأن زينب اشتهرت بعطفها على اليهود. وساعدته على الوصول للكرسي الرسولي الأنطاكي. لتضمن نوعاً من التعاون بينها وبين مسيحيي عاصمة الشرق. ولما وصل إلى السدة، جعلت منه زينب موظفاً مدنياً عالياً وأسندت له مهام مالية وإشرافية ولقبته ب "ذوقيناريوس". وازدادت سلطته فأصبح ممثل ملوك تدمر في أنطاكية. حتى قال فيه الأساقفة الذين نظروا بأمره فيما بعد-كما سنرى- أنه لم يكن بمقدور أحد أن يجرؤ فيشكو جور هذا الأسقف فتاه بولس بنفسه وتكبر. وصنع لنفسه عرشاً عالياً في الكنيسة وأذن لمريديه بتقريظه. ومنع تسابيح السيد في في الكنيسة. مدعياً أنها -التسابيح- من وضع إنسان متأخر، واستعاض عنه بمزامبر داود وتسابيح خصوصية أُعدّت لتمجيده، تم إنشادها في الكنيسة. وراح ينتقد الآباء الأولين، ولعله خصَّ أوريجانوس أكثر من غيره مما أثار حقد الأساقفة من حوله إذ كان أوريحانوس قد علّم في أنطاكية وكان كثيرين من الأساقفة في عصر بولس تلاميذ عند أوريجانوس العلامة الكبير. ومما أثار انتباه الأساقفة أن بولس نشأ فقيراً واغتنى بطريقة غير شرعية. وخامرهم الشك بإقامته علاقات مع نساء، إذ ساكن النساء واصطحب بعضهن على الرغم من حداثتهن ومظهرهن المغري تمكن بلباقته وخطابه البليغ أن ينشئ حزب حوله. وكان فيه عدد من أساقفة وكهنة وشمامسة الريف. مما أدى إلى شق كنيسة أنطاكية إلى معسكرين أبناء الريف وأمهات المدن وأبناء المدن الكبرى، وبعبارة أدق، إلى وطنيين شرقيين من سريان وعرب وإلى يونانيين ورومانيين ومتهلنين. فكان من الطبيعي أن يرى المعسكر الأول في زينب زعيمة تسعى إلى التحرر من سلطة الرومان وكل ما يمت للغرب بصلة. وصفَّ بعض اليهود والوثنيون إلى جانبهم واظهروا استعطافهم عليهم وناصروا زينب في حركتها (التحررية).
بولس ولونجينوس: أرسلت زينب في طلب لونجينوس الحمصي من أثينا ليأتي إلى تدمر ويتسلم زمام الأمور في الدفاع عن موقفها. بما عُرِف عنه من حجة وفصاحة ورجاحة، فأصغت إلى إرشاداته في السياسة. ومن المحتمل أن يكون بولس قد عرف لونجينوس وتأثر بالفلسفة الأفلاطونية الجديدة. الذين يعطفون على توحيد اليهود وينكرون ألوهية المسيح. من هنا نستطيع أن نفهم ضلالة بولس في قوله أن المسيح "مخلوق" صالح، حمل روح الله في أحشائه. وتمسك بولس بظاهر التوراة ورفض التأويل الاسكندري.
مقاومة أنطاكية بولس: حاول بولس أن يقاوم كل من أيّد رومة والحضارة اليونانية، والذين كانوا كثراً في أنطاكية. وحاولت زينب بدورها عن طريق لونجينوس أن تسميل هؤلاء بفصاحته. إلا أنهم ظلوا يعتبرونها بربرية ومتطفلة على الحضارة. وبالنسبة لليهود لم يُفضل البعض حكم زينب القريب على حكم رومة البعيد. بالرغم من استمالة بولس إلى عدد لا بأس به من الأساقفة إلى صفّه إلا أن كنيسة المسيح في أنطاكية كان ولا يزال فيها أساقفة أبرار حافظوا ويحافظون على تعاليم الرسل ودافعوا عن الإيمان ببسالة. وبهذا المقامة التي كانت ضد بولس كانت في صميمها مقاومة عقائدية، تهدف إلى تطهير كنيسة مدينة الله العظمى من بدعة بولس الفاسدة فتزعم هذه المقاومة الروحية في أنطاكية اثنان من أبناءها وهما دومنوس ابن ديمتريانوس الأسقف السابق وملكيون أحد معلمي الفلسفة والمنطق والفصاحة والبيان في مدارس أنطاكية الهلينية، وأحد أبناء كنيسة أنطاكية الأبرار. وهو الذي -كما حفظ لنا بطرس الشماس- تولى أمر المناقشة الرسمية في المجمع لاحقاً.
المزيد
16 يناير 2025
بدعة بورفيريوس
ولد في البثنية من أعمال حوران وتعلم في صور. ثم درس البيان و الفلسفة على لونجينوس في أثينة. فأعجب لونجينوس بشغفة بالعلم ومواهبه النادرة. وكان يدعى مالكاً فأطلق عليه لونجينوس اسم (الأرجواني) بورفيريوس. ولا نعلم ما إذا كان ولد مسيحياً كما يصرح سقراط المؤرخ. ولكننا نرجح أنه عرف اوريجانس العظيم وعلم أشياء وأشياء عن المسيحية التي كانت قد شاعت آنئذ في طول الساحل اللبناني وعرضه. ويرى بعض العلماء الباحثين أنه بالاضافة إلى لغته الأم تكلم العبرية وعرف جيداً طقوس الكلدانيين والفرس والمصريين ولعله أجاد فهم الأدب اليهودي غير المقدس والفينيقي. ويستبعد أن يكون بورفيريوس قد تذوق رسالة السيد المخلص في هذا الدور من حياته وأن يكون قد قدر عظمة التوراة حتى قدرها. فإنه في السنة 249 عندما بدأ داقيوس اضطهاده الشهير اتخذ موقف المدافع عن الامبراطورية وآلهتها وصنف رسالته في العرافة والعرافين وطرد قوساته Causatha من الحمام لأنه اعتبره شيطاناً رجيماً ولما بلغ بورفيريوس الثلاثين من عمره (263) رحل إلى رومة وأصغى إلى افلوطين فقال بفلسفته وأحب كثيراً أن يُغني ذاته في الوحدة الإلهية ويتحد بالواحد كما تسنى لمعلمه ولأفلاطون من قبله. واشتدت رغبته هذه حتى أنزفت قواه العصبية ففكر بالانتحار. ولكن افلوطين ردعه من ذلك مبيناً سخف هذا العمل وأشار عليه بالتجول. فرحل بورفيريوس في السنة 268 إلى صقلية وأقام في ليليبة. ولم يرَ أستاذه بعد ذلك وكان ما كان من أمر زينب التدمرية وحاجتها لفصاحة لونجينوس. وانقض القوط على ساحل ايجه وجزره. ففر لونجينوس ملبياً دعوة زينب وأقام معها. وعلم لونجينوس بما حل ببورفيريوس فكتب إليه أن يبرح صقلية ويعود إلى بلده الأم (270) ويحمل إليه بعض المصنفات. ولكن بروفيريوس آثر البقاء في صقلية فاستدرك بذلك خطر الموت الذي حل بلونجينوس في حمص السنة (272) على يد اوريليانوس وكان أفلطون المعلم يمقت البيان ويستثقل العناية بالجمل والألفاظ. وأدرك الحاجة إلى إعادة النظر فيما كتب فوكل ذلك إلى تلميذه بورفيريوس. فقبل التلميذ ولكنه لم ينفذ شيئاً منها إلا بعد وفاة معلمه. فدون في صقلية حياة أستاذه وجمع محاضراته في مجلدات ستة عرفت بالأقسام Ennead (التاسوعات) وشرحها. وكتب إليه تلميذه خريساريوس Chrisarios عضو مجلس الشيوخ الروماني أن يعينه على فهم كاتيغوريات Katrgoria (مقولات) ارسطو فصنف له بورفيريوس كتاب الايساغوجي Eisagoge (المدخل) وكسب بهذا السفر شهرة واسعة خالدة.
برفيريوس والمسيحية: وعاد اوريليانوس من الشرق إلى رومة منتصراً وأحب أن يعمم عبادة الشمس فيجعلها دين الامبراطورية الأوحد فأشأ في السنة 274 هيكل الاله الشمس على الكورينال وبدأ يدعو لدين الشمس في أوساط العاصمة وفي الولايات. وعلم بروفيريوس بذلك فهب يهاجم النصارى والنصرانية وصنف رسائله الخمس عشر الشهيرة. وأمر الاباطرة المسيحيون في القرنين الرابع والخامس بمصادرة هذه الرسائل وابطالها فضاع نصها الكامل ولم يبق منها سوى شذرات مبعثرة في متون الردود التي صنفت ضدها. ثم ضاعت هذه الردود بدورها فلم يسلم منها سوى رد مكاريوس ويرى رجال الاختصاص أن هذا الرسائل خالية من أي تفكير فلسفي عميق. وهي في نظرهم أقرب إلى الجدل الفيلولوجي التاريخي منها إلى البحث الفلسفي. فإننا نرى بورفيريوس يسخر من قصة آلام السيد ويتطلب مثل الفريسيين من قبله عجائب عظمى. وهو يهزأ أيضاً من "تناقض" الأناجيل الأربعة ويلجأ في غالب الأحيان إلى اللجاجة والمماحكة مبتعداً عن إتخاذ موقف حاسم واضح.
المزيد
26 ديسمبر 2024
بدعة بلاجيوس
البيلاجية - نسطوريوس والمجمع المسكوني الثالث
البيلاجية هى هرطقة تنادى بأن الإنسان يصل إلى الخلاص بمجهوداته الخاصة بعيداً عن نعمة الله أو أحياناً مع نعمة الله. والاسم نسبة إلى بيلاجيوس اللاهوتى الرومانى الذى علّم فى القرن الرابع والخامس. وقد كانت تعاليمه نسكية، ونادى بأن الإنسان له حرية الاختيار وأكد أتباعه على إنكار تأثير الخطية الأصلية على الإنسان. (The Oxford Dictionary for World Religions)
بدعة بيلاجيوس: نوقشت فى المجمع المسكونى الثالث، مجمع أفسس الأول 431 م
كان راهب قس من بريطانيا وكان ينادى بان " خطية آدم قاصرة عليه دون بقية الجنس البشرى وأن كل إنسان منذ ولادته يكون كآدم قبل سقوطه ثم قال أن الإنسان بقوته الطبيعية يستطيع الوصول إلى اسمى درجات القداسة بدون انتظار إلى مساعد النعمة وبديهى أن التعاليم الفاسدة تهدم سر الفداء المجيد ويضعف من دم السيد المسيح.
(مز 51: 5) " بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت "
(رو 2: 12) " كما فى آدم يموت الجميع هكذا فى المسيح يحيا الجميع "
وبدأ ينشر بدعته بين البلاد حتى حكم عليه مجمع أفسس الأول بحرمه وبدعته وقد جذب بيلاجيوس رجلاً أيرلندياً من الوجهاء (الأغنياء) أسمه كلستينوس وذهب معه إلى أفريقيا ثم تركه فى قرطجنة وتوجه إلى مصر وفلسطين.. وهناك إنضم إلى حزب اوريجانوس ونال إعتبار وشهرة وحدث أن شماس كنيسة ميلانو قدم ضد كلستينوس شكوى إلى الأساقفة الأفريقيين إذ كان فى أفريقيا سبع قضايا، فإجتمع منهم مجمع فى قرطجنة سنة 412 وحرمه، فذهب إلى أفسس وهناك رسم بالغش قساً أما بيلاجيوس فقاومه إيرونيموس الشهير وأورسيوس وإشتكياه إلى اساقفة فلسطين فعقدوا مجمعين أحدهما فى (لد) والثانى فى أورشليم وكان قرار مجمع قرطجنة قد وصل إليهما فقدم إلى كل منهما صورة إعتراف مستقيم ووقع على قرار الحكم ضد زميله فقام أورسيوس تلميذ أوغسطينوس بإبلاغ هذا الحكم لمعلمه وأرسله له لمقاومة صاحب هذه البدعة وإلى أساقفة أفريقيا، فعقدوا مجمعين وأصدروا منهما حكماً ضد بيلاجيوس ورفيقه وأعلنوا هذا الحكم للكنائس الرئيسية ومنها كنيسة أورشليم ورومية وكان يوحنا أسقف أورشليم قد قبل بيلاجيوس فى شركته وأيده أيضاً الذى خلفه برايليوس، أما اسقف روما إينوشنسيوس فقد ايد قرار مجمع أفريقيا ضد بيلاجيوس وكلستينوس، ولكن اسقف روما توفى بعد فترة وخلفه زوسيموس فذهب بيلاجيوس وكلستينوس إلى روما ومعهما توصية أسقف أورشليم وإحتجا إلى البابا وتظلما فإنخدع من ظاهر عباراتهما وقبلهما وكتب رسالة مجمعية يعنف بها مجمع أفريقيا فإنعقد سنة 417 وأقام الحجة ضد البابا وثبت قرارات مجمع 412 م وأظهر للبابا إنخداعه، فلما عرف البابا غلطته وعد أن يفحص المسألة من جديد وبمشورة أوغسطينوس أسقف هبو الشهير عقد مجمع كبير فى السنة التالية مؤلف من 214 أسقفاً فأرسل البابا ثلاثة نواب إلى المجمع وكان منهم قساً قبل ذلك قساً أفريقياً من أبرشية سبيكى وهوإيباريوس قطعه (حرمه) أوريانوس أسقفه لذنوب فظيعة إرتكبها فإستجار القس المحروم بزوسيموس فقبله فى شركته وهو محروم وأرسله مع النواب ليرغموا المجمع على قبوله ويردوه إلى كنيسته، وأرسل بيد النواب لائحة تشمل قرارات بها هذا الطلب فى البند الرابع منها، وكان
الفصل الأول وجوب إستئناف الأحكام ضد الأساقفة إلى البابا حسب أمر مجمع نيقية المسكونى.
الفصل الثانى عدم سفر ألأساقفة إلى باب الحكام إلا بعد ألإتفاق،
الفصل الثالث يجب فحص قضايا القسوس والشمامسة عند الأساقفة المجاورين إذ قطعهم (حرمهم) أساقفتهم عن حمق،
الفصل الرابع يجب قطع الأسقف أوريانوس من الشركة أو إستدعائه إلى روما إذ لم يصلح ما افسده.
فلما إنعقد المجمع أمر أبريليوس رئيسه وأسقف قرطجنة أن تقرأ أعمال مجمع نيقيا، فطلب إليه أولئك النواب لأن يأمر بتلاوة لائحة باباهم فتليت، ولما قرأ الفصل الأول.. قال الساقفة إن نسخ أعمال مجمع نيقية عندنا وليس فيها شئ من إدعاء زوسيموس، ولكى يزيلوا الشك باليقين قرروا إحضار صور أعمال ذلك المجمع من كنائس الشرق الرئيسية فكتبوا إلى كنائس العاصمة (القسطنطينية) والإسكندرية، وانطاكية يطلبون تلك الصور، ثم قرروا تأييد الحكم ضد بيلاجيوس وكلستينوس، وأما بخصوص القس المحروم الذى قبله البابا فنظراً لقانون مجمعهم ألأول المعدل بقانون 134 الذى مضمونه: إن كل إكليريكى يجدد دعواه عبر البحر أى إلى روما لا يقبل فى أفريقيا البتة وأعتبروا أن البابا تداخل بأمره بطريق المحبة، فقبلوا القس المومأ إليه بعد ندامته وتوبته وقبول خدمته فى كنيسة غير كنيسته الأولى وقبل أن تصل صور نسخ أعمال مجمع نيقية توفى اسقف روما زوسيموس وخلفه بونيفاتيوس اسقفاً على روما، وبعد قليل وصلت صورتان أحدهما من البابا السكندرى كيرلس، والثانية من أتيكوس أسقف القسطنطينية، فقراهما المجمع ولم يجد لدعوى زوسيموس الأسقف المتوفى أثراُ وإعتبروه مزوراً ومتلاعباً ثم حدث أن القس إيباريوس الذى كان محروما ونقله المجمع من كنيسته إلى اخرى عاد إلى حالته القديمة فحرمه المجمع، وكان بونيفاتيوس اسقفاً على روما قد توفى وخلفه كلستينوس فإستغاث القس المحروم به فقبله البابا وأرسله بصحبة اسق ليجبر المجمع على قبوله، فأبى المجمع الأفريقى قبوله وصمم على قطعه من الشركة وحرمه، وتمسك المجمع بحقوقه للنهاية، وقد أعتبر المجمع عروض البابا سلباً لحقوقه وحرر له رسالة طويلة شرح له كل ما حدث وتشبث سلفه زوسيموس وقبول المجمع للقس ولكن القس عاد لأخطائه مرة أخرى.
أوغسيطنوس وبيلاجى الهرطوقى
أنكر بيلاجيوس البريطاني وجود علاقة مباشرة بين خطيئة آدم أي عصيان ادم على الله ووقوعه فغي الخطيئة وسائر أفراد الجنس البشري وعلّم أن الإنسان ينال رضى الله بواسطة جهوده الخاصة. ومع أنه لم يبتعد نظرياً عن تعاليم الكنيسة المتعلقة بالمسيح يسوع إلا أنه كان يعمل بصورة قوية على هدم صرح المسيحية مظهراً بأن الإنسان لم يكن بحالة روحية سيئة إلى درجة تستوجب موت المخلص على الصليب. لم يذكر بيلاجيوس ذلك بصورة علنية ولكن تعاليمه كان لا بد لها من أن تؤدي إلى التقليل من أهمية موت المسيح وعمل الروح القدس في قلب الإنسان، ووجوب الولادة الثانية لكي يقدر الإنسان أن ينال سائر فوائد الفداء الذي كسبه لنا المسيح على الصليب كان جواب أوغسطين على تعاليم بيلاجيوس أن الإنسان يرث خطيئة آدم في حياته وان كل إنسان أخطأ في آدم. وهكذا فالإنسان في حالته الحاضرة غير قادر أن يقوم بجميع متطلبات الشريعة الإلهية وهو يبقى إذاً تحت غضب الإله. ليس هناك من واسطة للخلاص إلا بالمسيح يسوع وبما قام به على الصليب مكفراً عن خطايا المؤمنين. ولكن الإنسان لا يود من تلقاء نفسه أن يؤمن، أنه أسير لإرادته المستعبدة للخطية والشر. فالإنسان هو إذاً بحاجة مطلقة إلى معونة الله، إلى معونة فوق طبيعية، وهذا ما نسميه بالنعمة، أي تلك الهبة المجانية التي يعطيها الله للناس ممكنا إياهم من القيام بما يطلبه منهم في الإنجيل. فبدون هذه النعمة الخلاصية لا يقدر أي إنسان أن يستفيد من الخلاص المقدم مجاناً في الإنجيل. وقد أثّرت تعاليم أوغسطين هذه عن الإنسان في تاريخ الكنيسة في العصور المتتالية.
البابا شنودة الثالث يشرح بدعة بلاجيوس
بدعة بيلاجيوس
كلمتكم من قبل عن البدع التى قامت فى العصور الأولى للمسيحية وأريد أن أكلمكم عن البدعة البيلاجية، بيلاجية نسبة إلى بيلاجيوس، وهى يعنى لها موضوعات حساسة فى أيامنا برضه حالياً بينما كان علماء اللاهوت فى القرن الرابع يبحثون فى اللاهوتيات وفى الثالوث القدوس، ولاهوت الابن وتطوروا إلى الكلام عن طبيعة الابن، كلها موضوعات لاهوتية، قامت هذه البدعة للدخول فى موضوع آخر تماماً، طبيعة الإنسان والنفس البشرية وخطية الإنسان ونتائج هذه الخطية وحرية الإرادة والنعمة والعلاقة بين الإرادة والنعمة، كل دى دخلت فيها موضوع غير حكاية الثالوث ولاهوت الابن ولاهوت الروح القدس.. الخ.
بيلاجيوس هذا كان أصله راهب بريطانى من بريطانيا، وكان تقياً ناسكاً، ومشهور بالقداسة والتقوى وبدعوة الناس إلى الروحانيات، حاجة عجيبة صحيح، يعنى كتير نلاقى رهبان ونساك يخشوا فى اللاهوتيات يطبوا ويبقوا مبتدعين زى بيلاجيوس هذا وأوطاخى، ما هو كان راهب وناسك ورئيس رهبنة فى القسطنطينية وانتهى إلى البدعة، وأيضاً فيما بعد هنسمع عن جون كاسيان، إنه اتهموه إنه نصف بيلاجى، وكان راهب وناسك وحياته فى الأديرة وكان معاه واحد تانى اسمه فوستوس، وكان زعيم رهبانى، يا ريت الرهبان يخشوا فى الروحيات ويسكتوا، ويبعدوا عن الأمور اللاهوتية اللى بتتعبهم، إلا من كان فيهم قديراً على التحدث فى اللاهوتيات بيلاجيوس كان راهب بريطانى محب للتقوى ويدعو الناس للحياة المقدسة، فكان يتعبه كثيراً إن البعض يقول أنا مش قادر، أنا ضعيف، أنا مجرد بشر، أنا لا أستطيع، الخطية شديدة والتقوى صعبة، فلذلك هو تضايق من الناس اللى بيتكلموا عن ضعف الطبيعة البشرية، وبدأ يتكلم عن قوة الطبيعة البشرية وقدرتها لدرجة إنه تطرف، قال الطبيعة البشرية قوية وقادرة على إن الإنسان يحيا حياته كلها بدون خطية!، وإن فى العهد القديم قبل ما ييجى المسيح كان فيه قديسين بلا خطية، وقال ونحن لسنا فى حاجة إلى معونة إلهية من الخارج لتقويتنا حتى نعيش بلا خطية، وهكذا أنكر مفعول النعمة. وقال إن النعمة الحقيقية التى ممكن تعطى للإنسان إن ربنا خلقنا بهذه الطبيعة، يعنى النعمة الأصلية إن ربنا خلقنا على هذه الطبيعة التى يمكن أنها لا تخطئ ونعمة تانية اللى هى مغفرة الخطايا ولذلك اصطدم باثنين من القديسين وقفوا ضده، وهما القديس أغسطينوس الذى كان أسقفاً لمدينة هيبو فى إيبارشية قرطاجنة، يعنى إن قلنا إن مصر كانت هى أكبر الكانائس الأفريقية فى شمال أفريقيا من ناحية الشرق نقول من ناحية الغرب كانت قرطاجنة، والقديس جيروم أيضاً، القديس جيروم كان عنده رهبانات فى أورشليم، الراجل ده كان بيلاجيوس هرب إلى فلسطين، ففى شمال أفريقيا لقى أغسطينوس ولما راح فلسطين لقى جيروم وهما الاتين كانا فى خط واحد، فى كلام بيلاجيوس عن قوة الطبيعة البشرية وحرية الإرادة الضخمة التى تستطيع أن تختار الخير من غير النعمة أنكر الخطية الأصلية التى ولد الإنسان، وإزاى هيتولد إنسان بالخطية؟ ما يبقى ضعيف، فأنكر الخطية الأصلية وقال إن خطية آدم أضرت آدم وحده ولم تضر أحداً من نسله أو من أولاده، دى نقطة تانية، وما دام أنكر الخطية الأصلية، يبقى أنكر فائدة المعمودية، شوفوا الخطية دية سلسلة، خطية تقود لخطية.. الخ لغاية لما يقع الإنسان فى مجموعة من البدع، ولما أنكر المعمودية أنكر أيضاً حاجة الأطفال للمعمودية بالتالى، وبعدين قال إن الأطفال حتى غير المعمدين هيروحوا الملكوت، يبقى ما تفتكرش إن مسألة كلامه عن حرية الإرادة وقوة الطبيعة البشرية وقفت عند هذا الحد، دى دخلت فى سلاسل، وبعدين قال هو المشكلة إن الإنسان ربنا خلقه بطبيعة قوية وبإمكانيات لكن هو ساعات ما يستخدمهاش وقال إن أحنا لو أنكرنا هذا الأمر، يبقى هنتهم ربنا بجهل مزدوج، أنا آسف أقول التعبير ده، ده تعبير بيلاجيوس، قال يبقى اتهمنا ربنا بجهله بطبيعة ما قد خلق، وإيه تانى؟ وجهله بالوصية اللى هو اداها للناس هى أدهم ولا لأ، ده على رأى الشاعر اللى قال على الإنسان اللى مش قادر ومصير، قال: ألقاه فى يم يعنى بحر، مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ده ربنا يعنى، ولا مؤاخذه، مش هقعد كل كلمة أقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، ولا استغفر الله ده مش أسلوبنا، فبيلاجيوس قال الطبيعة البشرية طاهرة وتقدر تمر صح فى كل حاجة، وتستطيع أن تصل إلى الكمال أيضاً وبدون النعمة، قال كون إن المسيح يقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل ما دام أمرنا بالكمال يبقى ممكن، إذاً طبيعتنا البشرية ممكن تصل إلى الكمال، إحنا ما بنقولش لأ، لكن تصل للكمال بالنعمة، لكن هو ما بيجبش سيرة النعمة، وكون إن يكون حتى فى العهد القديم، ربنا قال لإبراهيم أب الآباء فى دعوته له فى تكوين 12، سر أمامى وكن كاملاً، مش ممكن يقوله كن كاملاً، إلا لو كان الكمال سهل وممكن، إحنا ما بنقولش مش ممكن يعنى عن طريق النعمة، ولذلك لما قرأ عليه جزء من اعترافات أغسطينوس التى قال فيها للرب، أعطى ما تأمر به، يعنى إدى النعمة اللى تخللى الواحد ينفذ ما تأمر به، أعطى ما تأمر به وأمر بما تشاء، يعنى أمر زى ما أنت عايز، بس على شرط إنك تعطى ما تأمر به، فقال سواء الإنسان أراد أو لم يرد عنده القدرة إنه يعمل الخير وبدون النعمة وأنه يحيا بدون خطية ويصل إلى الكمال، من أجل هذا وجدنا إن القديس أغسطينوس أخذ جهداً كبيراً فى الرد على البيلاجييين، لدرجة فى مجموعة أباء نيقية وما بعد نيقية نلاقى فيه مجلد كبير للقديس أغسطينوس اسمه ضد البيلاجية من ضمن هذه الكتب اللى فى المجلد كتاب عن مغفرة الخطايا ومعمودية الأطفال والروح والحرف وطبيعة النعمة، ونعمة المسيح والخطية الأصلية وأصل النفس، وأيضاً أربع كتب ضد رسائل بيلاجيوس والنعمة وحرية الإرداة كل هذه المؤلفات من سنة 412 لسنة 426 يعنى حوالى 14 سنة كتب عن بيلاجيوس، اللى فيكم يحب يقرأ عن النعمة يقرأ كلام أغسطينوس أتكلم كلام كتير قوى، طبعاً أغسطينوس اتكلم عن أهيمة النعمة بشدة عشان يرد على البيلاجيين، لكن يطلع بعد كده الطوائف تقول النعمة كل حاجة ومفيش أعمال ولا إرادة يبقى تطرف من ناحية أخرى، مش يستغلوا الكلام اللى قاله أغسطينوس ضد البيلاجية ياخدوه بصفة عامة، لأ، أغسطينوس قال يعنى على الرغم من كلام البيلاجيين، لم يوجد إنسان واحد وصل إلى كمال البر، فلابد من حاجة إلى معونة، البيلاجيين يقولوا لو اتكلمنا عن النعمة يبقى الكلام عن معونة خارجية وليس عن معونة داخلية، داخلية الإنسان قادر، لكن من بره يجيب نعمة ما لهاش دعوة بطبيعة الإنسان وأنكروا الخطية الأصلية وقالوا ليس شئ ولدوا معنا، إحنا ولدنا ونحن قادرون.
نيجى بقى لتاريخ هذه البدعة، كما ترون راجعة إلى أوائل القرن الخامس سنة 410 – 411 لغاية 426، إن بيلاجيوس وهو راهب بريطانى وكان عايش فى رومية وكان عايش هادى وأفكاره بيقولها بالوعظ ثم كتب كتاباً عن تفسير رسالة بولس ظهرت فيه أفكار، لكن مع ذلك الذى نشر أفكاره صديق له اسمه كلوستيوس وكان رجل محامى، بدأ ينشر تعاليمه، فالمسألة بدأت تنتشر وسط العامة، من معلم وسط تلاميذه كبلاجيوس إلى كلامه وسط الناس وصل الحديث أيضاً إلى أغسطينوس الحكاية كبرت بقت مسألة عامة، فأخيراً هرب الصديقان إلى شمال أفريقيا، وبعد شوية بيلاجيوس ذهب إلى فلسطين وترك كلوستيوس فى شمال أفريقيا، وكلوستيوس كان عايز يبقى قسيس، لكن ما كنش متأسس كويس، إزاى؟ طلع له واحد شماس اسمه باولينوس اتهمه بالهرطقة واتكلم عن 7 نقط ضده فى الهرطقة، فكات النتيجة إن اجتمع مجمع فى قرطاجنة سنة 412 لمحاكمة كلوستيوس، اللى هو تلميذ وصديق بيلاجيوس، المجمع ده كان برئاسة القديس أوريليوس، وده اسم مشهور لأنه كان رئيس الإيبارشية اللى فيها أغسطينوس ماسك مدينة صغيرة فيها اسمها هيبو، كان أسقف قرطاجنة، فالمجمع ده أوقف كلوستيوس، لم ينكر شيئاً من الاتهامات التى وجهت إليه، بس قال عن بعضها دى أمور موضع دراسة بين الناس ولا تصل إلى حدود الإيمان المعترف به، والكلام ده ما دخلش فى أذهان المجمع فحكموا عليه بحرمانه، هو أول ما لاقى أول ما لاقى حكم بالحرمان رجع لبلده واستطاع أن يقنعهم إنه يبقى قسيس، فرسموه قساً فى أفسس، دى تورينا مشكلة فى تاريخ الكنيسة، إن أحياناً إنسان ما ينفعش فى إبروشيته فيروح إبروشية تانية تحالله أو ترسمه، زى أوريجانوس، ما نفعش فى الإسكندرية فراح لقيصرية الجديدة فرسموه قساً هناك يعنى الحكاية بتمشى بنوع مش تمام، إحنا مش هانعاتب بتوع أفسس دلوقتى، خلينا فى حكاية الهرطقة بتاع كلوستوس، فبيلاجيوس كان فى فلسطين وهو موجود هناك وعايش بعيد هناك فى صيف 415 جه قسيس أسبانى اسمه باولوس بيحمل رسائل من أوغسطين إلى جيروم، جيروم كان موجود فى فلسطين، طبعاً الجوابات ده أمور لاهوتية، فالقسيس الأسبانى لما وصل إلى فلسطين سألوه فحكى لهم مسألة حرم كلوستيوس فى مجمع فى قرطاجنة، وإنه واخد التعليم من بيلاجيوس، واتقلبت الدنيا، فجابوا بيلاجيوس يحاكموا، عملوا مجمع برئاسة يوحنا الأورشليمى، واستعدى بيلاجيوس عشان يقدم إيمانه وكان الرجل الأسبانى عايز واحد يترجم له، المهم إن هذا المجمع ما استطعش ياخد لا حق ولا باطل من بيلاجيوس، وبيلاجيوس أنكر ما قيل فيه، اجتمع مجمع تانى فى مدينة اللدة، واستدعة بيلاجيوس، فأنكر أيضاً الاتهامات اللى وصلت ضده، وعلى رأى أغسطين قال المجمع حكم ضد الهرطقة مش ضد الهرطوقى، يعنى الهرطقة معترفين إن الكلام ده هرطقة، لكن ماقدروش يمسكوا بيلاجيوس وبيلاجيوس أدان الأفكار التى كان يقول بها وانتهى الأمر إلى أنهم تركوه بدون حكم، الحكاية دى غلط، هذا الخبر وصل إلى شمال أفريقيا، اللى هم حكموا قبل كده على كلوستيوس، فاجتمع مجمعان، مجمع حضره 69 أسقف سنة 416 ومجمع آخر من 60 أسقف فى مدينة ميلا، وهم الاتنين المجامع دول حكم ضد بيلاجيوس بالهرطقة، وضد كلوستيوس بالهرطقة، لعل بعضكم يقول، طب ما حكموا عليهم يبقى انتهى الموضوع، هو حكم مجمع لكن لسه، وصلت الحكاية إلى روما، فالمجمع التانى قال ده راجل كان عايش طول عمره فى روما نحوله على أسقف روما، كان أسقف روما ساعتها اسمه انوسنت الأول، وأساقفة أفريقيا بعتوا له تقرير عن موضوعه، فوجد إن بيلاجيوس إنسان هرطوقى، وكلوستيوس إنسان هرطوقى، فأيد كلام مجامع أفريقيا المكانية وحكم بهرطقة بيلاجيوس وكلوستيوس، المشكلة إن بعد أسابيع من هذا الحكم مات إنوسنت وجه واحد اسمه زوسيموس، زوسيموس ده يظهر ماكنش دقيق فى اللاهوتيات جرى له بيلاجيوس، وجرى له كلوسيوس، فحكم إن بيلاجيوس وكلوسيوس إيمانهم سليم وأرسل رسالة إلى أساقفة افريقيا شديدة اللهجة جداً، ويصفهم بالتسرع فى الحكم وطلب إعادة النظر فى الموضوع، دول أفريقيين بتوع زربنة!
وإذا بأساقفة أفريقيا هاجوا وعقدوا مجمعاً من أكثر من 200 أسقف وبعثوا برسالة إلى زوسيموس وقالوا له إنت غلطان، والراجل ده ضد النعمة والراجل ده ضد المعمودية، وأرسلوا له الرسالة، وعشان يضمنوا خط الرجعة اتصلوا بالأمبراطور وقالوا ده قرار المجمع و200 أسقف حكموا بهرطقة بيلاجيوس وكلوستيوس، والأمبراطور حكم بنفى بيلاجيوس ونفى كلوستيوس، ونفى كل من ينضم إليهم فى الرأى وأسقف روما وجد نفسه فى حيص وبيص، ماذا يعمل؟
فعلشان يخفى خجله، قالهم أنا أجبهم مرة أخرى عشان إعادة حكمهم، فاستدعاهم محدش جه عشان منفيين، وأخيراً خضع لقرار الإمبراطور وحكم بحرمهم والبدع بتاعتهم وأقر أيضاً إن لزوم المعمودية ووراثة خطية آدم والأمور التى أنكرها هؤلاء ووقع معه جميع اساقفة كرسيه ما عدا 18 فأمروا بنفى ال18، بعضهم رجع والبعض انتهى وظن البعض أن هرطقة بيلاجيوس انتهت، لكن قامت مجموعة فيما بعد حاولوا أن يجدوا حلاً متوسطاً ما بين أغسطين وبيلاجيوس، دول اللى سموهم أشباه البيلاجيين، للأسف منهم جون كاسيان، وده كان تلميذ لذهبى الفم.
المزيد
19 ديسمبر 2024
بدعة بطرس القصار
تعود إلى النزاع الخريستولوجي
إضافة بطرس القصار: فنقرّر من ثم بأن إضافة التي ألحقها بطرس القصار بالنشيد التقديس كفرٌ، لأنها تأتينا بأقنوم رابع، فتضع ابن الله وقوة الآب الأقنومية من جهة، والمصلوب من جهة أخرى على أنه غير القويّ. أو هي تُمجد الثالوث الأقدس المتألم، صالبة الآب والروح القدس مع الابن. فبعداً لهذا الكفر وهذا الهذيان!
الأسماء الإلهية العامة: أمّا نحن فننسب لفظة قدوس الله إلى الآب، غير فارزين اسم اللاهوت له وحده، بل مدركين أن الابن إله والروح القدس كذلك. ولفظة قدوس القوي نجعلها للابن، غير نازعين القوة عن الآب والروح القدس. ولفظة قدوس الذي لا يموت نخصصها للروح القدس، غير تاركين الآب والابن بمعزل عن الخلود، بل ناسبين إلى كل من الأقانيم كل الأسماء الإلهية نسبة بسيطة وعامة، مقتدين بالرسول الإلهي القائل: "لنا إله واحد الآب الذي منه كل شيء ونحن إليه، وربّ واحد يسوع المسيح الذي به كلّ شيء ونحن به" (1كور8: 6). ومتشبهين بغريغوريوس اللاهوتي الذي هو ليس بأقل من الرسول في تعبيره حيث يقول: "ولنا ربّ واحدٌ الآب الذي منه كل شي وربُ واحد يسوع المسيح الذي به كل شيء وروح قدوس واحد فيه كل شيء". فلفظة منه وبه وفيه ليس من شأنها أن تفصل الطبائع -لأن على حروف الجرّ هذه أن لا تتبدلّ أو على الكلمات أن لا يتغيّر ترتيبها- بل هي لتمييز خصائص الطبيعة الواحدة بدون تشويش. وهذا واضح من أن الحروف هذه تعود فترجع إلى واحدٍ لدى قراءة ذلك بتأنٍّ في الرسول نفسه القائل: "كل شيء منه وبه وإليه فله المجد مدى الدهور. آمين" (رومة11: 36).
النشيد المثلث التقديس موجّه إلى الثالوث الأقدس لا إلى الابن وحده: يشهد الأحبار الإلهيون أثناثيوس وباسيليوس وغريغوريوس وكل خورس الآباء اللابسيّ الله أن النشيد المثلّث التقديس لا يُقال في الابن فحسب، بل في الثالوث الأقدس. فإن السارفيم القديسين في تقديسهم المثلّث يُظهرون لنا الأقانيم الثلاثة للاهوت الفائق الجوهر، ويعرفوننا بوحدة السيادة ووحدة المُلك لرئاسة الثالوث الإلهي. وعليه يقول غريغوريوس اللاهوتي: "وهكذا إذاً، فإن أقدس الأقداس التي هي محجوبة عن السارافيم أيضاً وتتلقّى التمجيد بتقديسات مثلّثة تجتمع في سيادة واحدة ولاهوت واحد. وهذا ما قد استنتجه أيضاً من كانوا قبلنا من السلف الصالح وذلك بأقوال أكثر جمالاً وأعلى سموّاً".
تقليد الكنيسة عن هذا النشيد، في عهد بروكلُس الحبر: وعليه، فقد أجمع المؤرخون الكنسيّون على القول بأنّ الشعب القسطنطيني، في عهد رئيس الأساقفة بروكلس، فيما كان يقوم بابتهال لإبعاد محنة إلهية، وإذا بطفلٍ من الشعب قد اختطف بالروح وتلقن -بتعليم ملائكي- النشيد المثلث التقديس على النحو التالي: "قدوس الله. قدوس القوي. قدوس الذي لا يموت. ارحمنا". ولمّا عاد الصبيّ إلى وعيه، أخبر بما تعلّم. فأخذ الجمهور كلّه يترنّم بالنشيد فتوقفت المحنة للحال. وفي المجمع المقدس العظيم المسكوني الرابع، أعني الخلقيدوني، قد تمّ تسليمّ النشيد المثلث التقديس كما هو للترنيم، وعلى هذا النحو قد صار تدوينه في أعمال المجمع المقدس المذكور. إنها إذاً لسخرية مضحكة حقاً أنَّ النشيد المثلث التقديس الذي أشار به الملائكة وتحقق بوحي من إرشادهم وتثبت رسمياً في مجمع آباء جزيل عددهم وكان قبلاً قد ترنّم به السارافيم، على أنه يوضح أقانيم اللاهوت الثلاثة، ينتهي به الأمر أن يوطأ بتفكير سخيف من القصار، ومن ثم يكون عرضة لإصلاحه من مغالاة السارافيم! فيا للاعتداد بالذات، حتى لا أقول: يا للغباوة! - أما نحن فإننا نتابع الهتاف هكذا، ولو خزي الشياطين، ونقول: "قدوس الله. قدوس القوي. قدوس الذي لا يموت. ارحمنا".
المزيد
12 ديسمبر 2024
بدعة برديصان
اشتهر في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث غنوسي آخر وهو برديصان الرهاوي. وبرديصان Bardesenes مشتقة من "بار" السريانية ومعناها ابن ومن ديصان وهو نهر فوق الرها. ولد برديصان على هذا النهر فسمي به. ثم نشأ في الرها في قصر أبجر التاسع واهتدى إلى المسيحية فانبرى ينتصر لها. ثم زاغ عندما تقبل الغنوسية على مذهب فالنتينوس، وانتمى إلى فرع هذه البدعة الشرقي فزامل أكسيونيكوس واشتغل بالتنجيم وأجاد السريانية ونظم الأناشيد وأحسن التلحين فافتتن بأناشيده شبان الرها وفتياتها ونقلوا أضاليله بها. وجاء في تاريخ افسابيوس أن برديصان كتب مقالات كثيرة في الفلك والقدر وغير ذلك، وأن بعضها نقل إلى اليونانية. وليس لدينا اليوم من مصنفاته هذه سوى كتابه في شرائع البلدان الذي أملاه على تلميذه فيليبوس. ويرجح العلامة الأستاذ بيفان أن برديصان هو صاحب "أنشودة النفس" ولكن أحداً من زملائه لا يشاركه هذا الرأي وحكى مار أفرام الملفان أنه قال بسبعة كائنات. ونقل ما ميخائيل الكبير وابن العبري أنه قال بثلاث طبائه كبار وأربعة كائنات صارت 366 عالماً وكائناً وأن الله لم يكلم موسى والأنبياء وإنما هو رئيس الملائكة وأن "السيدة مريم العذراء" لم تلد جسداً قابلاً للموت لكن نفساً نيرة اتخذت شكلاً جسدياً. وكذّب بالقيامة وخلط في أمر تكوين العالم.
المزيد
08 ديسمبر 2024
تذكار الاعياد الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة
يحتفل في كل يوم 29 من كل شهر قبطي ماعدا شهري طوبه وأمشير بتذكار الأعياد السيدية الثلاثة الكبرى، بالطقس الفرايحي الذي يمتاز بالنغم المطرب الذي يليق بالأعياد والأفراح الروحية ولا يكون فيه صوم انقطاعي ولا ميطانيات metanoia. وهى كالآتي:
عيد البشارة الذي يقع في 29 برمهات.
عيد الميلاد الذي يقع في 29 كيهك.
عيد القيامة الذي كان في سنة صلب السيد المسيح وقيامته في 29 برمهات أيضًا.
الطقس:
تسبحة عشية:
تصلى تسبحة عشية كالمعتاد مع إضافة إبصالية واطس أو آدام الخاصة بالعيد، كما تقال الإبصالية باللحن الفرايحي ثم يقال الطرح الخاص بالبشارة قبل ختام التذاكيات.
في رفع بخور عشية وباكر:
تقال أرباع الناقوس الخاصة بالبشارة والميلاد والقيامة كذلك الذكصولوجيات ومرد الإنجيل والختام.
تسبحة نصف الليل:
تصلي التسبحة كالمعتاد على أن تقال “تين أويه إنثوك”، كما يقال المجمع بطقس الأعياد السيدية وتقال الذكصولوجيات والإبصاليات والدفنار ثم ختام التذاكيات فختام التسبحة.
في القداس:
تصلى مزامير الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل وتقال الليلويا فاي بيه بي ولحن طاي شورى وتقال الهيتنيات علي النحو التالي: الأولي للقديسة العذراء مريم والثانية للقيامة والثالثة للملاك غبريال (البشارة) والرابعة للسبعة رؤساء الملائكة والخامسة للميلاد والسادسة ليوسف ونيقوديموس والقديسة مريم المجدلية والسابعة للرسل القديسين والثامنة لمار مرقس الرسول والتاسعة لمار جرجس ثم تكمل كالمعتاد ومرد الأبركسيس``Pra[ic الخاص بالبشارة والميلاد والقيامة كذلك مرد الإنجيل والأسبسمس الآدام أو الواطس ويكون التوزيع جامعًا للأعياد الثلاثة بحيث يقال ربع لكل عيد بعد كل ربع من مزمور التوزيع والختام أيضًا يكون جامعًا للأعياد الثلاثة.
لا يحتفل بيوم 29 تذكار الأعياد السيدية الثلاثة في شهري طوبه وأمشير لأنهما يقعان خارج فترة حمل القديسة العذراء بالسيد المسيح، كما أنهما يرمزان لنبوات الناموس والأنبياء التي سبقت مجيء السيد المسيح.
تذكار الأعياد السيدية الكبرى الثلاثة (البشارة والميلاد والقيامة) تتم الصلاة بالطقس الفرايحي وتظل قراءات اليوم كما هي إلا إذا وقع يوم أحد فتقرأ فصول 29 برمهات بدل فصول الأحد الخامس لأنها متكررة.
إذا وقع عيد البشارة (29 برمهات) في المدة من جمعة ختام الصوم إلي اثنين شم النسيم swm `nnicim لا يحتفل به لأن هذه المدة تحمل أحداثًا سيدية هامة غير متكررة.إذا وقع عيد سيدي كبير أو صغير يوم أحد تقرأ فصول العيد بدل فصول الأحد لا تقال الألحان الحزايني وإذا كان هناك ترحيم على الأموات فيكون دمجا وليس باللحن الحزايني. وكذلك في أيام الآحاد والأعياد السيدية.
المزيد
05 ديسمبر 2024
مشكلة أوريجانوس
قضية الخلاف بين البابا ديمتريوس ال 12 وأوريجانوس
لا يسع القبطى إلا أن يفخر بالعلامة أوريجانوس فلم ترى مصر والكنيسة القبطية رجلاً أنجز الكثير من خدماته وأعماله التى أرتكزت على موهبتة الفائقة فى التفكير والتأمل وكذلك عقليته الفذه هذه كلمة حق نقولها تقديراً لهذا الرجل العلامة العظيم بالرغم من حرمانه على يد الأنبا ديمتريوس البطريرك ال 12 فى تعداد البطاركة وقد أوردنا هذه المقدمة إنصافاً للحق ونحن إنما نتخذ الحياد وسنسرد جميع وجهات النظر المختلفة فى هذا الموضوع الذى كان وما زال حتى الآن مثار جدل كبير.
نبدأ بالأحداث التى أدت إلى إلإتهامات التى وجهت إلى العلامة أوريجانوس كما يلى:
أرسل البابا الأنبا ديمتريوس أوريجانوس فى رحلة إلى اليونان حيث ذهب إلى آخائية ليعمل صلحاً، وكان يحمل تفويضاً كتابياً من أسقفه وفى طريقة عبر فلسطين، وفى قيصرية سيم قساً بواسطة أسقفها، حيث رأى للأساقفة أنه لا يليق بمرشد روحى مثل أورجانوس بلغ أعلى المستويات العلمية وتخرج من تحت يده كهنة وأساقفة ورهبان أن يظل بدون درجة كهنوتية، كما أن البابا ديمتريوس أعترض على أنه علمانى ويعظ فى الكنيسة فى حضرتهم حيث أنهم أساقفة، ولكن أعتبر البابا ديمتريوس أن هذه السيامة أكثر خطأ من وعظه علمانيا فى حضورهم، وقد أعتبرها سيامة باطلة لسببين:
ا - أن أوريجانوس قبل السيامة من أسقف غير أسقفه وبدون أذنه.
ب - أن أوريجانوس خصى نفسه، الأمر الذى يحرمه من نوال درجة كهنوتية!!
كيف أدين أوريجانوس؟
دعا البابا ديمتريوس مجمعاً من الأساقفة والكهنة فى الأسكندرية وكانت قراراته هو رفض المجمع القرار السابق وأكتفى بإبعاد أوريجانوس عن الأسكندرية .
عودة أوريجانوس من مهمته إلى مصر
وعاد أوريجانوس من مهمته التى أرسله فيها البابا ديمتريوس إلى الإسكندرية ليفاجأ بقرار المجمع بإبعاده عن الأسكندرية وأعتقد أنه له فيها كهنوت ويفعل ما أراده فلم يقبله القديس ديمتريوس وقال له: " يوجب قانون الآباء الرسل.. أن لا يفارق كاهن المذبح الذى قسم عليه، فإمضى إلى الموضع الذى قسمت فيه قساً فإخدم فيه هناك بإتضاع كالقانون، وأنا فلن أحل قانون البيعة (الكنيسة) لأجل مجد الناس " فظل مطروداً، فلم يقبله البابا ديمتريوس، ونفاة، فذهب أوريجانوس إلى بلدة تمى من كوستانكية، وبقول ويذكر الأنبا ساويرس (ابن المقفع) تاريخ البطاركة: سيره الأباءالبطاركه – ساويرس إبن المقفع أسقف الأشمونين أعده الأنبا صمؤيل أسقف شبين القناطر وتوابعها طباعة النعام للطباعة والتوريدات رقم اإيداع 17461/ لسنة 1999 الجزء الأول ص 18: " وخدع أسقفها وأسمه أمونة فجعل أوريجانوس يخدم فى أحدى البيع (الكنائس)، فلما وصل الخبر إلى الأنبا ديمتريوس ذهب بنفسه إلى تمى عن قصد ونفى أوريجانوس وقطع (حرم) الأسقف أمونة لأنه قبل أوريجانوس وشفق عليه فى أسقفيته مع أنه عارف بأعماله وكذبه، ورسم الأنبا ديمتريوس أسقفاً غيره أسمه فلا أس، وكان فلا أس رجلاً خائف من الرب وكان إيمانه كبير.. فقال: لن أجلس على الكرسى وأمونة على قيد الحياة " وظل كذلك حتى مات أمونة ثم جلس السقف فلا أس، ثم أستشهد بعد ذلك بزمان ومضى إلى الرب بسلام
البابا ديمتريوس يصر على عقد مجمع آخر
ولكن قرارات المجمع المحلى السابق لم ترضى البابا ديمتريوس فدعا لعقد مجمعاً آخر من الأساقفة فى سنة 232 م كان قرارة كالآتى
بطلان كهنوتة وأعتبارة لا يصلح للتعليم.
ويقول ابونا القمص تادرس يعقوب الملطى أن أوريجانوس: حرم أيضاً لأخطاء وردت فى كتاباته (ملاحظة من الموقع: لم يذكر أبونا تادرس هل الفقرات التالية وردت فى نص الحرم فى المجمع المنعقد أم لا - حيث أنه من المعروف أن الكتب فى ذلك كانت تنسخ باليد وكان يمكن أضافة مقاطع إلى كتب المؤلفين إذا أراد أحدا أن يفعل ذلك وليست مثل الكتب التى تطبع هذه الأيام حيث يذكر أبونا تادرس يعقوب الملطى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة علم ولاهوت - القمص تادرس يعقوب ملطى - طبعة تحضيرية 1986 م ص 36: " والآن أود أن أقدم فكرة مختصرة عن أخطائة التعليمية، وإن كان قد أعلن هو (أوريجانوس) بأنها قد أدخلت فى كتاباته بغرض تشوية صورتة) - وعموماً هذه مجرد تساؤلات فقط ونسرد الأخطاء التى ذكرها:
1 - آمن بأن النفوس خلقت قبل الأجساد، وأنها أرتبطت بالأجساد كتأديب عن خطايا سابقة أرتكبتها وأن عالم الحس بالنسبة لها ليس إلا مكاناً للتطهير .
2 - نفس المسيح لها وجود سابق قبل التجسد. أتحدت باللاهوت.
3 - ستعود كل الخليقة إلى أصلها فى الرب، ويخلص كل البشر (وأن العقوبة الأبدية لها نهاية)
4 - سيخلص الشيطان وكل الأرواح الشريرة، وإذ وجه إلي اوريجانوس اللوم على ذلك أعترض قائلاً: " أنها مجرد فكرة قد بلغت نظرية
أنتشر القرار فى مصر كقرار من مجمع محلى ولكن لشهرة العلامة أوريجانوس العالمية أنتشر فى الغرب وقد علق المؤرخ أوسابيوس القيصرى قائلاً: " عندئذ إزدادت شهرته جداً، وأصبح أسمه معروفاً فى كل مكان، ونال صيتاً عظيماً بسبب فضائلة وحكمتة، وأما ديمتريوس فإذ لم يكن لديه ما يقوله ضده سوى ذلك العمل الصبيانى، أتهمه بمرارة، وتجاسر على أن يتهمه ويشرك معه فى هذه الإتهامات أولئك الأساقفة الذين نصبوه قساً " ولكن تجاهلت الكنائس الشرقية قرار المجمع المصرى ومنها كنائس فلسطين والعربية وفينيقية وآخائية حيث كان أوريجانوس شخصية معروفة لأساقفتها.
الأسباب التى أوردها الأنبا ساويرس فى تاريخ البطاركة
الأنبا ساويرس (ابن المقفع) تاريخ البطاركة: سيره الأباءالبطاركه – ساويرس إبن المقفع أسقف الأشمونين أعده الأنبا صمؤيل أسقف شبين القناطر وتوابعها طباعة النعام للطباعة والتوريدات رقم اإيداع 17461/ لسنة 1999 الجزء الأول ص 14- 15 يصف إدانه أوريجانوس فيقول: أوريجانوس الذى قطعه الأنبا ديمتريوس بسبب فعلة ما لا يجوز من كتب السحر ورفضه كتب القديسين، وأنه وضع كتب كثيرة عن نفسه فيها تجديف كثير منه:
الأب خلق الإبن، وأن الأبن خلق الروح القدس.. ولم يقل أن ألاب والأبن والروح القدس إله واحد، وأن الثالوث لا يعجزة شئ بل قوته واحدة وربوبيته واحدة ولأجل سوء أعتقادة رفضته الكنيسة إذ كان غريباً منها وليس هو من أولادها لفساد أقواله، فلما طرد منها وزال طقسه خرج من الأسكندرية ومضى إلى فلسطين وأحتال حتى نال درجة الكهنوت وقسم قساً من يد أسقف قيسارية فلسطين،ويذكر الأنبا ساويرس (ابن المقفع) تاريخ البطاركة: سيره الأباءالبطاركه – ساويرس إبن المقفع أسقف الأشمونين أعده الأنبا صمؤيل أسقف شبين القناطر وتوابعها طباعة النعام للطباعة والتوريدات رقم اإيداع 17461/ لسنة 1999 الجزء الأول ص 17: " فلما رأى أوريجانوس الذى حرمه ديمتريوس بأن البيعة قد أبعدته مضى إلى اليهود وفسر لهم آيات من الكتب العبرانية على غير جهتها، وأخفى ما فيها من نبوات الأنبياء عن السيد المسيح حتى أنه لما جاء إلى موضع الشجرة التى كان فيها كبش أبراهيم (عندما كان يريد أن يقدم أبنه محرقة) مربوطاً بقريبه (شجيرة)، وقد فسرها ألاباء أنها مثال خشبة الصليب، فأخفى أوريجانوس ذكرها، وأزاله، وفسر كتباً كثيرة كذباً ليست صحيحة وشاركه مخالف آخر أسمه سيماخوس.. قال: " أن المسيح مولود من مريم ويوسف وأنكر قوة الولادة العجيبة وأن السيد المسيح مولود بلا تعب.. لأنه هكذا ولد من العذراء بلا تعب، هو الإله وهو الأنسان بالحقيقة واحد من أثنين، وكان هذا المخالف يظهر انه مسيحيى مرة ومرة أخرى يقول أنه حكيم وقد قرأ كتب الصابئة والمعتزلة.. ثم صادق أوريجانوس وأضل مجموعة من السذج، فقام أنسان فاضل قديس له حكمة إلهيه أسمه أمونيوس بالرد عليهما وأظهر كذبهما فيما فسراه من الكتب
الروح المسيحية النبيلة لأوريجانوس:
أطاع أوريجانوس قرار المجمع المحلى فى مصر متحاشيا روح الفرقة والإنقسام بكل محبة مسيحية أبتعد عن مكان نشأته والموضع الذى أحبه أكثر من أى بقعة أخرى على الأرض وهو الرجل الذى أعتقد أنه بخصى نفسه ضحى بشئ وبإبتعاده هذا ليست بالتضحية العظيمة من أجل حفظ وحدة الكنيسة، فقد وصلت علاقاته الشخصية قصر الأمبراطور ولأعماله ومركزه العلمى وصلت شهرته إلى العالمية حيث كان يتعلم فى مدرسة الأسكندرية أبناء عظماء بلاد الشرق والغرب، ويقول ابونا القمص تادرس يعقوب الملطى: فكان فى إمكانه قيادة حركة مضادة للبابا لكنه لم يفعل هذا، ويشهد على صلاته فى موطنة قوله: " يحدث أحياناً أن أنساناً يطرد خارجاً ويكون بالحق لا يزال فى الداخل، والبعض يبدون كما لو كانوا بالداخل مع أنهم بالحقيقة هم بالخارج "
الأنبا ديمتريوس يطارد أوريجانوس
وذهب أوريجانوس إلى قيسارية فلسطين وصار يقدس هناك أسقفاً، فكتب البابا ديمتريوس إلى الأكسندرس أسقف يورشاليم يقول له: " لم نسمع أن مارقاً يعلم (يقصد أوريجانوس) فى مكان فيه أساقفة قيام " وكان يعتب على أسقف قيسارية وأسمه تاودكطس ويلومه لأن أوريجانس عنده ويصعب عليه الأمر ويقول: " ما ظننت أن يكون هذا فى قيسارية (على هذا السقف) وقد وجدنا فى كتب أوريجانوس يقول أن: الأبن مخلوق والروح القدس مخلوق " فقرأ أسقف قيسارية كتاب البابا ديمتريوس فى البيعة (الكنيسة) لأن اسقف أورشليم أرسله إليه فقطع أوريجانوس (حرمه) وطرده من كرسى قيسارية وعاد أوريجانوس إلى الإسكندرية ويقول الأنبا ساويرس: " فعاد (أوريجانوس) بقلة حياء إلى الإسكندرية "ولما صار على أنطاكية بطرك أسمه فيلتس ظهر فى أيامه رجل مخالف آخر وكتب كتباً خارجه عن التعليم، ثم مات فيلتس ورسم بطرك اسمه زابتوس فأمر أن لا تقرأ كتب هذا المخالف، كما لا تقرأ كتب اوريجانوس الذى نفى من ألسكندرية لأن كتبه كانت قد أنتشرت وأشتهرت وقال: " من يحب أن يقرأ الكتب فليقرأ الكتب المقدسة " وكان البابا ديمتريوس عقد سينودسيَن ومنعهُ على إثرهما من التعليم ومن الإقامة في الإسكندرية، وقد ثبَّت البابا بونتيانوس هذا التدبير، ذلك أن أوريجانوس كان قد ارتكب خطأً فادحاً في خَصْي ذاتهِ، مُفَسراً بشكل حرفي ما ورد في مت 19/12. لكن من المحتمل أن هناك أسباباً أبعد من ذلك، تتعلَّقُ بصحة تعليمهِ بسبب هذه الأحداث انتقل أوريجانوس ليعيش في القيصرية تحت ظل الأسقف ثيوكتيستوس، حيث باشر بتأسيس مدرسة لاهوتية على شاكلة تلك التي كان عمل بها في الإسكندرية، بمساعدة صديقهِ أمبروسيوس الذي كان غنوصياً قد اهتدى إلى الإيمان. وأمضى أوريجانوس الباقي من حياتهِ هناك حيث علَّم ووعظ.
إتهام أوريجانوس بالتبخير للأوثان
تم اتهام أوريجانوس أيضاً بأنه ضحى للأوثان فى أواخر حياته حين ألقى فى سجن كريه وقد إعتمدوا فى دليلهم على رثاء على نفسه بعد أن خرج من السجن، ولم يذكر أحد من المؤرخين أنه قام بالتبخير للأوثان، ولكن فى هذا الرثاء إذا كان هو كاتبه حقاً لم يصرح صراحة بأنه قد بخر للأوثان، وأى رثاء لا يشترط فيه أنه عمل جرما كبيراً إن الإنسان الحساس الملتصق بالرب يمكن أن يرثى نفسه عندما يسقط فى خطية ولو صغيره لأنه فقد صلته معه ولو للحظة ولكن يوجد رجاء فى دم المسيح الذى يطهرنا من كل خطية إن مشكلة الذين يحرمون أوريجانوس أنهم لا يعطون الرجاء فى الرجوع لأنه بالرغم من إعتراف أوريجانوس للبابا ديمتريوس بالخصى إلا أن البابا لم يغفر له لأنه كل خطبة قابلة للمغفرة إلا التجديف على الروح القدس وأوريجانوس لم يحاكم ولم يدافع عن نفسه ولكن أعماله ومحبية على مدى قرون دافعوا عنه ومنهم القديس العظيم والشهير يوحنا ذهبى الفم وفيما يلى الرثاء:
" أيها البرج الشامخ كيف سقطت إلى الحضيض بغته، أيتها الشجرة الغضة كيف يبست على الفور، أيها النور المتوقد كيف أظلمت وشيكاً، أيها الينبوع المتدفق الجارى كيف نضبت، ويل فإنى كنت مشتعلاً بمواهب ونعم وقد تعريت من جميعها ألآن، فرقوا لحالى يا أحبائى فإنى قد رذلت لأنى دست خاتم إقرارى وإتحدت مع الشيطان، أشفقوا على يا خلانى فإنى قد طرحت من أمام وجه الرب، أين ذاك الراعى راعى النفوس الصالح، أين من نزل من أورشليم إلى أريحا وعنى بأمر جريح اللصوص، فإنجدنى يارب أنا الذى وقعت من أورشليم، ونقضت النذر الذى أخذته على بالمعمودية وغيرها، أغثنى أيها الروح القدس وهبنى نعمة من لدنك لأتوب، رب أنى أبتهل أن تردنى فقد سلكت للهلاك أعظم مسلك، أنعم على بالروح القدس المرشد والمهذب الصالح لئلا أمسى مأوى للشيطان بل أدوسه كما داسنى وأقوى على حيله فأعود للتمتع لخلاصك، رب إنى أخر أمام عرش مراحمك فكن بى رحيماً أنا النائح هذا النواح لشدة ما أسأت إليك، كثير من المسيحيين يتوسطون عندك من أجلى أنا العبد السقط، رب أظهر رحمتك لخروفك التائه الذليل، ونجنى من فم الذئب المفترس، أنزع عنى ملابس حدادى وألبسنى منطقة الفرح والسرور وأقبلنى فى فرح وأجعلنى أهلاً لملكوتك بواسطة خالص صلوات الكنيسة عنى لأنها تحزن على وتواضع نفسها من أجلى ليسوع المسيح الذى له الكرامة إلى الأبد "
هل من أنصاف للعلامة أوريجانوس؟
جميع الكتابات التاريخية هى على الحياد فى جميع القضايا ولا ننحاز حتى لرأى الكنيسة القبطية والأحداث التاريخية لا تكذب ولكن الآراء حول حدوثها وأسبابها ونتائجها تختلف من إنسان لآخر ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن المواضيع المحيرة موضوع حرم العلامة أوريجانوس، ويشعر القبطى بالفخر من أعمال هذا الرجل العظيمة فى خدمة العلم والوطن والمسيح كما يشعر القبطى أن من بين ابناء شعبنا خرج العلامة القبطى أوريجانوس، وإذا كانت الكنيسة القبطية حرمته من عضويتها إلا أنه ظل علامة يعطى بسخاء وطاعة وظل قبطياً مصرياً أصيلاً فلا أحد يستطيع سحب جنسيته ولا حتى محبته للمسيح وعطاءه له، والعلامة أوريجانوس موضع تبجيل وأحترام من معظم مؤرخى التاريخ وخاصة الغربيين وبعض ابناء الكنيسة القبطية، وفى هذا الموضوع سنورد ما قالة العلامة المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا - منقولة من كتاب - منشورات أبناء الأنبا غريغوريوس، موسوعة الأنبا غرغوريوس، الدراسات الفلسفية للمتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمى سنة 2004 م ص 276 - 278 - عن موضوع هل من انصاف للعلامة أوريجانوس؟ وقد وضعنا عناويين لكل مقطع فقط
أعجاب آباء الكنيسة بشخصسة وعلم العلامة أوريجانوس
يقول الأنبا غريغوريوس: "
لم يكن أوريجانوس، ذلك العبقرى الفذ، هو أعظم قادة الفكر بين المصريين وحدهم، ولا بين الجانب المقيمين فى مصر فحسب، بل كان أعظم أهل زمانه فى كل بلاد الشرق، والغرب أيضاً... حتى أنك لا تفتح كتاباً أو دائرة معارف شرقية أو غربية إلا وتجد أسم اوريجانوس يحوطه الإعجاب والإحترام والتقدير العظيم وهو يوصف عادة بأنه المع لاهوتى فى زمانه، ومن أعظم قلة معدودة فى تاريخ المسيحية بأسرها، وأنه فاق فى شهرته أساتذته الأفذاذ، وقفز أسمه إلى قمة الشهرة التاريخية، وصار يعرف ب (دكتور) الكنيسة الجامعة الأمر الذى لا شك فيه، ولا جدال حوله هو عبقرية أوريجانوس وشخصيته الفذة التى.. جمعت فأوعت: روحانية عميقة، وعلماً واسعاً وعقلاً جباراً، وأستاذية نادرة، ورجلاً مكملاً بالفضائل الأخلاقية والذهنية والعلمية، بصورة يتيمة لا تتكرر فى الترايخ إلا فى حقب متباعدة تفصل بينها قرون واجيال وأضاف قداسته: " والمعروف عند جميع الدارسين، أن كل الذين تتلمذوا على العلامة أوريجانوس من آباء الكنيسة الكبار، كانوا معجبين به كل الإعجاب، ولقد أثنوا عليه فى كتاباتهم ثناء عاطراً نادراً، ومدحوه مدحاً سخياً وبغير تحفظ، ولقد حمدوا صفاته الشخصية الروحية، كما حمدوا له عبقريته الفكرية اللاهوتية، وحمدوا له أيضاً غيرته المسيحية الأرثوذكسية، وذكروا له بالأعجاب والفخر مقاومته للآراء الهرطقية، فضلاً عن المذاهب الفلسفية الوثنية المنتشرة فى زمانه، ومن بينها مذهب كلسوس Celsus الفيلسوف البيقورى الكبير، الذى تزعم مهاجمة المسيحية وكان يسخر منها، فإنبرى له أوريجانوس بالبيان الشفاهى والكتابى حتى أنهزم كلسوس أمام قوة حجتة بل واعلن أقتناعه بالمسيحية، وأعتنق المسيحية ووضع فى تأييدها كتباً ومن بين الهرطقات التى قاومها اوريجانوس بدعة ضد خلود النفس أنتشرت فى بلاد العرب فى ايام فيلبس العربى، فذهب إليها، وحضر فيها مجمعاً وأستطاع أن يهدى الضالين، وأن يواجه الهراطقة بالدليل والبرهان، حتى أجهز على تلك البدعة وقضى عليها وغير ذلك الكثير صنعة أورجانوس، وله الفخر أنه أستطاع أن يرد إلى الإيمان الأرثوذكسى بريل أسقف البصرة
عبقرية أوريجانوس
على أن مشكلة أوريجانوس الحقيقية هى عبقريته.. أن عبقريته جعلت أنتاجه الخصب أبعد من مناله، فلم يكن له الوقت ليراجع أعماله وأكثر كتاباته وربما كلها لم يكتبها بقلمه ولكن كان لها جيش من الهواة، والأتباع والتلاميذ، بعضهم يكتب بقلم سريع ما يمليه عليهم الأستاذ العظيم، وبعضهم كان يأخذ ما يكتبه اصحاب القلم السريع (الإختزال) وينسخونه فى صحائف بخط واضح وجميل ولم يكن لأوريجانوس الوقت يراجع فيه اقواله والكتابات التى ينقلها عنه بعض تلاميذة، ولا المخطوطات المنسوخة بالخط الواضح الجميل.. ومع أمتداد حياته زاد إنتاجه الخصيب حتى صار يضم ألوفاً من الكتب، وقد قال عنه القديس أبيفانيوس أسقف قبرص: " أن قارئاً مهما كان واسع الأطلاع، لا يسعه الإلمام بكل مؤلفات أوريجينيوس لأن له اكثر من ستة الاف كتاب.
مشكلة اوريجنيوس
وإذاً فقد كان أمراً متوقعاً أن تحتوى الكتابات التى تحمل أسم أوريجينيوس على أخطاء، ولا نعلم إذا كانت هذه الأخطاء هى من عمل تلاميذه أصحاب القلم السريع (الأخنزال) أم من عمل تلاميذه النساخ، أم من عمل الفريقين معاً، كل فريق أسهم فى بعض تلك الأخطاء التى نسبت إلى اوريجينيوس، مما أحتوته الكتابات التى تحمل أسمه ويضاف إلى هذا أنه كان من عادة بعض الهراطقة فى الأزمنة القديمة أن يقحموا آرائهم الهرطقية فى صلب كتابات عالم فذ مثل أوريجينيوس، فى النسخة الخطية التى ينسخونها من تواليفه، وذلك لكى يكسبوا تأييداً لأفكارهم عند جمهور عريض من الناس يحترمون أسم أوريجينيوس وإنصافاً لأوريجينيوس نقول أنه هو نفسه كان يتنبه أحياناً لبعض الأخطاء وقع فيها أو زل فيها لسانه، من ذلك رأيه فى أن نفوس الناس، أى أرواحهم، كانت موجودة سابقاً قبل حلولها فى أجسادها بالولادة، وأنها لأخطاء إرتكبتها فى حياتها السابقة، عوقبت بأن حبست فى أجساد، لعلها بهذا الحبس فى الجسد ومعاناتها قى الأرض، تكفر عن خطاياها السابقة و ثم بهذا تتطهر فتعود إلى العالم الآخر مطهرة نقول أن هذه الفكرة أخذها أوريجانوس عن أفلاطون فى (نظرية المثل) وبرهن عليها من ألأنجيل بسؤال تلاميذ المسيح لمعلمهم عن المولود أعمى: " َفِيمَا هُوَ مُجْتَازٌ رَأَى إِنْسَانًا أَعْمَى مُنْذُ وِلاَدَتِهِ، 2 فَسَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ: «يَا مُعَلِّمُ، مَنْ أَخْطَأَ: هذَا أَمْ أَبَوَاهُ حَتَّى وُلِدَ أَعْمَى؟».(يوحنا 9: 1و2) ولكن اورجينيوس عاد وأعتذر عن هذا ومهما يكن من أمر, فهناك آراء خاطئة نسبت إلى أوريجينيوس ووجدت فى كتاباته، ولكننا لا نعلم على وجه اليقين إذا كانت هذه الاراء الخاطئة مردها كلها أو بعضها إلى التلاميذ الذين كتبوا ففاتهم فكر الرجل فعبروا عنه خطأ، أو فاتهم عبارات أو كلمات، فجاءت كتاباتهم صورة شوهاء.. لما ما قاله العالم الكبير، أو أن هذه الأخطاء جائت من عمل النساخ الذين بحسن نية أو بسوء نية أضافوا او حذفوا، فجاءت كتاباتهم مشتملة ‘لى أخطاء، وصار أوريجينيوس مسئولاً عنها، لأنه لم يكن لديه وقت لمراجعتها وتصحيحها، ولقد أمكنه، كما قلنا، أن يصحح بعضها، ولكنه لم يمكنه أن يصحح كل ما أتهمه به خصومه فيما بعد.
أوريجينيوس والتطبيق الحرفى للأنجيل
أما أنه خصى نفسه فهذه حقيقة، ولقد أضطرت الكنيسة أن تقف منه فى هذا الخطأ موقفاً حازماً، لقد تساهلت مع سمعان الخراز أو الدباغ الذى خلع عينه بالمخراز عندما أعثرته أمرأة ساقطة عرت ساقها أمامه، لكن سمعان رجل بسيط، ولا يقتدى بعمله أحد نظراً لبساطته، أما أوريجينيوس فقد كان تصرفاً خاطئاً حتى لا يتبعه فى عمله آخرون فيخصون أنفسهم مثله سيظل موضوع أوريجينيوس مشكلة معقدة لا حل لها يرضى جميع الأطراف، وسيبقى مسألة غامضة لا يجلوها إلا الرب نفسه فى يوم الحساب العظيم إن حرم الكنيسة لأوريجينيوس مأساة تاريخية، ومع ذلك ليس فى مقدورنا الان أن نصنع شيئاً إعادة محاكمة أوريجينيوس أو مراجعة الحكم عليه، لأن معلوماتنا عنه ناقصة فلم يبق من كتاباته إلا القليل، وفقد منها الكثير، ولسنا نستطيع أن نستعيد أحداث التاريخ بصورتها الحية التى عاشها المعاصرون لها، بما احاطها من ظروف وملابسات ومفاهيم اجتماعية أن موضوع أوريجينيوس، إذا أردنا إنصافاً له وللحقيقة، أن نستودعة يد الله الحاكم العدل، وهو الحق والحقيقة.. وعزاؤنا أن أحكامنا على الأرض أحكام إبتدائية، ولكن هناك بعد الموت محكمة أستئناف عليا، وفى يوم الحساب العظيم سيصير الحكم العدل الذى لا نقص فيه، وأمامه: " لِكَيْ يَسْتَدَّ كُلُّ فَمٍ، وَيَصِيرَ كُلُّ الْعَالَمِ تَحْتَ قِصَاصٍ مِنَ الإِله (رومية 3: 19) فلنترك قضية أوريجينيوس بما فيها من حق وظلم، بين يدى الديان الإله العادل: " لَّذِي سَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ.(متى 16: 27)، (رومية 2: 6) أما نحن قلا نملك إلا الإعجاب بكل صفات أوريجينيوس النبيلة والجميلة، ونحنى هاماتنا أمام عبقريته العظيمة، ونثنى على ما أسداه لنا ولكل الأجيال من خدمات ومعارف، مترحمين عليه، نسأل له الغفران عنا عساة أخطأ فيه عن غير علم، فالرب وحده هو المعصوم من الخطأ
تعليق: فيما يبدو ان أوريجانوس ندم وخجل من فعلته أما عن السبب الذى قيل أن الكنيسة حرمت العلامة أوريجانوس لأنه أستاذاً مشهوراً ويقتدى به كثيرين ولم تحرم سمعان الخراز لأنه مجهول.. سبب غير مقنع لأن سمعان لاخراز اليوم أكثر شهرة فى الكنيسة القبطية من العلامة أوريجانوس، كما أن قطع عضو أو أتلافه لم يحسب خطية عند الرب الإله يستحق الحرم وإلا لما أستخدم سمعان الخراز فى معجزة نقل جبل المقطم، كما أن السبب الذى قيل أنه قبل أن يرسمه أسقفاً غير أسقفه لا ترتقى لأن تكون أتهاماً.. وكما قال الأنبا غريغوريوس سيظل حرم اوريجانوس مشكلة معقدة تريد حلاً لهذا الرجل العظيم ذو الصفات النبيلة.
المزيد
28 نوفمبر 2024
مشكلة أوريجانوس
هناك خمسة إتهامات منسوبة للعلامة أورجانوس، الأولى مؤكدة، أما الأربع إتهامات الآخرى فغير معلوم على وجه اليقين هل هو فعلا آمن بها أم إنها بدع مدسوسة فى كتاباته من قبل الهراطقة لنشر افكارهم من خلال كتب العلامة اورجانوس، وتتمثل تلك التهم فى الآتى:
1- قم بخصى نفسة (وهذة حقيقة مؤكدة).
2- آمن بعودة التجسد: أى أن النفوس خلقت قبل الأجساد وإرتبطت بالأجساد كتأديب عن خطايا سابقة أرتكبتها وأن عالم الحس بالنسبة لها ليس إلا مكاناً للتطهير.
3- نفس المسيح لها وجود سابق قبل التجسد وإتحدت باللاهوت.
4- ستعود كل الخليقة إلى أصلها فى الرب، ويخلص كل البشر (وأن العقوبة الأبدية لها نهاية)
5- سيخلص الشيطان وكل الأرواح الشريرة
فكر أوريجانوس والبابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23
التفسير الرمزى هو إتجاه لتفسير الكتب المقدسة بما يسمو بالروحانيات، ولا دخل بالثقافة الوثنية أو الفلسفة الوثنية فى تفسير الكتب المقدسة لسبب بسيط هو أن التفسير الرمزى هو إتجاه فكرى بحثى تأملى للوصول إلى العمق الروحانى، والتفسيرات الرمزية تعتمد على قدرة تأمل الإنسان، وتختلف قدرة التأمل من إنسان إلى آخر، كما أنه فى فقرة ما أو آية ما ينطبق عليها التفسير الحرفى وينطبق عليها ايضاً التفسير الحرفى البسيط، بل نستطيع القول أنه يمكن تفسير كل شئ بالتفسير الرمزى ولكن لا يمكننا تفسير كل شئ بالتفسير الحرفى البسيط، والتفسير الرمزى لا يتعارض إطلاقاً مع التفسير الحرفى، ولكن التمسك بالتفسير الحرفى بمفرده فهذا قد يقتل التمتع بالايات المقدسة هو الذى تجعل الإنسان يسموا فى سماء الروح نحن محتاجين للتفسير الرمزى أكثر من الحرفى، وبالرغم من أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد حرمت أوريجانوس وحرمت فى بعض الأحيان من يقرأ كتاباته، إلا أن كتاباته لا زالت حية ويقرأها الأقباط حتى يومنا هذا بل ويستمتعون بها، كما أنه يمكن القول فى ثقة أن التفسير المجازى والرمزى والتأملى الأوريجانى هو الذى يتبعه غالبية قادة الكنيسة القبطية كمنهج رئيسى فى تفسير الكتب المقدسة وبالرغم من محبة معظم الأقباط لهذا المنهج الأوريجانى فى الكنيسة القبطية فى التفسير شعباً وقادة، إلا أن الكنيسة القبطية تفتقر للتفسير العلمى الواضح والبسيط، وإنغماس القادة فى هذه التفسيرات الروحية جعل البرتستانت يتقدموننا فى التفسير العلمى وإلتزامهم بالآيات وحفظهم ودراستهم للكتب المقدسة وننهى هذا الموضوع بالقول أن تفسير الكتب المقدسة يتم عن طريق محاور عديدة منها التفسير الرمزى، والحرفى، والعلمى.. ألخ كما يجدر الإشارة فى التفسير إلى الناحية التاريخية والجغرافية بل والإجتماعية وعادات الناس فى هذه العصور القديمة بل قد يحتاج موضوع ما إلى نوع العملة ومقدارها. الموضوع ليس حرباً بين الفكر الأوريجانى والفكر الحرفى وأيضاً ليس تحيزاً بين منهج وآخر ولكن التفسير الشامل الكامل هو الذى يلم بتفاصيل وزوايا الأحداث فى الكتب المقسة من جميع وجهات النظر: الرمزية والحرفية والعملية والإجتماعية والإقتصادية والتاريخية والجغرافية وغيرها وبالنسبة إلى موضوع أوريجين أو أوريجانوس يمكن تقسيم موضوعه إلى: شخصيته، أعماله الشخصية، كتاباته، منهجة الفكرى فى التفسير الرمزى لقد حرم اوريجانوس لأجل عمل شخصى بتنفيذ آية فى الكتاب المقدس تفسير حرفى وهو صاحب فكر التفسير الرمزى، أما كتاباته لا يستطيع احد أن يتأكد من: هل أدخل النساخ عليها تغيير أم لا (فى أزمنة لاحقة خاصة من الأريوسيين) لأن الاباء العظماء مثل أثناسيوس الرسولى وغيره قد إستخدموها، لهذا لا زالت كتاباته تقرأ، أما عن منهجه فى التفسير الرمزى فلا أحد يستطيع حرم إنسان يستخدم التفسير الرمزى والمجازى الأوريجانى
الفكر الأوريجانى والبابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23 فى القرن الرابع
شغف آباء القرن الرابع بالفكر الأوريجانى (نسبة إلى العلامة المصرى أوريجانوس) وقلدت كتاباتهم الفكر الأوريجانى المؤسس على الرمزية، كما درسوها وحفظوها وأخذوا أفكاره وأستبعدوا أخطاؤه، مشيرين إليها دون أن يقلل ذلك إهتمامهم بها أما رهبان مصر فقد إنشغلوا بالفكر الأوريجانى
البابا أثناسيوس الرسولى وآباء وقديسين إستخدما كتابات وأقوال العلامة أوريجانوس
وقد إعتمد البابا أثناسيوس الرسولى علي ما وجده في كتابات العلامة المصرى أوريجانوس من براهين قوية تسندة فى قوانين الإيمان النيقاوى وفى مقاومة الهرطقة الأريوسية كما شغف بكتابات أوريجانوس آباء وقديسين كبار منهم آباء الكبادوك مثل القيسين باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزنيزى الناطق بالإلهيات وفى الغرب إستوحى القديسان هيلارى أسقف بواتيه وأمبروسيوس أسقف ميلان منها أفكارهما وتأملاتهما أخذ القديس جيروم والأب يوحنا الأنطاكى من كتابات العلامة المصرى أوريجانوس المنهج التفسيرى الأوريجانى فى تفسير الكتب المقدسة.
بداية مهاجمة التفسيرات الأوريجانية الرمزية بالعودة إلى الحرفية
فى حوالى عام 373 بدأ القديس أبيفانيوس (315- 403م) أسقف سيلاميسى بقبرص كتابه عن الهرطقات " خزانة العلاج لشفاء كل الهرطقات" وقد كان ناسكاً أراد أن يرد على كل الهرطقات، وظن أن العلامة أوريجين قد أفسد نقاوة الإيمان الحقيقى (بقصد البسيط) بسم الثقافة الوثنية، وقد إعتبر كتاباته هرطوقية دان فيها أولاً وقبل كل شئ ميله لتفسيره العبارات الحرفية الواضحة برمزية روحية، خاصة روحنة تعليم القيامة لم يقصد أبيفانوس إدانة أوريجين الراقد، بل قصد جزء من كتاباته رآها من وجهة نظرة ليست سليمة ولكنها هرطوقية لأنها رمزية وإبتعدت عن الحرفية البسيطة وفى عام 394 قامت مناقشة بين يوحنا اسقف أورشليم ومعه روفينوس كاهن أويلية وكانا الإثنان معجبان بالعلامة أوريجين وكتاباته، وبين جيروم الذى إعتبر أوريجين هرطوقياً يؤيده بلا شك أبيفانيوس أسقف سلاميس..
الثورة الفكرية التى أحدثتها الكتابات الأوريجانية بين رهبان مصر
الرهبنة فى بدء قيامها فى مصر تأسست على الممارسة العملية لآيات الكتاب المقدس وتنفيذ الوصايا الإنجيلية والنمو فى سلم الفضائل الروحية والقداسة والصراع فى البرية ضد قوات لاشر الروحية هذا ما أعلنه اثناسيوس الرسولى فى كتابه عن القديس أنطونيوس، وكانت فى البداية لا تحتوى على أى إتجاه تأملى عقلى، ولكن ما ان تسللت الأوريجانية " التفسير الرمزى والمجازى " إلى بعض الرهبان والنساك حتى وجدوها لذة وغاية فى الإنطلاق فى تاملات إلهية عميقة وبهذه التأملات الروحية أثار الفكر الوريجانى ثورة فكرية فى الحياة الرهبانية وخاصة بين رهبان مصر.
وخرج القمص العلامة تادرس يعقوب الملطى بنتيجة فقال " نستطيع القول أن الكتابات الأوريجانية هى سر التحول الرهبانى من نسكيات مجاهدة لأجل الفضيلة إلى نسكيات مجاهدة من أجل التأمل أو التأوريا.. "وفى حوالى عام 370م عشق رهبان نتريا الفكر الأوريجانى فى التفسير وحفظ كثير منهم كتابات العلامة المصرى أوريجانوس، وكان الأخوة الطوال فى مقدمة هؤلاء الذين حفظوا عن ظهر قلب الملايين من سطور كتابات أوريجانوس، وإشتهر الإخوة الطوال بالقداسة والنسك والزهد الشديد، وسجل التاريخ نضالهم ضد الأريوسية وذهب أحدهم مع البابا أثناسيوس الرسولى إلى نيقية، وكانوا على علاقة طيبة مع كل من البابا أثناسيوس الرسولى 20، والبابا تيموثاوس 21، وكانوا على علاقة طيبة مع البابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23 حتى عام 400م وكان قد احبهم واكرمهم فرسم ديسقوروس أسقفاً على هرموبوليس، وأراد أن يرسم أخاً آخر منهم أسقفاً إلا أنه قطع اذنه، ورسم الأثنين الباقيين كاهنين عنما رفضاً الأسقفية وأراد البابا أن يبقيهما بالأسكندرية ولكنهما فضلا سكنى البرية وفى شقوق الأرض لممارسة عباداتهم الروحية.
وقوع اغلبية من الرهبان فى بدعة وهرطقة تصور شكل الله الإنسانى
فى منطقة الأسقيط حيث كان يتواجد أعداد كبيرة من الرهبان وكانوا فيما يبدوا على درجة بسيطة من العلم، رفضوا التفسير الرمزى الأوريجانى رفضاً قاطعا بل أنهم إعتبروا الرهبان الذين يأخذون به أعداء وهراطقة، وقاموا بتفسير العهد القديم تفسيراً حرفياً فتصورا أن الإله له وجه وعينان وأيدى وأعضاء جسدية وفسروا بعض الايات التى وردت فى العهد القديم بلغة يفهمها البشر بتفسير حرفى كقول العهد القديم إسجدوا عند موطئ قدميه (مز99: 5)عيناى على أمناء الأرض... المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عينى (مز 101: 6، 7) يداك صنعتانى وأنشأتانى (مز119: 73)أضئ بوجهك على عبدك وعلمنى فرائضك (مز114: 135)وهكذا سقطوا فى بدعة جديدة إعتنقوا فكر تجسيم شكل الإله أو تصور شكل الإله الإنسانى Anthropomorphism كان رأس وقائد هذه البدعة أفوديوس من بين النهرين وجر ورائه الكثيرين من الرهبان... وحدث نزاع فكرى بين الوريجانيين من جهة وأصحاب هرطقة تصور شكل الإله الإنسانى Anthropomorphism كم جهة أخرى وأصبح هناك حزبين من الرهبان وكثر اللغط والكلام حول هل للإله أعضاء جسدية؟ وهكذا أصبح فى مصر فريقان من الرهبان فريقاً وصل إلى أقصى درجات العلم فى التفسير وهو الفريق الذى تبنى التفسير الرمزى الأوريجانى وآخر فريقا من الرهبان جاهلاً تصور أن للإله أعضاء جسدية حسية وكان للأسف الرهبانمن أصحاب بدعة تصور شكل الإله الإنسانى Anthropomorphism هم الأكثر عدداً وقوة، فقد كان التعلم فى الأزمنة القديمة لا يقدر عليه إلا الأغنياء وكان يعتبر شكلاً من أشكال الرفاهية إنقسم رهبان مصر إلى قسمين أكثرية سقطت فى بدعة تصور شكل الإله الإنسانى Anthropomorphism وأقلية رهبانية كانت تفسر الإنجيل بطريقة رمزية كان أول من بدأ بها هو العبقرى أوريجانوس العلامة المصرى، وكان البابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23 يميل إلى الإتجاه الأوريجانى الرمزى فى التفسير وفى عام 399م كتب البابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23 رسالته الفصحية التى تقرأ فى كل الكنائس والتى كان من العادة إرسالها ويحدد فيها عيد القيامة حسب قوانين مجمع نيقية، وفى هذه الرسالة لمح البابا بطريقة غير مباشرة أنه لا يليق بنا أن نعتقد فى الإله بطريقة جسمانية مادية لأن الإله روح، إذ هو غريب عن الشكل البشرى وقد روى القديس يوحنا كاسيان فى كتابه " المناظرات " أثر هذه الرسالة على جماعات الرهبان، فقد رفضت المجامع قرائتها ، ما عدا القديس بفنوتيوس الذى كان أباً لمنطقة شهيهيت العليا، الذى تلاها فى مجمعه وما أن عرف الراهب البسيط صرابيون وهو من أنصار بدعة تصور شكل الإله الإنسانى Anthropomorphism ما جاء فى الرسالة حتى رأس حركة مقاومة لهذه الرسالة وسرعان ما إنضم له أعداد غفيرة من الرهبان وكان هذا الراهب بسيطاً وزاهداً وناسكاً
الرهبان يهددون البابا بقتله لأنه هرطوقى
وسرت نار التمرد والثورة فى قلوب الرهبان التى خرجت للبرية للصلاة والجهاد والفضيلة، وبالرغم من أنهم يعتنقون فكراً هطوقياً إتهموا البابا بأنه هرطوقى وتجمعوا فى جماعات بالإسقيط وتحركوا فى حشد غفير إلى الإسكندرية، فأحاطوا بالبطريركية يصيحون ويتوعدون بالقضاء على البابا الهرطوقى مهددين بقتل صاحب البدعة والهرطقة البابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23 هذا ما سجله المؤرخون القدامى
إلى من إنحاز البابا ثاؤفيلس البطريرك رقم 23؟
ويقول العلامة القمص تادرس يعقوب ملطى عن هؤلاء الرهبان الهراطقة: " أن كثيرين منهم كانوا بسطاء وعباد روحيين، ويسهل قيادتهم ويبذلون حياتهم من أجل طاعة مرشديهم الروحيين، وكانوا مملوئين حباً للإله الذى ظنوا أنه له شكل مجسم، ورأى البابا ثاؤفيلس البطريرك أن الوقت ليس وقتاً للجدال والنقاش بل أراد كسب صداقتهم حتى يعالج ألمور بهدوء وسكينة.. بحكمة إلتقى بهم قائلاً بلطف: " إذ أراكم أنظر وجه الإله "ففسروا قوله تفسيراً حرفياً كعادتهم وفعلاً خفت حدة غضبهم، واجابوه: " إن كنت حقاً تقول بوجود ملامح لٌله مثلنا فإحرم كتب أوريجانوس، فقد إستخرج البعض منا أدلة تخالف قولنا، وإن لم تفعل ذلك فتوقع منا معاملتك كهرطوقى عدو للإله " وأجابهم البابا ثاؤفيلس البطريرك: انى مهتم بهذا الأمر، ومستعد أن أجيب طلباتكم، لا تغضبوا على، فإنى لست موافقاً على أعمال أوريجين وألوم من يقتنيها "
عاد الرهبان إلى أديرتهم، وكاد الموقف ينتهى عند هذا الحد كقول المؤرخ سقراط لولا ثورة الأخوة الطوال، فقد رأوا فى تصرف البابا جبناً وإستهتاراً بالعقيدة ومجاملة على حساب الحق.. " وفى الفصح التالى عقد البابا مجمعاً وحرم أوريجينوس وكل من يقرأ كتابات أوريجين، وهكذا نفذ البابا طلبات الهراطقة ووجد الأخوة الطوال أنفسهم فى حالة حرم لأنهم يحبون كتابات أريجانوس وتفسيره الرمزى للكتاب المقدس، فتمردوا أيضاً ولكن كان البابا سريعا فى التحرك فقاد قوة عسكرية وذهب إلى اديرتهم وقام بحرق صوامع الرهبان واحاط الجنود بالرهبان وإختبئ الأخوة الطوال فى بئر عميقة وقتل أحد الرهبان وهو يصلى فى صومعته ويقول الملكيين انه قتل كثيرين من الرهبان الإوريجانيين ثم هربوا من الجنود وإعتصموا فى الكنيسة.
المزيد