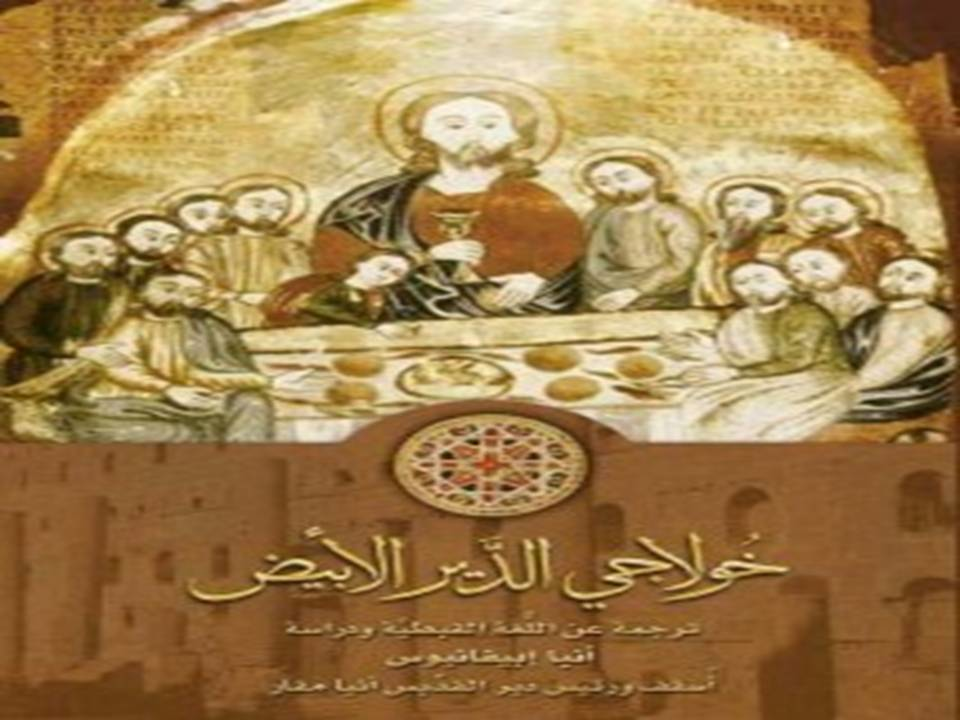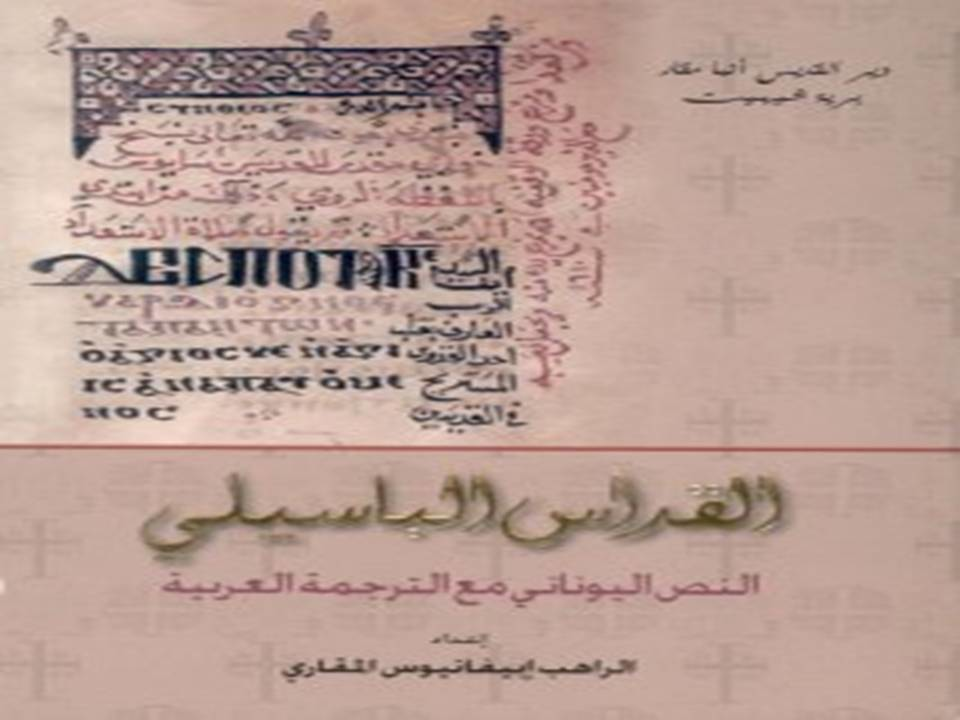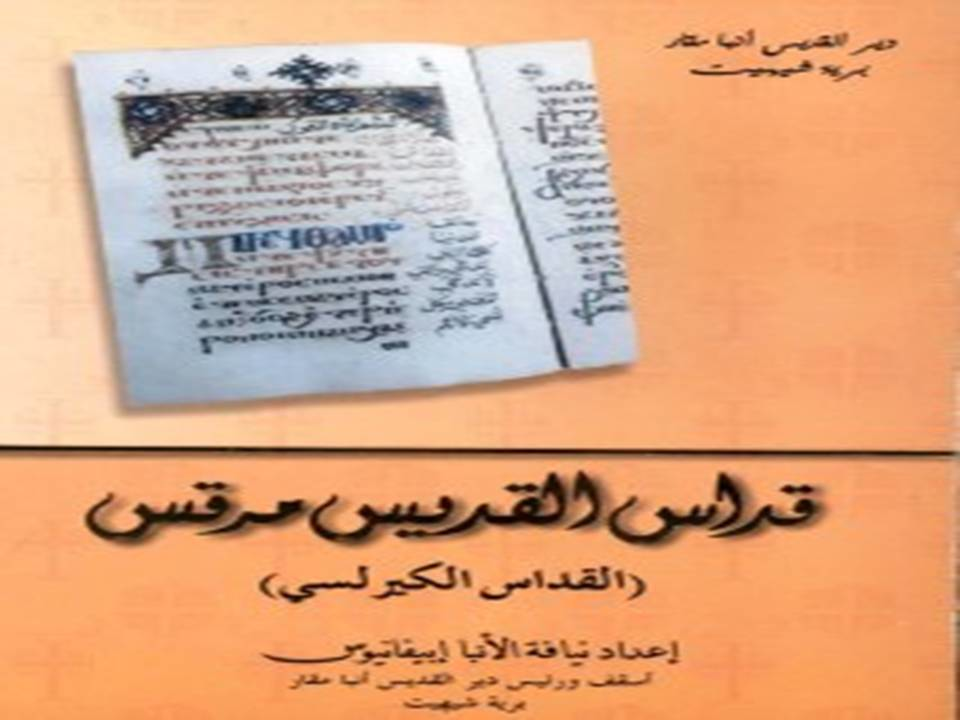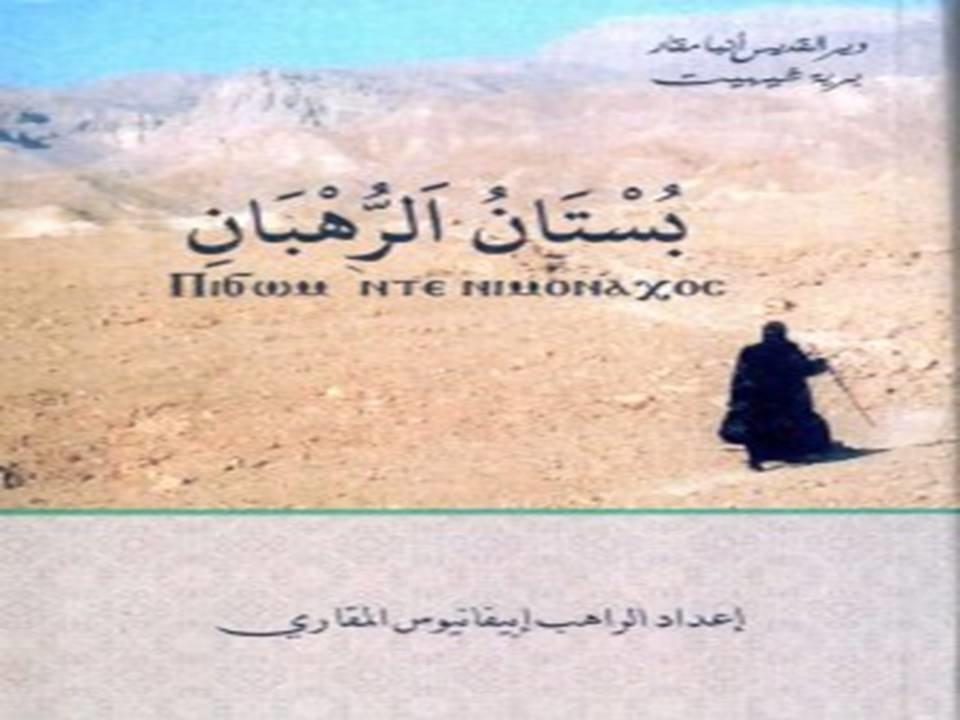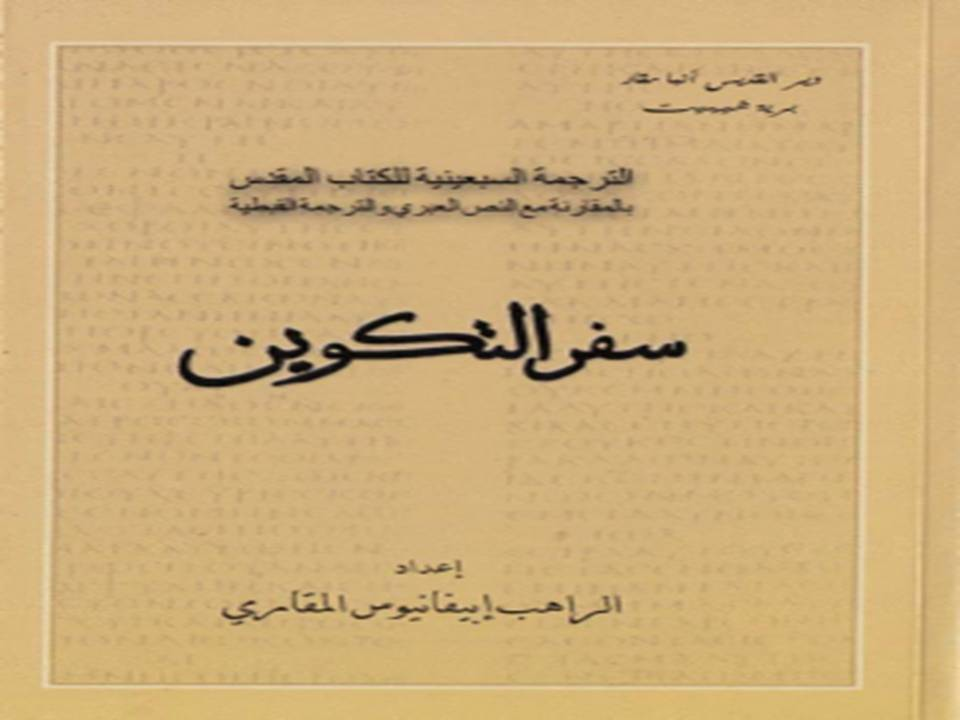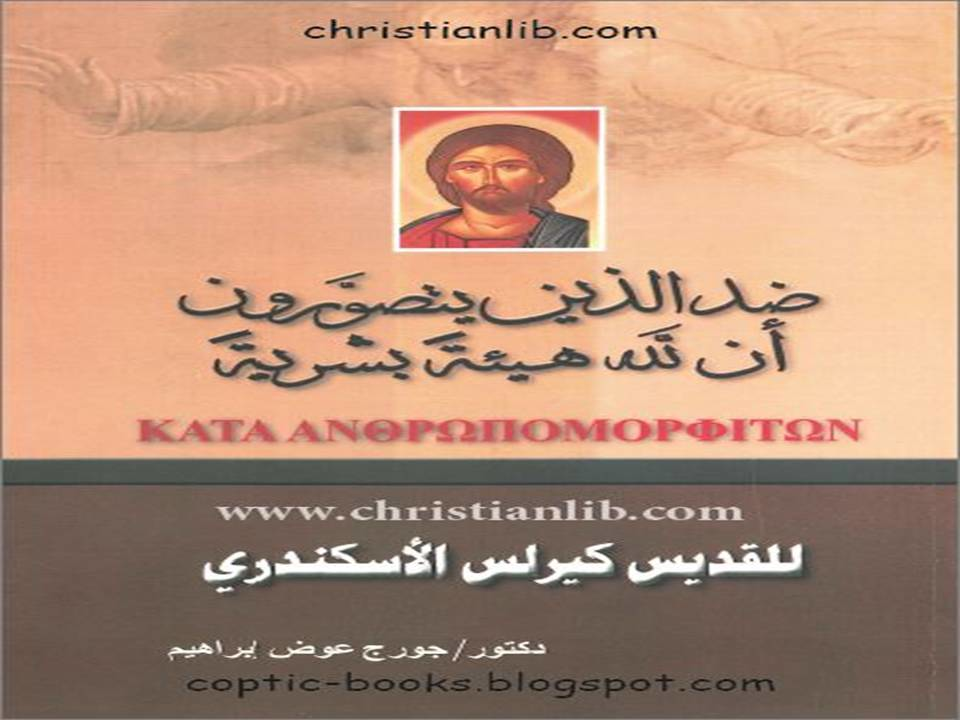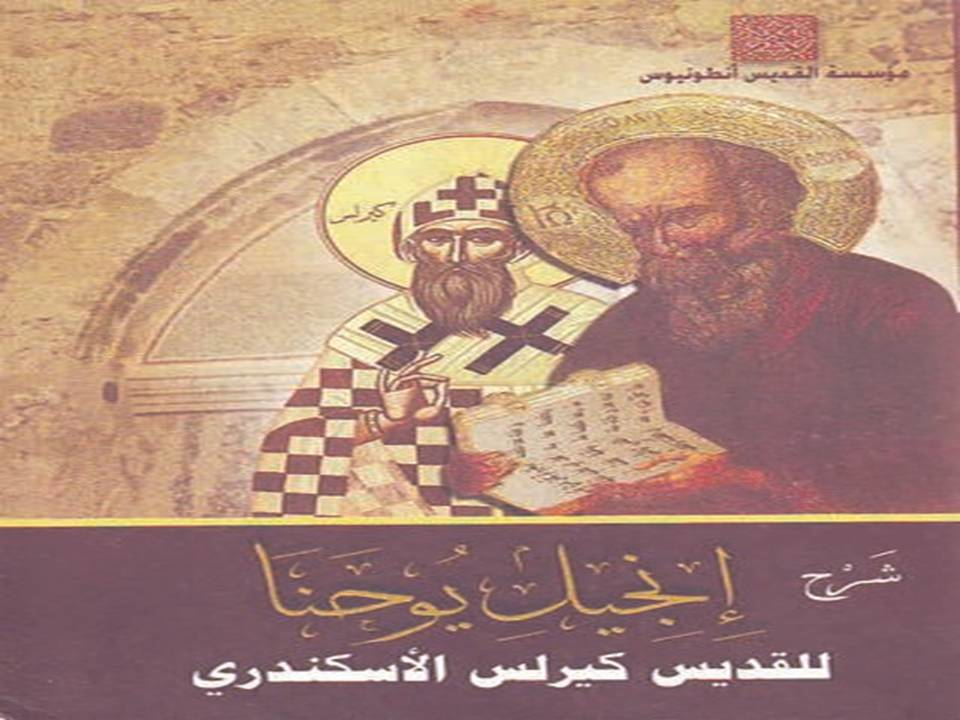الكتب
خولاجي الدير الأبيض ترجمة عن اللغة القبطية ودراسة
دراسة تحقيق القديمة وتحقيق النصوص، تُعتبر علمًا في حد ذاته، يهدف إلى الحفاظ على التراث الإنساني بصفةٍ عامة. ومهمة علماء الليتورجيات في تحقيق ونشر المخطوطات التي تحوي نصوصًا ليتورجية – أي نصوص الصلوات التى كانت تستعملها الكنيسة – لا تهدف فقط إلى حفظ هذه النصوص من الضياع، ولكن هذه النصوص القديمة تلقى ضوءًا باهرًا على حياة الشعب المسيحي في العصور القديمة، وبالأكثر على إيمان هذا الشعب ومعتقده، وعلى مفهومه لسر الثالوث وسر الإنجيل وسر التجسد والفداء.فنصوص الصلوات القديمة، وخاصة التي تُمارس كل يوم تشرح لنا إيمان الكنيسة وإيمان الشعب المسيحي الذي كان يهذُ في هذه الصلوات ويلهج بها كل يوم وكل ساعة، لأن لمثل هذه المخطوطات كانت تُنسخ للاستعمال اليومي، سواء الشخصي أو داخل الكنائس والأديرة، وليس للحفظ فى خزائن الكتب. وبمقارنة هذه النصوص بما نمارسه اليوم، يتضح لنا مدى بعدنا أو قربنا من هذه الممارسات. كما نتعرف أيضاً على النمو الذى حدث للطقس، سواء كان ذلك بالزيادة في النصوص أم النقصان، ومدى ضرورة هذا النمو وأسبابه.كما تشرح وتفسر لنا بعض النصوص التى تبدو غامضة في ممارستنا الحالية، بسبب ضعف الترجمة أو بُعدها عن الأصل المترجم عنه. ومن هنا جاءت أهمية دراسة النصوص الليتورجية القديمة.
القداس الباسيلي النص اليوناني مع الترجمة العربية
القداس الباسيلي
القديس باسيليوس الكبير (330-379م) :
أحد الآباء الكبادوك الثلاثة العظام (مع القديسين غريغوريوس النزينزى وغريغوريوس النيسي) وشقيق القديس غريغوريوس النيسي والقديسة ماكرينا. بعد أن أتم دراسته في قيصرية الكبادوك والقسطنطنية وأثينا، فى أعظم مدارسها المسيحية والوثنية فى تلك الآيام ، ترك العالم للانخراط فى الحياة الرهبانية فعاش كراهب أولاً فى نواحى سوريا ومصر ، ثم استقر عام 358م بجوار نهر إيريس Iris بالقرب من قيصرية الجديدة، وهناك التقى بصديقه القديم القديس غريغوريوس النزينزي، وكان لهما أثرُ كبير في التعليم والكرازة في تلك النواحي. وفي عام 364م ترك حياة الوحدة، تحت الحاح من أسقفه يوسابيوس القيصرى، ليدافع عن إيمان الكنيسة الإرثوذكسي ضد الإمبراطور فالنس الأريوسي وفي عام 370م رُسم أسقفاً خلفًا ليوسابيوس القيصري علي كرسي قيصرية حتى نهاية حياته.بجانب شهرة القديس باسيليوس في الخطابة والفصاحة، وشهادة معاصريه على قداسته، تجلت أيضًا مواهبه في فن الإدارة والتنظيم بما أبدعه من قوانين منظمة للحياة الرهبانية الشرقية. كما ظهرت إمكانياته في الإنشاء والتعمير فى مدينة قيصرية، فبالإضافة إلى الكاتدرائية ومبنى الأسقفية أنشأ أيضًا المستشفيات ومساكن إيواء الفقراء، ووضع لها القوانين الدقيقة، حتى باتت فترة طويلة شاهدة لذكراه.وقد ترك لنا القديس باسيليوس الكثير من الكتابات الهامة، أشهرها كتابه عن الروح القدس، وكتابه ضد بدعة أيونوميوس، وكتابه الفيلوكاليا بالاشتراك مع زميله القديس غريغوريوس النزينزي، وهو عبارة عن مختارات من كتابات العلامة أوريجانوس؛ بالإضافة إلى القداس المعروف باسمه، وقوانينه الرهبانية، والكثير من الرسائل.
قداس القديس مرقس القداس الكيرلسي
ليتورجية القديس مرقس هى ليتورجية كنيسة الإسكندرية. وهي ليتورجية لها طابع خاص يميزها عن باقي الليتورجيات الشرقية القديمة. فهي الوحيدة بين الصلوات الليتورجية القديمة التي فيها صلاة مقدمة القداس (Preface) تحتوي على تقديماً للقرابين؛ كما أن الصلوات التضرعية أو الأواشي تأتي في بداية القداس، يليها صلاة قدوس قدوس، ثم تأتي صلاة استدعاء بسيطة، وبعدها صلوات التأسيس والتذكار وصلاة الأستدعاء الأخير، ثم التمجيد الختامي فالقسمة والتناول.
القديس مرقس الرسول:
هو مرقس الإنجيلي، كاتب الإنجيل الثاني من أسفار العهد الجديد. ويعرف باسم يوحنا مرقس، كان يهودياً، ويمت بصلة قرابة للقديس برنابا الرسول، وقد رافق القديسين بولس وبرنابا في الرحلة الكرازية الأولى، ولسبب ما تركهما ورجع إلى أورشليم، ثم رافق القديس برنابا في رحلته الكرازية إلى قبرص وبعد ذلك ذهب إلى روما مع القديس بولس كما رافق أيضاً القديس بطرس.يذكر التقليد القبطي أنه كان من السبعين رسولاً، وفى بيته أسس الرب يسوع سر العشاء الأخير وفي هذا المنزل حل الروح القدس على التلاميذ والرسل ويؤكد هذا ما جاء في سفر أعمال الرسل أن الكنيسة الأولى كانت تجتمع فى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس.وحسب ما يذكر يوسابيوس القيصري (260-340م) في تاريخ الكنيسة أن القديس مرقس هو مؤسس كنيسة الإسكندرية وأول أسقف عليها، كما أن هناك تقليد متأخر نوعاً ما يربط اسمه أيضاً بمدينة البندقية (فينيسيا) بإيطاليا وكرازته هناك.
بستان الرهبان
فى عام 1978م زار الأب العالم Regnault دير القديس أبو مقار بوادى النطرون وقضى فيه عده شهور وهو من أشهر العلماء المعاصرين الذين قاموا بنشر ومقارنة نصوص الآباء الرهبان بكل اللغات القديمة، وقد حاول أن يتعلم اللغة العربية لدراسة نصوص آباء البرية التى وصلت إلينا في هذه اللغة، والتى لا توجد فى اللغات الأخرى، ولكنه انتقل إلى السماء قبل أن يحقق رغبته. وكان يأمل في نشر كتاب بستان الرهبان العربي، وذلك بعد مراجعته على المخطوطات، وعمل ترقيم للأقوال لسهولة المقارنة مع النصوص الأخرى، وهذا ما حاولنا القيام به.
تحقيق النص:
عمل ترقيم لأقوال الآباء، لتسهيل عملية النقل والاقتباس والمقارنة مع نصوص الأقوال فى اللغات الأخرى.
مراجعة هذه الأقوال على المخطوطات المتاحة فى دير القديس أنبا مقار بوادى النطرون.
وضع شاهد في نهاية كل نص يشير إلى موضع هذا القول في المخطوطات.
اعتبرنا مخطوط س5 هو المصدر الأساسي لهذه الشواهد.
الأقوال التى لم نجدها في هذا المخطوط وضعنا لها شاهداً من المخطوطات الأخرى.
تم وضع بعض العناوين الجانبية، وعمل فهرس بهذه العناوين في هذا الكتاب.
تم اضافة بعض الحواشي التوضيحية لتفسير الكلمات الغريبة ولا سيما التي ترجع إلى أصول قبطية أو يونانية.
كما حاولنا أن نقارن كافة الأقوال مع نظائرها باللغات القديمة الأخرى.
وقد أضفنا شاهداً في نهاية الأقوال التي تم مقابلتها بغيرها يوضح المصدر الذي يقابل أياً من هذه الأقوال.
اكتفينا بمصدر واحد فى أغلب الحالات، يمكن بواسطته الرجوع لباقي المصادر حسب الجدول المنشور في نهاية هذا الكتاب.
النص التقليدي لبستان الرهبان:
وقد التزمنا في النشرة الحالية بالنص التقليدي لبستان الرهبان الذى يقرأ فى أديرتنا منذ مئات السنين، أثناء العجين وعلى مائدة الرهبان، والذى حافظ على تقليدنا الرهباني على مدى الأجيال، وهو الذي يعتبر الأساس فى تلقين الرهبنة للرهبان الجدد.
حياة الرهبان الأوائل:
أن حياة الرهبان الأوائل في صحراء مصر كانت قد اجتذبت الكثير من الآباء والرهبان الأجانب، للتلمذ على أيديهم والاقتداء بسيرة حياتهم. ومنهم من قضى بقية حياته في وسطهم ولم يعد مرة أخرى إلى بلده، مثل القديس أرسانيوس، ومنهم من عاد إلى بلده وكان سبباً فى تأسيس حياة رهبانية على غرار ما عاشه فى إسقيط مصر، أمثال القديس إيلاريون وباسيليوس وإبيفانيوس كاسيان. كما وفد أيضاً عليهم بعض الرحالة الذين عاشوا وتتلمذوا على أيديهم، ثم كتبوا ما رأوه وسمعوه منهم، من أمثال بالاديوس وروفينوس وجيروم وجيرمانوس، ولهؤلاء يعود الفضل الأول فى حفظ التاريخ لسير وأقوال هؤلاء القديسين.
سفر التكوين عربي الترجمة السبعينية بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية
اللغة العبرية هي لغة اليهود العبرانيين التي تكلموا بها منذ الألف الثاني قبل الميلاد، وهي اللغة الأصلية التي دُون بها كتاب العهد القديم بأكمله، ما عدا 268 آية كتبت بالآرامية (سفر دانيال 2: 4-7: 28؛ سفر عزرا 4: 8-6: 18؛ 7: 12-26 ؛ سفر إرميا 10: 11 بالإضافة إلى كلمتين وردتا في سفر التكوين 31: 41-47).
تاريخ الترجمة السبعينية:
تُعتبر الترجمة السبعينية للعهد القديم أقدم ترجمة يونانية وصلت إلينا نقلاً عن النص العبري الأصلي. وأسفار موسى الخمسة هي أول الأسفار التي تم ترجمتها. وقد وردت أقدم إشارة عن هذه الترجمة في كتابات الفيلسوف اليهودي الإسكندري أرستوبولس (حوالي عام 170 ق.م)، ومنها نعرف أن هذه الترجمة تمت فى مدينة الإسكندرية في زمان حكم بطليموس الثاني فيلادلفيوس مللك مصر (285-247 ق.م). ويتأكد هذا الكلام عينه من رسالة أرستياس المرسلة إلى فيلو كراتس (بين عامي 170 و 100 ق.م)، والتى تنص على أن الترجمة تمت بواسطة اثنين وسبعين شيخًا من شيوخ اسرائيل، حسب طلب الملك ومن هنا عُرفت باسم <<الترجمة السبعينية>> نسبة لهؤلاء الشيوخ.وبالرغم من أن هذا العنوان كان يقصد به فى المقام الأول الأسفار الخمسة التي تمت ترجمتها بالفعل فى ذلك الوقت، إلا أن الاسم اتسع فيما بعد ليشمل كل أسفار العهد القديم التي تُرجمت في وقت لاحق. ويتضح لنا من افتتاحية سفر حكمة يشوع بن سيراخ، أنه بنهاية القرن الثاني قبل الميلاد كان قد تم ترجمة كل أو معظم أسفار العهد القديم إلى اللغة اليونانية. وليس هناك ما يدعونا للشك، في أن هذه الترجمة هي نفس الترجمة الموجودة بين أيدينا اليوم والمعروفة بالترجمة السبعينية.
ضد الذين يتصورون ان لله هيئة بشرية بشرية
يزعم البعض بدون فهم من أولئك الذين يبحثون في مفهوم خلق الإنسان بحسب صورة الله أن التشابه بين الإنسان والله هو تشابه يخص فقط الصورة الجسدية والشكل الذي نراه وليس شيئاً آخر. وبحسب رأيي يجب أن أجيبهم بأنهم قد ضلوا وإن عقلهم فَقَدَ الشوق والمحبة للحق. فبينما يُعْلِم المخلص بكل وضوح أن "الله روح". نجد أولئك ينسبون ملامح جسدية للطبيعة الإلهية وشكلاً مماثلاً للشكل الذي لدينا، وبالتالي لا يُدرك الله ذاته بعد كروح بل كجسد، طالما كانت الأشكال تُصاحب الأجساد. لكن، لأن الله هو روح ورائع الجمال، فهو أسمى من كل هيئة ومثال وشكل يمكن أن يُوصف.
القديس كيرلس الأسكندري
شرح انجيل يوحنا
"الابن الوحيد أزلي وقبل كل الدهور"
ماذا يقولون عن " فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ "؟ هل هذا يعني أن الابن ليس هو الله؟ لأن الأسفار الإلهية تقول: "لا يَكُنْ فِيكَ إِلَهُ غَرِيبٌ وَلَا تَسْجُدْ لإِلَهِ أَجْنَبِي (مزمور ۹:۸۱). فكيف لا يكون الابن إلها جديدا إذا كان قد ظهر فقط في الزمان؟ وكيف لا يكون كاذبًا وهو يقول لليهود الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: قَبْلَ أَنْ يكُونَ إبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ " (يوحنا ۸ : ٥٨). أليس من الواضح بل ما يعترف به الكل أن المسيح وُلِدَ من العذراء القديسة بعد إبراهيم بعصور كثيرة !؟ وكيف يمكن أن يصبح للكلمات " فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ " أي معنى إذا كان الابن الوحيـد جـاء إلى الوجود في الزمان؟ انظروا . أرجوكم - من الأدلة التالية كيف تصبح غباوة ظاهرة أن يُقضي على الميلاد الأزليّ للابن إذا سُمِحَ للذهن أن يتصور أنه جاء إلى الوجود في الأزمنة الأخيرة. إن لفظة "البدء ذاتها ، سوف تقودنا إلى معان أعمق.
المسيح الواحد
مقدمة
كتب القديس كيرلس كتابه المسيح واحد على شكل حوار بينه وبين شخص رمز له بحرف B أو ب وضع على لسانه كل الاعتراضات والاسئلة التى أثيرت فى الجدل مع النسطورية .والحوار أى طرية السؤال والجواب هو الاسلوب القديم في التعليم اللاهوتى الذي امتازت به مدرسة الاسكندرية والذي عرف باسم " الكاتكزم" Catechism ويقوم على الرد على الاسئلة مباشرة ، ولكنه يتميز رغم بساطته بثلاثة عناصر أساسية هي :
١- تحديد دقيق للفكرة أو المبدأ الذى يراد شرحه أو تعليمه وذلك باختيار سؤال محدد ورد محدد.
٢- لا يصبح ربط الاسئلة والاجوبة بنظرة شاملة لكل العقائد، وبالتالى الأمر مجرد رد على سؤال بل تكوين فهما شاملا لكل ما يحيط بالسؤال والجواب من علاقة مع الموضوعات الاخرى ولعل أقدم ما وصلنا هو حوار العلامة أورجينوس مع هيراقليطس والذي عثر عليه فى صحراء طره جنوب القاهرة حيث يعالج العلامة أورجينوس كل الاسئلة الخاصة بألوهية الابن من خلال شرح علاقة الابن بالآب وبالروح القدس ، وعلاقة الابن بالمؤمنين ، ويقدم أمثلة على وحدة عمل الثالوث من الحياة الروحية نفسها
حوار حول الثالوث الحوار الثالث
ويهدى القديس كيرلس كتابه "حوار حول الثالوث" إلى شخص يدعى "نيميسيوس" وكان ذلك في حياة بطريرك القسطنطينية اتيكوس، كما يشهد بذلك القديس كيرلس نفسه، وذلك في رسالته الثانية إلى نسطور فيقول: ... [،وفي الحقيقة أقول ذلك إنه بينما كان اتيكوس ذو الذكر السعيد لا يزال حيا، فإني قد كتبت كتابًا عن الثالوث القدوس الواحد في الجوهر، وقد ضمنته مقالاً عن تأنس الابن الوحيد وهو يتفق مع ما كتبته الآن]. ولهذا فقد كتب ق. كيرلس هذا الكتاب على الأكثر عام 425م ، ويشبه مضمون هذا الكتاب، مضمون كتاب "الكنز في الثالوث إلا أنه أكثر تفصيلاً، ولا نعرف السبب الذي جعله يعود للكتابة عن نفس الموضوع بمثل هذا الاسهاب، لكن من المحتمل أن يكون كتابه الأول "الكنز" في الثالوث قد كان صعبًا على جمهور القراء العريض، ولهذا فقد اجتهدق. كيرلس في أن يعمل على تبسيط تعليمه وشرحه بتفصيل وإسهاب أكثر . وكما تشهد الرسالة المشار إليها فإن هذا الكتاب كان قد قُرء جزءً منه أمام عددًا كبيرًا من الأساقفة والكهنة والمؤمنين القسطنطينية، وربما كان هذا قد تم من خلال سلسلة من العظات.